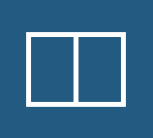عبد الغني النابلسي
عبد الغني النابلسي([1])
مآسي الأرواح في الفلسفة الصوفية
عبقرية المرحوم الشيخ عبد الغني النابلسي في العلوم والفنون
| هيهات لا يأتي الزمان بمثله | إن الزمان بمثله لبخيل |
لقد تولتني الحيرة حين رغبت أن أكتب عن النابغة المرحوم الشيخ عبد الغني النابلسي، فاقتصرت من بحر تاريخ حياته على هذه القطرة، أما إحصاء فضائله فهي نفحات قدسية آياتها الكبرى عبقرية وسحر مبين ومآثر خالدة عزت عن الوصف في مناحي العلوم والشعر والفنون. إن هذه النفحات الربانية خص الله بها سيد أصفياء القلوب النابلسي رحمه الله، فهو العندليب الصادح بالفلسفة والرمز الصادق لأسمى فكرة وجدانية تعبر عن شعور المحبين ومآسيهم، تشتاق إليها الأرواح والقلوب.
أصله: هو الشيخ عبد الغني بن إسماعيل، وينتهي نسبه إلى إبراهيم سعد الله ابن جماعة الكناني المقدسي النابلسي الدمشقي.
ولد هذا النابغة العظيم بدمشق في الخامس من شهر ذي الحجة سنة (1050ﻫ) وكان والده مسافراً في بلاد الروم، ولما شاهد المجذوب الصالح الشيخ محمود المدفون بتربة الشيخ يوسف القيميني بسفح قاسيون والدته وهي حامل بشرها به، وقال لها: سميه (عبد الغني)، فإنه منصور، وتوفي الشيخ محمود المذكور قبل ولادته بأيام، ولما عاد والده من رحلته؛ قصت عليه امرأته ما حدث، فسماه عبد الغني، وتولى والده تثقيفه، وشغله بقراءة القرآن الكريم.
وفاة والده: وفي سنة (1062ﻫ) توفي والده وكان المترجم العظيم في الثانية من عمره، وتولته العناية الإلهية، فأتاحت له ظروف الهداية والتوفيق في أعماله، فدرس من الفقه وأصوله، والنحو، والمعاني والبيان، والصرف، والحديث، والتفسير على عدة من شيوخ دمشق الأعلام، فكان وهو فتى كوكب دمشق الذي به تستنير.
صفاته: كان المترجم رحمه الله حنفي المذهب، قادري المشرب، أخذ الطريقة الكيلانية عن الشيخ عبد الرزاق الحموي الكيلاني، ومما قاله في ذلك:
| أيا ساكناً في الشرق قد شرقت بكم | عيوني بدمع حين شامت سنا البرق |
| فمدت يد شرقية قادرية | بها نشأتي خضراء طيبة العرق |
| ألا فاعذروا الطرف المحب فإنه | رأى البرق شرقيًّا فحنَّ إلى الشرق |
وأخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ سعيد البلخي.
كان مصون اللسان عن اللغو والشتم، لا يخوض فيما لا يعنيه ولا يحقد على أحد، وإن هجوه للذين تحاملوا وافتروا عليه كان بسائق الدفاع عن نفسه لإظهار الحق، عظيم التواضع يحب الصالحين والفقراء، ويجل طلبته ويكرمهم، رحيب الصدر كثير السخاء.
الدعايات الفاسدة ضده: كان يلقي الدروس في الجامع الأموي في عدة فنون، وبعد العصر في الجامع الصغير، ثم يقيم الأذكار، ويعود إلى داره الواقعة بالقرب من الجامع الأموي، لا لذة له إلا نشر العلوم والتبحر بمطالعة مؤلفات الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، ثم اعتراه مرض نفساني أو ما يسمونه (السودا)، فاعتزل الناس، واستقام مدة سبع سنوات لم يخرج من داره، وأسدل شعره، وأطالأظفاره، وبقي في أحوال عجيبة، فتكلم به الحساد ـ والحسد في النفوس المريضة داء ـ فنعتوه بأوصاف لا تليق به، واتهموه بترك الصلوات الخمس، وأنه يهجو الناس بشعره، وكثرت دعايات المرجفين بحقه شأن كل ذي مكانة مرموقة وعلم مكين، وقامت عليه أهل دمشق وآذوه بأفعال غير مرضية، ودافع عن نفسه بما فعلوه معه فهجاهم، ومن قوله في ذلك:
| قسوة فيهم وفرط جفا | لم يخف مرميهم رامي |
| وابتلوا بالغي من حسد | مثل أمراض وأسقام |
| قد أتى في مسند ابن عدي | خبر عن جل أقوام |
| قال خير الخلق سيدنا | الجفا والبغي في الشام |
ولم يزل يقاوم هذه الدعايات الباطلة حتى تغلب على أصحابها، وأظهر الله أمره للوجود، فأشرقت بعلومه الأيام، وتبسم ثغر إقباله، فبادرت الناس بالتقرب إليه؛ لاجتلاء بركاته وصالح دعواته، ووردت عليه أفواج الواردين من سائر الأقطار العربية، وعمت نفحاته وعلومه الأنام والعباد، ولامه البعض لأنه لا يداري زمانه فقال:
| قيل لي كن مع الأنام وداري | كل شخص فقلت ما الذل قدري |
| أنا عبد الغني لا عبد زيد | في جميع الورى ولا عبد عمرو |
كان مغرماً بالمناقشة وأن تكون له الغلبة دائماً، حياته كلها نضال وقراع ومناظرة وحجج، وإن قوة المنطق تلك الهبة السامية التي منحه الله إياها كانت عنصراً قويًّا من عناصر نجاحه.
تآليفه: مؤلفاته كثيرة يتعذر عدُّها في هذه الرسالة، أكتفي بذكر أشهرها، منها التحرير الحاوي لشرح تفسير البيضاوي، وقد وصل فيه من أول سورة إلى قوله تعالى: ﴿ﲍﲎﲏﲐ﴾، في ثلاث مجلدات، وشرع في الرابع وحال دون إكماله وفاته، ومنها بواطن القرآن ومواطن الفرقان، كله منظوم على قافية التاء المثناة، وصل فيه إلى سورة (براءة)، فبلغ الخمسة آلاف بيت، ومنها كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين، وجواهر النصوص في حل كلمات الفصوص للشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي، وكشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض، وتحقيق الذوق والرشف، وأنوار السلوك في أسرار الملوك، وديوان الإلهيات الذي سماه ديوان الحقائق وميدان الرقائق، وديوان الغزليات المسمى بخمرة بابل وغناء البلابل، وقد ألف المرحوم محمود بك العظم رسالة بليغة شرح بها مناجاة المترجم النابلسي رحمه الله.
شعره:
| إذا أخذ القرطاس خلت يمينه | تفتّح نوراً أو تنظّم جوهراً |
لقد جاءت منظوماته الشعرية بغرائب الإعجاز، منها (البديعية)، وهي القصيدة المسماة بنسمات الأسحار في مدح المختار، وقد بلغت أبياتها مئة وخمسين بيتاً، تشتمل على مئة وخمسة وخمسين نوعاً من الأنواع البديعية، ومطلعها:
| يا منزل الركب بين البان والعلم | من سفح كاظمة حييت بالديم |
وقد استبعد بعض المنكرين فضله وعلمه أن تكون من نظمه فاقترحوا عليه أن يشرحها، فنظم بديعية أخرى وشرحها في مدة شهر شرحاً بليغاً لطيفاً في مجلد ضخم، فأفحم حساده، وهي على منوال القصيدة الأولى، التزم فيها تسمية النوع تمثيلاً لما ذكره من الاستسهال، وكتب كل بيت منها عند ما يماثله في الهامش على حسب مقتضى الحال، ومطلعها:
| يا حسن مطلع من أهوى بذي سلم | براعة الشوق في استهلالها ألمي |
وقال رحمه الله: (أيها الناظر فيها بنظرة من بصيرة قلبه وبصره، لا تظنن بأن هذا الكلام من جنس ما تعرفه من كلمات الأنام وإن تشارك معها في المعاني وفي المباني، فإن سماع السبع المثاني ليس كاستماع المثالث والمثاني)، وشعره ينشد في المحافل ويحفظه الناس لبلاغته ورقته.
فنه: تعتبر موشحات النابلسي رحمه الله من أبدع الموشحات، وهي على كثرتها محفوظة ومنتشرة تسحر الألباب برقتها وبلاغة معانيها وقوة تلحينها، وهذا موشح من نغمة العراق قال فيه:
| يا أهيل الحي | إن قلبي حي |
| يا رفيقي قم | لحبيبي حي |
| وارتشف خمري | فهو ملء الكوب |
| لوح نوراني | بالورى مكتوب |
وله موشح من نغمة الأوج تتحدى روعته ومتانته من يأتي بمثله من القطع الحديثة، وهو:
| يا جمال الوجود | طاب فيك الشهود |
| والبرايا رقود | إن عيني تراك |
| ما لقلبي سواك | |
رحلاته: قام برحلات كثيرة، وأهمها رحلته في سنة 1075ﻫ إلى دار الخلافة، واستقام بها بضعة أشهر، وفي سنة 1100ﻫ زار البقاع وجبل لبنان، وفي سنة 1101ﻫ زار القدس والخليل، وفي سنة 1112ﻫ ذهب إلى طرابلس الشام، ثم في سنة 1150ﻫ ذهب إلى مصر، ثم إلى الحجاز، وهي رحلته الكبرى، ولكل من هذه الزيارات رحلة مسجلة بمشاهداته، وكان أين ما حل يستقبل بالحفاوة والإجلال.
حياته العامة: وفي سنة 1119ﻫ انتقل من دار أسلافه إلى صالحية دمشق، وأقام في الدار المعروفة بدار النابلسي إلى أن مات فيها، والذي شوَّقه لسكنى الصالحية صديقه الوفي المرحوم أسعد بن أحمد البكري قاضي قضاة الدولة العثمانية وولده المرحوم خليل، وبعد وفاة المترجم وهبه قطعة أرض شيد قبره وجامعه عليها، ومن مدحه لآل البكري قوله:
| حرمٌ آمن لكعبة قلبي | أنا فيه مخطوف عقل ولب |
| هذه طلعة الحبيب جهاراً | تجمع الحسن للنواظر تسبي |
| أنا شرق لشمسها فاجتلوني | ليس عني يوماً تميل لغرب |
| وهي روحٌ مهبُّها ذات أمر | وأنا هائم بذاك المهب |
كان إذا خرج إلى نزهاته في ربوع الشام الفاتنة ضمت مجالسه المئات من طلابه ومريديه وعشاق فنه، وأقاموا الأذكار، ثم انثنوا لفصل السماع والطرب للترفيه عن أنفسهم، فكان المغنون إذا أنشدوا موشحاته بهروا العقول بأصواتهم الجميلة، وصغى لسماعها آذان المحبين لما فيها من فنون، فقد جعل رحمه الله الشرق منادح صبابة ومراتع فتون وفنون، واسمع ما يقوله في وصف الغناء والطرب:
| هلا غنيتم بما غنى به الوتر | فتسمعوا منه يا عشاقه وتروا |
| فإن في نغمة الطنبور بارقة | من البروق التي في القلب تستعر |
| واستنطق الدف ينطق بالإشارة عن | معنى بدا وهو في الأكوان مستتر |
| وأخبرتنا إشارات الصنوج بها | فهيم القلب منا ذلك الخبر |
| حتى انعطفنا على السنطير نسأله | عن عينه فتبدى منه لي أثر |
| وقال لي الناي إني من إشارته | ونفح روحي منه تبعث الصور |
| والعود عاد بصوت في الغناء شج | وقال نحن وأنتم كلنا عبر |
منزلته الاجتماعية: كان عظيم الهيبة والوقار والحرمة والجاه لدى ولاة الأمور، يبذل نفوذه بالشفاعات الحسنة فتقبل ولا ترد، وقد نال من عطف السلطان أحمد الشيء الكثير.
وقـد رأى فـي أواخـر عمـره مـن العز والجاه ورفعة القدر ما لا يوصف، ومتعه الله بقوته وعقله، فكان يصلي النافلة من قيام التروايح في داره إماماً بالناس إلى أن مات، ويقرأ الخط الدقيق، وقد شرح تفسير البيضاوي بعد أن جاوز التسعين من عمره.
وفاته: لقد مرض المترجم مدة أسبوع، فكان الناس في وجوم وحزن، وفي عصر يوم الأحد في الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1143ﻫ حم القضاء واختاره الله لجواره، وجهز ثاني يوم وصلي عليه في داره من شدة الازدحام، ودفن في القبة التي أنشأها في أواخر سنة 1126ﻫ، وأغلقت الشام يوم وفاته، وانتشرت الناس في جبل الصالحية وهم يبكون إمامهم الأكبر، وبنى حفيده الشيخ مصطفى النابلسي إلى جانب ضريحه جامعاً حسناً، ولقد تبارى الشعراء في رثائه.
تغمده الله برحمته ورضوانه.
* * *