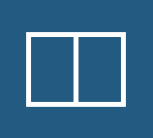محمد إمام العبد
محمد إمام العبد([1])
(1862 ـ 1911م)
لقد ثبت أن الشاعر محمد إمام العبد توفي في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي غير متجاوز الخمسين من عمره، وعلى هذا الاعتبار تكون ولادته وقعت في عام 1862م ووفاته سنة 1911م على وجه التقدير.
ولد إمام من عبدين رقيقين كانا جلبا من السودان، وبيعا لبعض الأثرياء وقد جمعتهما الأقدار برباط الزوجية فأنجبا محمد وحده، فورث عنهما السواد والدمامة والبؤس، نشأ في كنفهما يقتات بما يتساقط من فتاة الموائد وبقايا الصحاف، وكأن القدر القاسي لم يشأ أن يحرمه كل شيء فمنحه القوة الجسمية والبلاغة في المنطق والخفة في الروح، فكان رياضيًّا ممتازاً يصرع أقرانه لدى الصيال، وشاعراً مطبوعاً دانت له القوافي والأوزان، وخطيباً مفوهاً، وسميراً يؤنس سامعيه بنوادره العذبة، وقل أن يجتمع هذا كله في إنسان.
تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة مدة قصيرة، ثم انقطع فجأة عن العلم دون أن يتم المرحلة الأولى، ولعله فعل ذلك ليتلقى دراسته الواسعة في ميدان الحياة بين صفحات الكتب وفي الحلقات الأدبية التي كان يقصدها المتأدبون لعهده بالأندية والمقاهي الشعبية، وفيها تخرج أكثر أدباء العهد الماضي من كتاب وشعراء.
التندر بسواده: كان لونه الأسود موقع التندر بين زملائه وعارفيه، فقاسى من جرائه كثيراً من ألوان التهكم والاستخفاف، وهذا ليس بعجيب، فقد ابتلي كثير من الأدباء قبله ببلواه فدافعوا عن أنفسهم أبلغ دفاع، وكان شاعر النيل حافظ إبراهيم أقسى المتهكمين لهجة وألذعهم سخرية، وكانت فكاهته معه تأخذ طريقها إلى الألسنة، وطالما وقعت بين الشاعرين جفوات متقطعة لما يلوكه حافظ من حديث إمام، ثم لا تلبث السحب أن تنقشع لما بينهما من صلات جمع بينهما الشعر والبؤس والفكاهة، وأكدها صفاء النفس ونقاوة الضمير.
مواهبه الأدبية: لقد اشتهر إمام بالشاعرية قبل صديقه حافظ إبراهيم، فكان حافظ في صباه يعرض عليه ما يفيض به خاطره من بيان، فيقوم إمام بصقله وتجويده وتزكيته، ثم مضت الأيام فإذا شاعر النيل يطير بشعره في آفاق الشرق العربي، وإمام البؤساء لا يجد من يروي قصائده، وينظر العبد إلى مكانه من صاحبه فيوسع عشاق حافظ لوماً وتسفيهاً كما يعلن أستاذيته له في كل ندوة يدور بها الحديث عن الشعر والشعراء.
لقد نظم إمام في الخمر أبياتاً رائعة صادفت هوى في الأسماع والقلوب، والواقع أن حافظاً كان مريضاً يعاينه إمام، فهو لا يرحمه بالسكوت عنه مهما بالغ في الترديد إليه، وكان لا يقصر تندره على قصائده وهي أثمن ثروة يعتز بها الشاعر، بل ينتقل إلى ملبسه ومأكله وهيئته، فيوسعه سخرية وعبثاً، وكان في طرق إمام أن يؤدب صاحبه ببأسه وصرماته، ولكنه كان في أكثر أحواله ينفق عليه ويقاسمه بما يمتلكه مما يدعو إلى التسامح والإغضاء.
ولم يكن حافظ وحده يستغل سواد إمام في تندره وسخريته، بل إن إماماً نفسه قد اتخذ منه مادة دسمة للحديث عن نفسه، فهو لا يفتأ يردده في قصائده وأزجاله، ويستلهمه كثيراً من المعاني الجياد، فإذا تحدث الشاعر عن بؤسه وفاقته دار حول سواده ودمامته، وإذا لفحه الحب تذكر سواده الفاحم فانتزع منه الخواطر المشجية، وهكذا يصبح السواد مركب النقص لديه يشعر به في ألم ومرارة فيسلمه أزمة القوافي والأوزان.
أما غزله المطبوع فيدور أكثره في قصائده على ما مني به من حلوكة دامية، وهو في كل مقطوعة يبتكر ويجدد.
لقد كان بؤسه الذي صحبه في حياته قد امتد إلى تاريخه، يكاد أن يأتي عليه والبؤس طاغية جبار، يصاول الأحياء في عنف وطغيان.
واستمع إلى غزله الفاتن إذ يقول:
| عذبي القلب كما شئت ولا | تكثري اللوم فمثلي لا يلام |
| وأسدلي الليل على بدر الدجى | فحديث الشوق يحلو في الظلام |
| همت بالوصل فقالت عجبا | أيها الشاعر ما هذا الهيام |
| لم ينل منا الرضا حر وما | رام منا سيد هذا المرام |
| أنت عبدٌ والهوى أخبرني | أن وصل العبد في الحب حرام |
| قلت يا هذي أنا عبد الهوى | والهوى يحكم ما بين الأنام |
| وإذا ما كنت عبداً أسودا | فاعلمي أني فتى حر الكلام |
وهو تارة يعلن أن لونه لم يكن مسوداً قبل غرامه، ولكن لهيب الشوق أحرقه في قسوة فأحاله من البياض إلى السواد، وهو تعليل طريف مستملح، وفي ذلك قوله:
| كتمت فأقصاني ربحت فلامني | فهاج غرامي بين سري وإعلاني |
| وما كان لوني قبل حبك أسودا | ولكن لهيب الشوق أحرق جثماني |
ويلاحظ من غزله المرح أنه كان مشبوب العاطفة، صادق الصبوة، وقد تحاشا في شعره الجناس المستكرة والطباق الثقيل، واندفع إلى التعبير عن خواطره في سلالة ونصوع، وحسبك أنه يطرب بعذوبة قوله:
| أرى لوعة بين الجوانح لا تهدأ | أهذا الذي سماه أهل الهوى وجدا |
| وما ذلك الواهي الخفوق بجانبي | أهذا هو القلب الذي يحفظ العهدا |
أو يقول:
| أقام الهوى عشرين حولاً بمهجتي | وسار، فمن أوحى له برجوع |
| كأن الهوى ما أكرمته ربوعها | وصادف إكراماً له بربوعي |
ورغم هذه المقطوعات الجياشة بالحنين إلى المرأة وللتشوق إلى ظلالها الوارفة وروضها البهيج، فقد قضى الشاعر حياته عزباً لم يتزوج، ولسنا نحار في تعليل ذلك، فتكاليف الزواج مرهقة لا يتحملها شاعر معدم، تتلوى أمعاؤه في أكثر أوقاته جوعاً وسغباً، ويتحرق إلى مسكن ضئيل يقيه برد الشتاء وحر الهجير، وقد كان الأدب في عهده لا يغني من جوع أو يدفع من فاقه.
إدمانه للخمرة: كان إمام العبد يتهالك على الشراب، وتلك حالة جديرةبالرثاء والإشفاق، وقد نظر إمام إلى الزواج ككارثة مروعة تؤجج اللوعة والحيرة في قلبه، وصوّر للقراء ما يعقبه من تبعات ومصاعب، وفيها ما يدل على قلقه واضطرابه:
| أيها العاقل المهذب مهلا | هل رأيت الزواج في الدهر سهلا |
| كل عام يزاحم الطفل طفل | ليتني عشت طول عمري طفلا |
| ذاك يحبو، وذاك يمشي، وهذي | فوق صدر، وتلك تنشد بعلا |
| ضاق صدري من الزواج فمن لي | بحياة الخصي قولاً وفعلا |
| كان هذا الشقي جسماً فلما | أنهكته الهموم وأصبح ظلا |
هكذا يئس الشاعر من الزواج، فلم يطرق بابه، وقد ادعى أن لديه مانعاً يحول دون زفافه، فهو كالليل الحالك وكل حسناء شمس منيرة، واجتماع الليل والشمس من ضروب المحال كما قال:
| يا خليلي وأنت خير خليل | لا تلم راهباً بغير دليل |
| أنا ليل وكل حسناء شمس | فاجتماعي بها من المستحيل |
وقد صور الشاعر فاقته وعدمه وأسهب في تبرمه وتوجعه لحالته، وكان يحز في كبده أن يجوع وتأكل الماشية، ويعرى وتكتسى الأضرحة، ولولا أنه كان يسري عن نفسه بمجالس السمر ومطارح الفكاهة لاحترق بما يشتعل في صدره من جحيم، وقد كان من القسوة الغليظة أن يلقبه الناس بالعبد وهو الأديب الحر العيوف، وماذا يصنع في لقب ورثه عن أبيه ولازمه كالظل، وقد تمنى الشاعر أن يكون قلمه سهماً مسدداً إلى فؤاده فيريحه مما يكابده من عناء، وتلك أمنية ترمض الجوانح وتدمي الجفون، إذ يقول:
| لبست لأجله ثوب الحداد | ودرت مع الزمان بغير زاد |
| أمد يدي إلى قلمي افتقارا | فيدفعني إلى تلك الأيادي |
| فياليت اليراع يصير سهما | كما أبغي ويكتب في فؤادي |
| سئمت من الحياة بلا حياة | وضقت من الرشاد بلا رشاد |
| وكيف يهيم بالدنيا أديب | تسربل بالسواد على السواد |
| إذا أكل الطعام فمن تراب | وإن شرب المياه فمن مداد |
| كأن الدهر يغضبه صلاحي | فأفقرني ليرضيه فسادي |
وأوجع من هذا أن يقول شاكياً فاقته نادباً مجتمعه الجائر:
| خلقت بين أناس لا خلاق لهم | فباعني الفضل في الدنيا بلا ثمن |
| لولا بقية دين أمسكت خلقي | لقلت إن إله العرش لم يرني |
أو يقول:
| وما قتلتني الحادثات وإنما | حياة الفتى في غير موطنه قتل |
| وما أبقت الدنيا لنا من جسومنا | على بأسنا ما يستقيم به الظل |
ومازال يتقلب على أشواك الحرمان حتى دهمته العلة بعد خمسين عاماً من عمره الجديب، وأحس أنه قريب من الموت فلم يأسف من الحياة على شيء غير يراعة العجيب، فطالما نفث بمداده السحر، وشنف بصريره الأسماع، فطفق يودعه في حرقة وتلهف وينشده الرثاء الباكي الذي ناح به على نفسه، وهو يصاول النداء الفتاك فيقول:
| يراعي، لقد حان الفراق وربما | أراك على العهد المقدس باقيا |
| لبست عليك الليل حزناً وليتني | لبست على نفسي الدجنة ثانيا |
| مضت بيميني الحادثات جهالة | فلما رأت صبري مضت بشماليا |
| وكيف يطيب العيش والدهر مدبر | وفي القلب ما يغري الحسام اليمانيا |
* * *