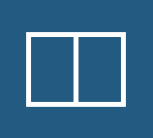محمد عبد المطلب
محمد عبد المطلب([1])
(1870 ـ 1931م)
مولده ونشأته: نزح أجداده من الجزيرة العربية منذ قرن واستوطنت قرية (باصونة) التابعة لمديرية جرجا، ولد هذا الشاعر الكبير سنة 1870م في القرية المذكورة، ونشأ في كنف والده نشأة دينية قويمة، درس القرآن الكريم، وتمكن من الفقه الإسلامي والحديث النبوي، ثم دخل الأزهر، وقضى مدة سبع سنوات في حلقات الأزهر العلمية ظهرت فيها مواهبه.
في خدمة الثقافة: خرج من الأزهر إلى مدرسة دار العلوم سنة 1892م وعنده من غرر القوافي ثروة ثمينة ساعدته على النظم في مختلف الأفانين الشعرية، وقضى أربع سنوات في دار العلوم، وتخرج منها في سنة 1896م متوجاً بالنجاح.
عين مدرساً بمدرسة سوهاج الابتدائية، ثم انتقل إلى عدة مدارس ابتدائية وثانوية، حتى اختير أستاذاً بمدرسة القضاء الشرعي، وكانت شهرته قد طارت إليها بما كان ينشره من حين لآخر في الصحافة، وأخذ يغرس في نفوس طلابه حب الأدب والفضيلة، ويدفعهم إلى التعصب للعربية، ولقد غالى في ذلك مغالاة عدها الكثيرون رجعية وجموداً، فكان لا يحفل بناقديه، ثم قضت الظروف السياسية أن ينتقل من مدرسة القضاء الشرعي إلى مدارس الأوقاف، فحيل بينه وبين العقول الممتازة التي كانت تنتفع بآرائه وتوجيهه، واعتبر وجوده في مدارس الأوقاف محنة قاسية قابلها بالصبر والتجلد، وعكف على إنتاج الأدب الرفيع، ثم نقل إلى التدريس في دار العلوم، وكان يشكو ضعفاً في قوة إبصاره، ولم يلهه التدريس بالجمهور عن طرق الصحافة، فقد كان ينشر أبحاثه الأدبية دراكاً، وفي أواخر حياته انتدب سنة 1928م للتدريس في تخصص اللغة العربية بالأزهر، وظل به حتى لقي وجه ربه.
أدبه: لقد كانت القصائد الصوفية التي تنشد في حلقات الذكر في داره أول حافز دفعه إلى الانكباب على الدواوين الشعرية في ميعة صباه، يستوضح غامضها ويتفهّم معانيها، حتى خلقت منه فيما بعد شاعراً بليغاً ملهماً، جزل العبارة، فخم الأسلوب، كان ينهج منهج القدامى من فطاحل العصر العباسي، فكان يبتدئ قصائده بالغزل الرائق مستعيناً بخياله البدوي في التوليد والتصوير، وتلك منَّة كبرى أسداها إلى الأدب العربي، وكان إكثاره من الغريب المستساغ في وقت ظاهر فيه أعداء اللغة بعجزها عن مسايرة الحياة.
ديوانه: لقد خلَّف ديوانه الحافل بالقصائد السياسية التي تعتبر في الواقع وثائق تاريخية يحتج بها الباحثون، فما من عاصفة سياسية هبَّت بمصر إلا خلَّدها في شعره الرائع، إلى جانب ما كان يكتبه من مقالات طنانة عميقة التأثير، وله في الحرب العظمى قصيدة فهي وحدها كافية للتدليل على مذهبه في الشعر، وقد عبر فيها عن إحساس الشعب المصري أصدق تعبير، صبّ فيها ناره الموقدة في ظهور الإنكليز، والقصيدة قد جاوزت المئتين، تضرب على هذا الوتر الرنان، وهذه بعض أبيات منها:
| تبصر خليلي هل ترى من كتائب | دلفن بها كالسيل من كل مودق |
| سراعاً إلى الحانات تحسبهم بها | نعاماً تمشى رزدقاً خلف رزدق |
| يهولك مرآها إذا اصطخبت بهم | مواخير تجلو فاسقات تفسّق |
| إذا أجلبوا فيها حسبت ضفادعا | تجاذبن إيقاعاً على صوت نقنق |
| زعانف شتى من طويل مشذب | طري القرا عاري الأشاجع أعنق |
| ترى منه بحبوحة الأمن باسلا | وإن يدعه الداعي إلى الكر يحبق |
عراكه الأدبي: وحين ظهر كتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين؛ سارع إلى نقده في جريدتي الأهرام والمقطم، ثم تشعَّب به النقاش فخاض المعركة الحامية بين الجديد والقديم، حتى عدّعند الكثيرين عميداً للمدرسة القديمة الاتباعية.
رواياته: وضع في سنة 1909م وما بعدها بضع روايات شعرية مسرحية، ذات فصول ومناظر تمثيلية، وقد جعلها متينة الحوار سريعة الحركة، حسنة المفاجأة، وكلها عربية بدوية تتخذ أسماء لامعة في تاريخ الأدب؛ كالمهلهل، وامرئ القيس، وليلى، العفيفة، ثم أعقبها بعدة روايات مشهورة، وهي لا تزال في غمرة الجحود مخطوطة بدار الكتب المصرية.
صفاته: كان شيخاً وقوراً وعالماً متفقهاً في دينه يعظ الناس فيهز أوتار القلوب ذا أخلاق فاضلة دينية مثالية، متواضعاً، عزوفاً عن الشهرة، وعف اللسان، صلب العقيدة، متمسكاً بتقاليد قومه، راغباً في الزهد الصوفي، وقد اشترك في جمعيات إسلامية كبيرة.
وفاته: أُحيل إلى التقاعد من دار العلوم قبل وفاته بشهر واحد، وفي سنة 1931م فاجأه اليقين، وشُيِّع في حفل مهيب، وتبارى الشعراء والخطباء في تأبينه، وقد وصف الشعر الهراوي حفلة دفنه فقال:
| لقد مشت الدنيا وراءك خشعاً | وما كنت في سلطان حل ولا عقد |
| ألا إنها كانت قلوباً تدافعت | على الود تمشي حول نعشك في حشد |
* * *