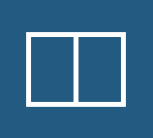محمد عبده (الإمام)
محمد عبده (الإمام)([1])
الإمام محمد عبده
(1849 ـ 1905م)
مولده ونشأته:هو محمد بن عبده خير الله، ولد في سنة 1266ﻫ و1849م في قرية محلة نصر بمركز شبرا خيت من أعمال البحيرة في مصر، وأمه هي السيدة جنينة، تعلم القراءة والكتابة في منزل والده، وحفظ القرآن الكريم في عامين ولما يتجاوز العاشرة من عمره، وتلقى علم النحو في مسجد طنطا، ثم عزم على العودة إلى قريته، وترك طلب العلم والعمل في الزراعة، إلا أن والده ألح عليه فأضمر الهرب واختفى عند أخواله، وتولاه الشيخ درويش أحد أخواله وكان على شيء من العلم، فما زال بالفتى حتى آنس به وانشرح صدره إلى العلم، وانقلبتفي عشرته قيم الأشياء، فأصبح اللهو والزهو أبغض شيء إليه.
قرانه: اقترن وهو في السادسة عشرة من عمره، وبعد أربعين يوماً انقضت على زواجه أرسله أبوه إلى القاهرة ليأخذ العلم في الأزهر، فقرأ جميع الكتب المقررة في ثلاث سنين، ومضت سبع سنين، فأخذ الشيخ درويش يحثه على لقاء الناس ووعظمهم بعد أن اكتمل علمه، وكان في نفسه أشياء من طريقة شيوخ الأزهر وشروحهم ومتونهم وحواشيهم رآها مما تضيع فيه الأعمار ولا ينتج عن تعليمها فائدة.
عاش الشيخ محمد عبده في بيئة علمية ضيق الصدر، مرير العيش، واصطدم بعاملين، هما عامل الحسد وعامل البيئة، ومن المحال أن يوجد رجل كالشيخ في صفاته وعلمه لا يحسد، ولولا المقاومة والحسد لما كان شيئاً يتحدث عنه، ولما كان رجلاً مخلداً في التاريخ.
حلقته الدراسية: كان يدرس التفسير في ليلتين من كل أسبوع، والبلاغة في الليالي الأخرى، وكان درس التفسير يزدحم بكل طبقات المثقفين، ويحضره جميع رجال النهضة وأركان البحث والتجديد في مصر، وكان يكره أن يقاطع بسؤال في أثناء انهماكه في الإلقاء؛ لأنه كان يرتب أفكاره بطريقته الخاصة.
وكان الأزهر يقوم على معسكرين ويضم طائفتين: طائفة المجددين، وهؤلاء كانوا يرحبون بكل ما يقوله الإمام، وطائفة المحافظين، وهؤلاء كانوا يحاربون له كل فكرة ويتقولون عليه الأقاويل.
كان الإمام يرفض أكثر الأسئلة، ويزجر أصحابها، فإذا تمادى طالب في الإلحاح بالسؤال؛ نادى بتابعه (غراب) فأمره بإخراجه من الحلقة، فانقض عليه هذا الغراب الأسحم فجرَّه جرًّا وعتله إلى الباب.
وكان يحيط بحلقته العلمية الشعراء أمثال حافظ إبراهيم، وإمام العبد، وعلي الجارم، والمنفلوطي، وغيرهم.
جمال الدين الأفغاني: بقي المترجم في هذه البيئة العلمية المنحطة مضرب البال حتى وافى مصر الإمام جمال الدين الأفغاني سنة 1869م، فلازمه وتتلمذ له وهو في العشرين من عمره، وقرأ مختلف فروع الفلسفة والتصوف والتاريخ والسياسة والاجتماع.
وفي أواخر سنة 1878م عين مدرساً للتاريخ في دار العلوم، ومدرساً للغة العربية في مدرسة الألسن، وبعد قليل عزل عن التدريس في هاتين المدرستين، على أن يقيم في قرية لا يبرحها إلى الحواضر المصرية، وذلك لغضب الخديوي عليه.
في الصحافة: وفي سنة 1880م عفا عنه أمير البلاد، وعين محرراً لجريدة (الوقائع المصرية) الرسمية، وكان تلميذه الشاب سعد باشا زغلول يساعده فيها، وقد بلغت جهود الإمام وقتئد ذروتها في نهضة الشعور الوطني العربي.
الثورة العرابية: وقد انتهى عهد تحريره لـ(لوقائع المصرية) بقيام الثورة العرابية، فقبض عليه، وصدر الأمر بنفيه من البلاد ثلاثة أعوام، فحضر إلى الشام، ثم غادرها إلى باريس، وأصدر مجلة (العروة الوثقى) مع أستاذه الإمام جمال الدينالأفغاني، وكانت مواضيع المجلة في محاربة الاستعمار والمستعمرين حتى ضاق صدرهم، فمنع الإنكليز دخولها إلى الهند ومصر والسودان، فلم تعش أكثر من ثمانية أشهر، وكانت مقالاتها أشبه بدساتير للأمة، ثم ذهب متنكراً من باريس إلى تونس فمصر، ثم عاد إلى بيروت سنة 1885م للتدريس في المدرسة السلطانية، ووضع برنامجاً لتعليم علوم التوحيد والمنطق والمعاني والإنشاء والتاريخ الإسلامي، وزار خلال ذلك بعض مدن الشام، وأفاض على كل من لقيه غرفة من علمه وبيانه، وزار إنكلترا حيث اجتمع بالفيلسوف الإنكليزي (هربرت سبنسر) وكان من المعجبين به، وقد ساعدته هذه الأسفار على توسيع دائرة تجاربه وألهمته حمية وطنية إصلاحية جديدة، حتى تحول من زعيم لقادة الفكر إلى رجل سياسي مفكر بثورة سياسية.
عودته إلى مصر: وعفى عنه أمير البلاد، فعاد إلى مصر، وعين قاضياً ثم مستشاراً، وقد دعا الأزهريين لتعلم اللغات الأجنبية وبدأ بنفسه، فتعلم اللغة الفرنسية وهو في الرابعة والأربعين من عمره، وتعلم الهجاء الفرنسي أثناء الثورة العرابية.
وقـد أقـام فـي فرنسـا عشـرة أشـهر لم يتعلم خلالها اللغة الفرنسية؛ لأنه كان لا يختلط بالفرنسيين ولا يجتمع بهم، ويقضي الوقت كله بين عمله في تحرير مجلة (العروة الوثقى) وبين السيد جمال الدين الأفغاني وزملائه من العرب.
ولما عاد من النفي إلى مصر عين قاضياً بالمحاكم الأهلية، وكانت الأحكام تصـدر بالاسـتناد للقانون الفرنسي، فرأى أن يعود إلى تعلم اللغة الفرنسية حتى لا يكون أضعف من زملائه القضاة في العلم بهذا القانون، فبحث عن مدرس للفرنسية، فلما أقبل الأستاذ في اليوم الأول وجده حاملاً كتاباً في الآجرومية الفرنسية، فقال له الإمام: (لا وقت عندي لأن ابتدئ، وإنما عندي زمن لأن أنتهي)، ثم قدم له قصة من تأليف الكسندر دوماس وقال له: (أنا أقرأ وأنت تصلح لي النطق وتفسر لي الكلام، وما عدا ذلك فهو علي، والنحو يأتي في أثناء العمل)، واستمر في هذه القصة حتى انتهى منها، فتناول كتاباً ثانياً وثالثاً على هذه الوتيرة، ثم سافر بعد ذلك إلى فرنسا وسويسرا عدة مرات أيام العطلة الصيفية، وكان يحضر دروس العطلة الصيفية في كلية جنيف، وبهذه الطريقة تعلم اللغة الفرنسية في أوقات الفراغ، مع اشتغاله بالقضاء في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ومع إجادته اللغة الفرنسية واستفادته منها كان يرى أنه لا غنى للسائح في البلدان الأوروبية عن تعلم غير لغة واحدة.
وكان يود ألا يدخل في سلك القضاء لرغبته في التعليم، وطلب أن يعود إلى التدريس في العلوم، فأبى الخديوي أن يجيبه إلى طلبه مخافة أن يلقن تلاميذه من أفكاره السياسية.
منصب الإفتاء: وفي سنة 1899م أسند إليه منصب الإفتاء في الديار المصرية، فأصبح بحكم منصبه الجديد عضواً في مجلس الأوقاف الأعلى الذي أنشأه عميد الاحتلال للحد من تصرفات الخديوي في أموال الأوقاف، وعين في الشهر الذي تولى فيه الإفتاء عضواً في مجلس الشورى، ولم يلبث أن ظهرت المشادة بين الإمام والخديوي.
كلمة أليمة: لقد طلب الخديوي توفيق استبدال مزرعته بأطيان من أملاك الأوقاف، فلم يوافق الأستاذ الإمام على الاستبدال، فكان ذلك من دواعي زيادة حنق الخديوي عليه، وفي هذه الأثناء أقبل أحد الأعياد القومية، وذهب الشيخ محمد عبده فيمن ذهب من الكبراء لتهنئة خديوي البلاد، فلما كان في المجلس قال الخديوي: (في البلاد أناس ليسوا راضين عن أعمالنا، فخير لهؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم ليشتغلو فلاحين)، قال ذلك على مسمع محمد عبده، فأيقن أنه يعنيه على أثر هذه الحادثة، فخرج من القصر وذهب إلى منزله، وقد اشتد عليه المرض واعتكف فيه، ولكنه لم يألف الراحة، فأخذ يغالب الآلام ويعمل لوظيفته وللناس في فترات سكون الألم وهو على فراشه.
إصلاحاته العلمية: لم يكتف بحكم منصبه الديني بإصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية، بل توفر مع أصحابه على إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية، وأصبح رئيسها من سنة 1900م إلى وفاته، فجمع لها من كرام المصريين أموالاً كثيرة، ووقف عليها مزارع وأراضي، وأنتجت ما كان يعقد عليها أمله من الخير في تربية أبناء الفقراء تربية حرة طاهرة.
مؤلفاته: أول تآليفه هو: 1 ـ الواردات 2 ـ رسالة في وحدة الوجود 3 ـ تاريخ إسماعيل (لم يطبع) 4 ـ فلسفة الاجتماع والتاريخ 5 ـحاشية على عقائد الجلال الدواني 6 ـ شرح نهج البلاغة 7 ـ شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني 8 ـ شرح البصائر النصيرية 9 ـ نظام التربية والتعليم 10 ـ رسالة التوحيد 11 ـ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 12 ـ تفسير سورة العصر 13 ـ تفسير جزء عم.
وأمتع تآليفه التي تجلى فيها علمه وبيانه هي (رسالة التوحيد)، هذا إلى تقريره في إصلاح الأزهر والمحاكم الشرعية ودفاعه عن الإسلام.
ومن الغريب أن هذه الآثار التي أفادت المسلمين في الآفاق كانت سبباً في وفاته، فقد عظمت آثاره وأعماله الإصلاحية التي كان يتفانى فيها لخدمة دينه ووطنه، فزاد ذلك في حسد الحساد وغيظ الخصوم، فجعلوا يحاربونه في إصلاحاتهبالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، وزادهم تشجيعاً على محاربته أن أمير البلاد الخديوي توفيق في عهده كان ينتقم منه لعدم تمشيه مع أهوائه، فكان الإمام يحمل هذا بصبر وجلد، حتى إذا كان قبل وفاته بعام سافر إلى السودان، ثم عاد يشكو ألماً في جسمه لم يعرف كنهه، فأشير عليه بالراحة، ولم يكن من طبعه أن يركن للراحة ولو كان في مرضه، وكانت محاربة حساده وخصومه مازالت على أشدها، فأضعف ذلك من صحته وضاعف من آلامه.
أمراضه: كان يشكو من الآلام في المعدة والأمعاء، ثم انتقلت هذه الآلام إلى الكبد، واختلف الأطباء في مرضه، وأشاروا عليه بترك العمل والسفر إلى أوروبا، فتهيأ للسفر في شهر حزيران سنة 1905م، ولكن السفن الدورية كانت قد امتلات بالمصطافين، فاضطر الى الانتظار إلى ما بعد الرابع عشر من الشهر المذكور، ومع اشتداد مرضه كان يذهب إلى دار الإفتاء ويزاول العمل ويقضي حاجات الناس، وينظر في أعمال الجمعية الخيرية ومجلس الشورى ومجلس الأوقاف الأعلى، ولما أعجزه المرض عن السير اضطر إلى الاعتكاف في سريره، ولم ينقطع عن الدرس والنظر في قضاء حاجات الناس، ودنا موعد الدور الثاني لسفر السفن إلى أوروبا، وكان قد استخرج جوازاً، ورأى الأطباء حالته وقد أنذرت بالخطر، فنصحوا أهله ومريديه بمنعه عن السفر، فمنعوه بحجة أن جسمه لا يقوى على مشقة السفر في البحر، وحببوا إليه الرياضة في الإسكندرية لتغيير الهواء، فوافق على ذلك وأعدت له داراً في رمل الإسكندرية.
دنو الخاتمة: واشتد عليه المرض وأخذ الكبراء والأمراء يترددون عليه واستسلم الإمام للقدر، وقال هذه الأبيات التي أملاها على الشيخ رشيد رضا قبل وفاته بأيام:
| ولست أبالي أن يقال محمد | أبل أم اكتظت عليه المآتم |
| ولكنه دين أردت صلاحه | أُحاذر أن تقضي عليه العمائم |
| وللناس آمال يرجون نيلها | إذا مت ماتت واضمحلت عزائم |
| فيارب إن قدرت رجعى قريبة | إلى عالم الأرواح وانقض خاتم |
| فبارك على الإسلام وارزقه مرشدا | رشيداً يضيء النهج والليل قاتم |
| يماثلني نطقاً وعلماً وحكمة | ويشبه مني السيف والسيف صارم |
أملى هذه الأبيات وقال: كأن الشعر لا يأنيني إلا في (السجن) و(المرض)، وهو يعني عن قصيدته التي قالها في السجن عقب الثورة العرابية، ومطلعها:
| مجدي بمجد بلادي كنت أطلبه | وشيمة الحر تأبى خفض أهليه |
وكان خلال المرض واشتداد آلامه يردد كلمة (الله أكبر)، وهذه الكلمة هي آخر كلماته، وكأنه وقد تغلب على كثير من العقبات واجتاز كثيراً من الصعوبات، ورأى الغلبة على الموت أكبر من أن تزيل عزيمته التي ذللت عظائم الأمور، ورأى للموت في تلك الساعة من جبروت وسلطان تصغر أمامه قوة الإنسان، فردد كلمة (الله أكبر).
وفي الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر تموز سنة 1905م، و8 جمادى الأولى سنة 1323م انتقل إلى عالم الخلود في القاهرة، وشيع جثمانه في اليوم الثاني، ونقل على قطار خاص من الإسكندرية الى القاهرة باحتفالعزَّ نظيره، ودفن بمقبرة (العفيفي) وهي بين تلول المقطم، وكتب على رخامة قبره (هو الحي الباقي):
| قد حططنا للمعالي مضجعا | ودفنّا الدين والدنيا معا |
كانت مدة حياته (57) عاماً، قضى أولها في التعليم، ووسطها في التعليم، وآخرها في إعلاه الدين ونفع المسلمين، وكان قصير القامة، أسمر اللون، ذا عينين شديدتي السواد.
وهكذا كانت حياة أعظم عبقري موهوب، سيبقى حيًّا خالداً بآثاره ومآثره، وبفضله وفضائله التي أغرت الناس بحبه، وأجبرت حساده على الاعتراف بمكانته، وقد تبارى الشعراء برثائه وتأبينه، وهذه مرثبة الشاعر حافظ إبراهيم نقتطف منها بعض أبياتها:
| سلام على الإسلام بعد محمد | سلام على أيامه النضرات |
| لقد كنت أخشى عادي الموت قبله | فأصبحت أخشى أن تطول حياتي |
| فوالهفي والقبر بيني وبينه | على نظرة من تلكم النظرات |
* * *