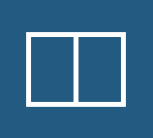مصطفى صادق الرافعي
مصطفى صادق الرافعي([1])
صاحب العبقريات الشامخة مصطفى صادق الرافعي
(1880 ـ 1937م)
تحية إعجاب وإكبار: بوركت الأرض التي أنجبت الأستاذ محمد سعيد العريان الأديب الكبير والمؤرخ المحقق الخطير، الذي أوحى إليه النبل والوفاء فعمل على إحياء ذكـرى الرافعـي وتخليـده بقلـم المؤرخ الصادق، ولا شـك أن ما أقدم عليه هو فريد من نوعه في عصر تنكر أهله للفضيلة، وطغت عليهم عناصر المادة والأنانية والجحود.
ويقضي علي الواجب أن أشيد بفضله من وما بذله من جهد عظيم يستحق الثناء والتقدير، والذي يدعو إلى الإعجاب والإكبار بمواهب هذا الأديب الفذ وفاؤه للرافعي، فقد كان ضرباً من الوفاء النادر بين البشر، ونهجاً مشكوراً في تقدير النبوغ.
حياه الله، ولا عدمت العروبة من أمثال النبلاء، وبورك ذلك اليراع الذي أبدع فجمع وأوعى ما جادت به قريحته المتقدة التي استقيت من معينها ترجمة الرافعي الخالد فخر العروبة والإسلام.
أسرته: لقد أوضحت عن أصل الأسرة الرافعية في ترجمة شعراء الرافعيين بأن بعض أفراد من هذه الدوحة المباركة قد نزحوا من طرابلس إلى مصر، فكان أول وافد إليها هو الشيخ محمد الطاهر الرافعي، قدمها سنة 1837م، ثم توافد إخوته وأبناء عمومته إلى مصر يتولون القضاء، حتى اجتمع منهم في وقت ما أربعون قاضياً في مختلف المحاكم المصرية، وأوشكت وظائف القضاء والفتوى أن تكون مقصورة على أحد أعلام الرافعيين.
لقد أعقب الشيخ محمد الطاهر الرافعي فتاة وغلام انتهى بموتهما نسبه، وهو شقيق الشيخ عبد القادر الرافعي الذي عهد إليه بمنصب الإفتاء بعد وفاة الإمام محمد عبده، فتوفي قبل أن يباشر عمله.
مولده: بزغ نجم صاحب العبقريات المرحوم مصطفى صادق الرافعي في شهر كانون الثاني سنة 1880م في (بهتيم) من قرى مديرية القليوبية، إذ آثرت والدته وهي كريمة الشيخ الطوخي ـ وكان تاجراً وأصله من حلب ـ أن تكون ولادتها في دار أبيها.
والده هو الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ محمد سعيد، والجد الطرابلسي هو الشيخ عبد القادر الرافعي، كان والده رئيساً للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم، وهو واحد من أحد عشر أخاً اشتغلوا كلهم بوظائف القضاء من أولاد الشيخ سعيد الرافعي.
نشأته: نشأ في مهد العلم والفضائل، في أسرة اشتهرت بالتمسك بأهداب الدين والحفاظ على الأخلاق، قضى سنة في مدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل أبوه قاضياً إلى محكمة المنصورة، فانتقل إلى مدرستها ونال الشهادة الابتدائية، وسنه يومئذ أقل من سبع عشرة سنة، وكان أستاذه في العربية العلامة مهدي خليل المفتش بوزارة المعارف.
محلته: وفي السنة التي نال فيها الرافعي الشهادة الابتدائية، وهي كل ما ناله من الشهادات المدرسية، والتي تتضاءل أمام كفائته كفاءات أصحاب الشهادات العالية شاء القدر القاسي فأصيب بمرض (التيفوئيد) أقعده في فراشه أشهراً، فما نجا منه إلا وترك في أعصابه أثراً، وكان حبسة في صوته ووقراً في أذنيه من بعد.
وأحس الرافعي آثار هذا الداء توقر أُذنيه، فأهمه ذلك همًّا كبيراً، ولم يجده العلاج وفقدت إحدى أذنيه السمع، ثم تبعتها الأخرى، فما أتم الثلاثين حتى صار أصم لا يسمع شيئاً مما حواليه، وانقطع عن دنيا الناس، وامتد الداء إلى صدرهوكاد يذهب بقدرته على الكلام، ولكن القدر أشفق عليه أن يفقد السمع والكلام، فوقف الداء عند ذلك الحد، وظل في حلقه حبسة تجعل في صوته رنيناً أشبه بصراخ الطفل.
وكانت بوادر هذه العلة التي أصابت أذنيه هي السبب الذي قطعه عن التعليم في المدارس بعد الشهادة الابتدائية، لينقطع إلى مدرسته التي أنشاها لنفسه، كان له من علته سبب يباعد بينه وبين الناس، فما يجد لذة ولا راحة في مجالسة أحد، فانطوى على نفسه، لقد كان يعجز أن يسمع، فراح يلتمس أسباب القدرة على أن يتحدث، وظلت لهجته قريبة من اللهجة السورية إلى آخر أيامه، وقد جعله إيمانه بحكمة القدر أقوى على مكافحة أحداث الزمن، وكان الشعور المرهف سبباً قويًّا وفر له أسباب المعرفة والمطالعة، والكتب العلمية في الأسرة الرافعية موفورة، وصدق من قال: (كل ذي عاهة جبار)، فقد كانت هذه العلة خيراً وبركة على هذا الفتى النحيل الضاوي الجسد، الذي هيأته القدرة بأسبابها والعجز بوسائله ليكون إمام أدباء العربية في تالدها وطارفها.
انتسابه للوظيفة: وفي شهر نيسان سنة 1899م انتسب للخدمة، فعين كاتباً في محكمة طلخا بمرتب شهري أربعة جنيهات، فكان يسافر بالقطار كل يوم ويعود إلى بيته، وفي فترات الذهاب والإياب استظهر نهج البلاغة ولما يبلغ العشرين من عمره بعد، وفي طلخا تعرف على شاعر العراق الكبير المرحوم عبد المحسن الكاظمي، ومنها نقل إلى محكمة إيتاي البارود الشرعية، وفيها تفتحت زهرة شبابه، ثم إلى طنطا، ومنها انتقل إلى المحكمة الأهلية بعد سنين، وفيها كان نضجه وإيناع ثمره، وظل فيها حتى وافته المنية، لم تكن الوظيفة عائقاً بينه وبين فنونه، ولم يكن يراها إلا شيئاً يعينه على العيش، وكان راضياً في مكانه من الوظيفة، ولكنه لم يكن ليرضى مكاناً بين الأدباء دون الصدارة، وهو لو أراد أن يكون في الوظائف ذا مرتبة عالية لخسر إمارة الأدب، وخسرته الأمة، وخسره الخلود، ولكن نفسه الشاعرة أبت أن تقنع ببريق زائل، ورامت تطلب مكان الثريا في الأدب.
فإذا استطاع أهل السياسة بذكائهم أن يصبحوا يوماً وزراء، فطريق الشهرة السياسية أقصر وأسهل منالاً من طريق النبوغ الأدبي، ومنهم من غرته نفسه فطمع أن يكون من أدباء هذه الأمة فكبا واختفى، فالعباقرة هم وحدهم الذين يستطيعون أن يصبحوا أدباء أو فنانين.
الصدمة الأولى: تقدم رئيس المحكمة بشكوى ضد الرافعي لتهاونه في العمل والدوام على الوظيفة، فانتدبت وزارة العدل الشاعر المشهور المرحوم حفني ناصيف للتفتيش والتحقيق معه، ورفع تقريره، وقد جاء فيه: إن الرافعي ليس من طبقة الموظفين الذين تعنيهم الوزارة بهذه القيود، إن للرافعي حقًّا على الأمة أن يعيش في أمن ودعة وحرية، إن فيه قناعة ورضى، وما كان هذا مكانه ولا موضعه لو لم يسكن إليه، دعوه يعيش كما يشتهي أن يعيش، واتركوه يعمل ويفتن ويبدع لهذه الأمة في آدابها ما يشاء أن يبدع، وإلا فاكفلوا له العيش الرضي في غير هذا المكان.
وما زاد مرتب الرافعي الشاعر الكاتب الأديب الذائع الصيت في الشرق والغرب الموظف الصغير في محكمة طنطا الأهلية على بضعة وعشرين جنيهاً في الدرجة السادسة بعد خدمة ثمان وثلاثين سنة قضاها في وظائف الحكومة.
وقد تجلت عبقريته في الوظيفة، إذ كان المرجع الأخير لوزارة العدل، تستفتيه في مشاكلها العريضة، فيكتب إليها برأيه، لتبلغه في منشور عام إلى كل المحاكم الأهلية للعمل بمقتضاه.
تحت راية القرآن: لقد كان الرافعي أمير البلاغة والبيان، يبدع المعاني العربية، ولم يحاول أبداً كغيره من أدباء هذا الجيل أن ينقل أفكاراً غربية على ألفاظ مستعربة، وقد ترك للأجيال آثاراً فنية رائعة، وهو آخر من يستطيع أن يكتب بهذا البيان العربي المبين، وأضحت مؤلفاته كعبة للفن الإنشائي والسمو الفكري.
لقد كان الرافعي على يقين من أنه رسول بياني أرسل لتأييد بلاغة القرآن وإحياء آدابه وأخلاقه التي هي حصون الإسلام، فبعث الله هذا النابغة في هذا العصر ليجدد من بلاغة البيان العربي، ويضيف من وحي قريحته إلى الميراث الأدبي روائع معجزاته.
وظهرت في أوائل هذا القرن في مصر (بدعة لغوية) نادى بها ودعا إليها نفرٌ من الكتاب، وكانت هذه البدعة تدعو إلى (تمصير اللغة العربية) بأن تدخل فيها الألفاظ السوقية وتمزج تراكيبها بالمصطلحات العامية، حتى تخرج لغة الكتابةفي أسلوب يجمع كل اللهجات المصرية، فيفهمها الناس جميعاً، وكان يؤيد هذا الرأي الأستاذ أحمد لطفي السيد باشا بما ينشره في (الجريدة) التي كان يتولى تحريرها، وما لبثت أن أنجبت مولوداً سموه (الجديد)، ومعناه أن تكون لنا عربية جديدة لا تجري في بيانها على أساليب العرب الفصحاء، وأن لا نتقيد فيما نكتب بأصول البلاغة العربية، وجعلوا الأدبي البليغ (قديماً) يجب أن يذهب بذهاب أهله، ولأن هؤلاء الدعاة لم يجدوا أمامهم من يذود عن هذا الميراث ويدافع عن لغة القرآن أقوى من الرافعي فقد نحلوه زعامة هذا الأدب الذي أصبح في رأيهم (قديماً)، ونشبت بينه وبينهم معارك طاحنة كان ينازلهم فيها وحده (تحت راية القرآن)، في حين كانوا جمعاً كبيراً ذا قوة وجاه وسلطان، ولم يزل يكافحهم بشباة قلمه البليغ حتى قضى على تلك البدعة وما نحلت، وكتب الله النصر للغة كتابه الكريم.
وقد عاش يجاهد في سبيل هذه الرسالة، لا يمل ولا يلين، وناله من هذا الجهاد ما ينال الرسل في جهادهم من أذى، وأصابه ما يصيبهم من إرهاق حتى لقي ربه راضياً مرضيًّا.
ومن عجيب الأمر أنك ترى اليوم بعض من كانوا يدعون إلى هذه البدع قد أصبحوا من أشد الناس تعصباً لأساليب العربية في بيانها ولغتها.
ومن مآثره التي سجلها له الأدب العربي في صحائف مفاخره أنه لما أنشئت الجامعة المصرية في سنة 1908م لم يكن في مناهجها دراسة آداب اللغة العربية، فغضب وحمل حملة صادقة على إدارة الجامعة لكي تتدارك تفريطها العظيم، وما لبثت أن عادت إلى الصواب وقررت تدريس آداب اللغة، ولا تزال هذه الدراسة تنمو وتزدهر.
الخصومة الأدبية: الخصومة بين الرافعي وطه حسين، وبين الرافعي والعقاد، وبين الرافعي وعبد الله عفيفي المحرر العربي بديوان الملك فؤاد الذي أصبح شاعراً بعده، وبينه وبين غير هؤلاء خصومة مشهورة، وإن قراء العربية عامة يعرفون الرافعي الناقد وشدته وعنفوانه في النقد شدة حببته وألبت عليه الكثير.
وكانت المنافسة بينه وبين إبراهيم حافظ شاعر النيل منافسة مؤدبة كريمة لم تعكر ما بينهما من صفة المودات، وظلا صديقين حميمين منذ تعارفا في سنة 1900م.
وأول شأنه في النقد عن شعراء العصر في سنة 1905م، وقد نشبت معارك أدبية طاحنة بين الرافعي ولفيف من أدباء عصره بعد ذلك بعشرين سنة، وكان يرى عمله ذلك جهاداً تحت راية القرآن.
ابتدأت الخصومة بين الرافعي وطه حسين (حول رسالة الأحزان) إلى أن انتهت عند مجلس النواب حول كتابه في (الشعر الجاهلي).
أخرج كتاب (على السفود) وهو خلاصة مذهب الرافعي في النقد وأسلوبه في الجدال، وبينهما أشلاء المعركتين الطاحنتين بينه وبين طه حسين، وبينه وبين العقاد، وأكثر الخصومات كانت دفاعاً عن الدين وحفاظاً على لغة القرآن.
ومن رأي الرافعي أن الدكتور زكي مبارك لا يعد شاعراً ولا ناثراً، إذ ليس في إنشائه عبارة بليغة يشرق منها نور البيان، وقد سماه (نثروراً)، فإذا كان ذكي مبارك في رأي سيد البلغاء (نثروراً)؛ فماذا تكون درجات أولئكم الذين يظنون أنفسهم أنهم من كبار الكتاب والأدباء؟!
لقد كان أفقه العلماء في دينه، وأعلم الأدباء بلغته، وواحد الآحاد في فنه، والدين واللغة والآداب هذه هي عناصر شخصيته وروافد عقليته وطوابع وجوده.
عبقريات الرافعي: إن التاريخ الأبي للرافعي يبدأ في سنة 1900م، لقد عاش في خدمة العربية سبعاً وثلاثين من عمره القصير، ولكنها عصر بتمامه من عصور الأدب، وفصل بعنوانه في مجد الإسلام.
تأثر الرافعـي بشـعراء عصـره وأكـد صلتـه بالبارودي، وحافظ إبراهيم، والكاظمي، وعقد آصرة بينه وبين الإمام محمد عبده، لقد كانت عبقريات الرافعي تتنزل على قلمه المرسل حين تمتد الأفيكة إلى كتاب الله أو إلى لغة العرب أو إلى أدبه.
بدأ الرافعي ينظم القريض ولما يبلغ العشرين من عمره، وأصدر ديوانه الأول وهو لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، وقرظه الشعراء والأدباء، منهم الشيخ إبراهيم اليازجي صاحب مجلة الضياء وأديب العصر وأبلغ منشئ في العالم العربي الذي أعجب بمقدمة ديوانه الرائعة، فقال: (إن الناظم كما بلغنا لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، ولا ريب أن من أدرك هذه المنزلة في مثل هذا السن سيكون من الأفراد المجلين في هذا العصر، وممن سيحلون البلاغة بقلائد النظم والنثر).
وأصدر سنة 1904م الجزء الثاني من الديوان، وفي سنة 1906م أخرج الجزء الثالث، وفي سنة 1908م أخرج الجزء الأول من ديوان النظرات، وتألق نجم الرافعي الشاعر وبرز اسمه بين عشرات الأسماء من شعراء عصره، ولقي من حفاوة الأدباء ما لم يلقه الأقلون من أدباء هذه الأمة، فكتب إليه الإمام الشيخ محمد عبده يقول:(أسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيفاً يمحق به الباطل، وأن يبقيك في الأواخر مقام حسان في الأوائل).
وكتب إليه الزعيم مصطفى كامل باشا يقول: (وسيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس: هو الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان).
وقال الأستاذ الكبير أحمد لطفي السيد: (فكأني وأنا أقرؤه أقرأ من علم المبرد في استعمال المساواة وإلباس المعاني ألفاظاً سابغة مفصلة عليها، لا طويلة تتعثر فيها، ولا قصيرة عن مداها تودي ببعض أجزائها).
وكتب الأمير شكيب أرسلان مقالة في صدر المؤيد جاء فيها: (لو كان هذا الكتاب خطًّامحجوباً في بيت حرام إخراجه للناس لاستحق أن يحج إليه، ولو عكف على غير كتاب الله في نواشئ الأسحار؛ لكان جديراً بأن يعكف عليه)، ثم خلع الأمير شكيب على الرافعي لقب إمام الأدب وحجة العرب.
وكتب عباس محمود العقاد عن أسلوب الرافعي، وبين العقاد والرافعي خصومات لم يعرف التاريخ الأدبي أشد منها، يقول: (وإنه ليتفق لهذا الكاتب من أساليب البيان ما لم يتفق مثله لكاتب من كتاب العربية في صدر أيامها).
وأخرج الرافعي كتاب (إعجاز القرآن) الذي كتب عنه سعد زغلول قوله المأثور: (بيان كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم).
وقال أحمد زكي باشا عن كتاب المساكين: (جعلت لنا شكسبير، كما للإنكليز شكسبير، وكما للإفرنسيين هوكو، وكما للألمان جوته).
أسلوبه في الكتابة: كان نسيج وحده في أسلوبه المعجز، فاجتمع له هو وحده تراث الأجيال من هذه الأمة العربية، فعاش ينبهها إلى حقائق وجودها، وقد أجد على الإسلام معاني لم تكن لتخطر على قلب واحد من علماء السلف، وكان مذهبه في الكتابة أن يعطي قراء العربية أكبر قسط من المعاني، ويضيف ثروة جديدة إلى اللغة، وقد بلغ ما أراد، ولعل أحداً لا يعرف أن الرافعي لم يكن يرى في تلك العلة التي ذهبت بسمعه وهو لم يزل غلاماً، إلا نعمة هيأته لهذا الينبوع العقلي الذي أملى به في تاريخ الأدب فصلاً لم يكتب مثله في العربية منذ قرون، إذ لم يكن يمر به حادث يألم له أو يقع له حظ يسر به إلا كان له من هذا وذلك مادة للفكر والبيان؛ ليزيد بها في البيان العربي ثروة تبقى على الدهر، وقد قال الرافعي عن نفسه: إنه لا يمس من الآداب كلها إلا نواحيها العامة، ويخيل إليه دائماً أنه رسول لغوي بعث للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه، وأن عليه رسالة يؤديها، وله غاية أخرى هو عليها أقدر وبها أجدر. فجعل الهدف الذي يسعى إليه أن يكون حارسه وحاميه يدفع عنه أسباب الزيغ والضلال.
كان يعنى بتجويد عباراته ويبالغ في صقلها حتى تخرج في أروع صورة البيان العربي، وكان يرى نفسه من أول يوم أنه أديب الأمة، وظل كذلك يرى نفسه لآخر يوم.
عشقه: لقد مس الحب قلبه، واتقدت جذوته في أعصابه سنة 1923م، كان عاشقاً غلبه الحب على نفسه، وما غلبه على دينه وخلقه، ومن وحي هذا الحب كان أكثر قصائد الرافعي الغزلية في الجزء الأول من الديوان، ومنه كان ولوعه في صدر أيامه بلقب شاعر الحسن، لقد كان حبه بركة في الأدب وثروة في العربية، كان حبه ليس من حب الناس، حب فوق الشهوات، وفوق الغايات الدنيا؛ لأنه ليس له مدى ولا غاية، كان يلتمس الحب ليجد فيه ينبوع الشعر وصفاء الروح، وحسبه أنه كان الوحي الذي استمد منه الرافعي فلسفة الحب والجمال في كتبه الثلاثة: رسائل الأحزان، والسحاب الأحمر، وأوراق الورد.
وحب الرافعي كقصة كل شاعر مرهف الحس، رقيق القلب، عميق العاطفة، كقصة كل فنان أخلص للفن، وعاش للفن والطبيعة والجمال والخير.
إن قصة حبه قديمة أزلية، امتدت إليه من أفئدة الشعراء وعباقرة الفن.
لقد كان الرافعي متيماً بالكاتبة الأديبة المعروفة (مي زيادة)، وكان بينهما رسائل وأحاديث، ولكن الأمر اليقين أن الرافعي كان عاشقاً، ومن غلاة العشاق، وأنه كان ملهماً في حبه، وأن هذا الحب قاده إلى الخلود ورفعة إلى الذروة في الأدب، وأوحي إليه من البيان ما لم يوح لغيره، لقد خلده الحب وخلد هو أحلام الحب، لقد خلد هذه الأحلام في رسائل الأحزان، لا لأنها من الحزن جاءت، ولكن لأنها إلى الحزن انتهت، ثم لأنها من لسان كان سلماً يترجم من قلب كان حرباً، ثم لأن هذا التاريخ الغزلي كان ينبع كالحياة، وكان كالحياة ماضياً إلى قبر.
لقد أحبها جهد الحب ومداه، حبًّا أضل نفسه وشرد فكره، وسلبه القرار، ولكنه كما يقول الأستاذ الأجل محمد سعيد العريان، حب عجيب ليس فيه حنين الدم إلى الدم، ولكن حنين الحكمة إلى الحكمة، وهفوة الشعر إلى الشعر، وخلوة الروح إلى الروح في مناجاة طويلة، كأنها تسبيح وعبادة، لقد أحبها عقلاً جميلاً، وأحبته بياناً جميلاً، وكان لا بد لهذا الحب أن يلد كحب كل شاعرة عبقرية، فولد قصة اليمامتين، وأوراق الورد، وإليك وريقة من هذه الأوراق التي جمعت نضرة الخلود، لتتحسس بهذا الحسن العلي، وتتذوق هذا التحليق الأدبي الذي علا فوق كل تحليق، فقد قال الرافعي:
وإنه ليس معي إلا ظلالها، ولكنها ظلال حية تروح وتجيء في ذاكرتي، وكل ما كان ومضى هو في هذه الظلال الحية كائن لا يفنى، وما أريد من الحب إلا الفن، فإن جاء من الهجر فن فهو الحب... ولن أطلب الحب إلا في عصيان الحب، أريدها غضبى، فهذا جمال يلائم طبيعتي الشديدة، وحب يناسب كبريائي، ودع جرحي يترشش دماً، فهذه لعمري قوة الجسم الذي ينبت ثمر العضل وشوك المخلب، وما هي بقوة فيك إن لم تقو أول شيء على الألم...
وكأنما اجتمع في كتاب أوراق الورد ـ منذ كانت الخليقة ـ كل خلجات القلوب العاشقة ومعاني الأفئدة الوالهة، فانتقى بيان الرافعي منها طاقة ورد لا تذبل، وإن قارئ أوراق الورد يتحسس بأنه يرقي بهذا النثر إلى آفاق سامية من الشعر، إلى آفاق لم يبلغها غزل ابن المعتز، وابن زيدون، والبحتري، وابن الفارض، وشوقي.
كان الرافعي نزاعاً إلى الجمال، طماحاً إلى الفضيلة، مولعاً بكل خلق كريم، يفيض قلبه بالإيمان والطهر.
شاعر الملك: اتصل ببلاط الملك فؤاد سنة 1926م، واستمر يرسل قصائده في مديحه في المناسبات إلى سنة 1930م، ثم سكت لمقتضيات خاصة.
لم يكن للرافعي شاعر الملك أجر على هذا المنصب في حاشية الملك إلا الجاه وشرف النسب، وجواز مجاني في الدرجة الأولى على خطوط سكة الحديد، ودلال وازدهاء على الموظفين في محكمة طنطا الكلية الأهلية، وقد استفاد من هذا النسب الملكي، فتعطف الملك، فأمر بطبع كتاب (إعجاز القرآن) على نفقة جلالته، كما أذن بإرسال ولده السيد محمد في بعثة علمية لدراسة الطب في فرنسا، فظل يدرس في جامعة ليون إلى سنة 1934م على نفقة الملك حتى شاء الأبراشي باشا لسبب ما أن يقطع عليه المعونة الملكية، ولم يبق بينه وبين الإجازة النهائية غير بضعة أشهر، فقام أبوه بالإنفاق عليه ما بقي، وكان الرافعي ينشر في مجلة الرسالة مقالاتهويتقاضى عنها الأجر ليؤمن نفقات العيش.
لقد كلف الرافعي بالشعر من أول نشأته، فما كان له هوى إلا أن يكون شاعراً عبقريًّا، والعبقري إذا اتزنت فيه العبقرية أصبح نبيًّا، أما إذا شردت عبقريته فقد أصبح شاعراً أو فيلسوفاً، وظل ينظم الشعر، ثم تطورت به الحياة فانحرف عن الهدف الذي كان يرمي إليه من الشعر، وليس كل شعر الرافعي في دواوينه، فالجيد الذي لم ينشر من شعره أكثر مما نشر، وكان مزمعاً على جمع شعره في ديوان واحد ليقدمه هدية منتقاةإلى الأدباء والمتأدبين، ولكن الموت غاله، فحال دون أمنيته، وبقي عمله تراثاً باقياً لمن يشاء أن يسدي يداً إلى العربية يتم بها صنيع الرافعي.
ومن رأيه أن في الشعر العربي قيوداً لا تتيح له أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبر عن نفسه الشاعرة، لقد كان يشعر بالعجز عن الإبانة عن كل خواطره الشعرية في قصيدة من المنظوم، فعدل عن قرض الشعر ونزع إلى النثر الفني، لا يقولهإلا إذا دعته الحاجة.
أناشيده الوطنية: لقد ولع منذ نشأته في الشعر، والأناشيد الوطنية، والأغاني الشعبية، وقد اشتهر من بين قصائده الوطنية هذه، ومطلعها:
| بلادي هواها في لساني وفي دمي | يمجدها قلبي ويدعو لها فمي |
وأشهر أناشيده (اسلمي يا مصر)، فقد أصبح نشيد مصر القومي، و(إلى العلا إلى العلا بني الوطن)، وألف نشيد الاستقلال، والنشيد الخالد ليكون شعار الشبان المسلمين، ونشيد الملك، ونشيد بنت النيل، ونشيد الكلية، أو نشيده الرائع (حماة الحمى)، فهذا مطلعه:
| حماة الحمى يا حماة الحمى | هلموا هلموا لمجد الزمن |
| لقد صرخت في العروق الدما | نموت نموت ويحيا الوطن |
ولكل نشيد مناسبة وطنية تاريخية، وهي ما زالت تردد حتى الآن.
آثاره الأدبية: وهذا ثبت بمؤلفاته الخالدة المطبوعة: 1 ـ ديوان الرافعي: ثلاثة أجزاء صدرت بين سنتي 1903م و1906م. 2 ـ ديوان النظرات: أنشأه بين سنتي 1906م و1908م. 3 ـ ملكة الإنشاء: يحتوي على نماذج أدبية. 4 ـ تاريخ آداب العرب: أصدره في سنة 1911م، وقد نال بمؤلفه هذا مكاناً سامياً بين أدباء عصره وشغل به العلماء. 5 ـ إعجاز القرآن، والجزء الثاني من تاريخ آداب العرب، ومات الرافعي وفي مكتبة أصول الجزء الثالث من تاريخ آداب العرب، وقد نشرته المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة سنة 1940م. 6 ـ حديث القمر: وهو أسلوب رمزي في الحب أنشأه بعد رحلته إلى لبنان في سنة 1913م، حيث التقى لأول مرة بالآنسة الأديبة المرحومة (مي) . 7 ـ المساكين: فصول في بعض المعاني الإنسانية، ألهمه إياه بعض ما كان في مصر من أثر الحرب العامة، أنشأه في سنة 1917م.8 ـ نشيد سعد باشا زغلول: اسلمي يا مصر. 9 ـ النشيد القومي المصري: إلى العلا.10 ـ رسائل الأحزان.11 ـ السحاب الأحمر.12 ـ المعركة تحت راية القرآن، وفيه قصة ما كان بينه وبين الدكتور طه حسن لمناسبة كتابه (في الشعر الجاهلي)، صدر في سنة 1926م.13 ـ على السفود: قصة الرافعي والعقاد. 14 ـ أوراق الورد: الجزء الأخير من قصة حبه. 15 ـ رسالة الحج. 16 ـوحي القلم: مجموع مقالاته في الرسالة بين سنتي 1934م و1937م.
أما مؤلفاته التي لم تطبع فأهمها: 17 ـ أسرار الإعجاز: يتحدث فيه عن البلاغة العربية وعن بلاغة القرآن وأسرار إعجازه. 18 ـ ديوان أغاني الشعب. 19 ـ الجزء الثالث من وحي القلم. 20 ـ الجزء الأخير من الديوان: وهو مجموعة كبيرة من شعره بين سنتي 1908م و1937م بما فيه من شعر الحب والمدائح الملكية التي أنشأها للملك فؤاد.
أما مقالاته: (في اللهب ولا تحترق)، فإنه لم ينشأ مثلها في روائع الأدب العربي، ومقالاته في الانتحار هي باب من الأدب لم ينسج على منواله في العربية من قبل، فيها فنه القصصي، وفيها شعر وفلسفة وحكمة، وسيكون لأدبه الخالد شأن عظيم عند الأجيال المقبلة في التاريخ، وليس أدبه من السهولة بالمقدار الذي توهمه بعض الأدباء المستكبرين، فظنوا أن في إمكانهم هدمه، فالكثرة المطلقة مدينة لأدب الرافعي في توجيهها إلى طريق الأدب الصحيح.
فـي المجامـع العلميـة: لـم يكن من أعضاء المجمع اللغوي المصري؛ لأنه لا يسمع، وقد نقده وانتسب إلى عضوية المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1920م.
لقد كان الأديب الكبير الأجل الأستاذ سعيد العريان يقوم بمرافقته، ويكتب له الأسئلة والأحاديث التي كانت تدور بينه وبين الناس.
أسرته: اقترن الرافعي في سنة 1904م وكان في الرابعة والعشرين من عمره من السيدة نفسية من أسرة البرقوقي في منية جناح دسوق، وعاشا ثلث قرن على أهنأ ما يكون، وتوفيت في سنة 1949م.
ومن ذريته الدكتور محمود سامي، والدكتور محمد، وعبد الرحمن وهو من ضباط المدفعية في الجيش المصري.
أوصافه: كان رحمه الله ذا وجه ممسوح مستطيل، وجبهة عريضة، وأنف طويل، مستدق من أعلاه منتفخ من أسفله، أشمط خفيف شعر الرأس، حليق اللحية، عريض المنكبين، غليظ، قوي الكتف والساعد بما كان يعالج من تمريناتالرياضة، في عينيه سحر يشع منهما أسرار العبقرية والنبوغ.
أما إباؤه وشممه وعزة نفسه؛ فهي مضرب الأمثال، فقد كان لا يخضع لإنسان، ولا ينافق لمخلوق، ولا يستعين بكبير، ولا يستنصر بوزير، كأنه الجبل الأشم الذي لا يستند إلى شيء.
وتعبر مقالته (حديث قطين) عن خلقه، وأبرز سجاياه، هي طبيعة الرضا بما هو كائن، فقد كان من ألزم صفاته له، وكان دائماً باسماً منبسط الوجه، يقوم بأداء فروض الصلاة بأوقاتها، فمن عرف وحي الله في قرآنه، وفهم إعجاز الفن في بيانه؛ أدرك سر العقيدة في إيمانه، حتى إن الناس لينزلون الرافعي من نفوسهم منزلة الأولياء الصالحين.
وفاته: لقد استطاع الدهر في لمحة من الزمن أن يطوي الشمس في ظلمة الرمس، واستطاع أن يدك طوداً كان شامخاً كالجبل الأشم.
استيقظ في الساعة الخامسة، فصلى الفجر وهو يجد في جوفه حزة كان تعتاره من حموضة الطعام، فلما فرغ دخل على ولده الطبيب، فسقاه دواء، ثم عاد فنام، وهب من نومه في منتصف الساعة السابعة وخرج يريد الحمام، فسقط جسداً بلا روح، وذلك في صباح يوم الإثنين 10 مايس سنة 1937م و29 صفر سنة 1356ﻫ، وحمل جثمانه بعد الظهر ودفن في جوار أبويه بمقبرة الأسرة الرافعية بطنطا.
لقد عاش سبعاً وخمسين سنة ثم طواه الموت، وعاد إلى التاريخ بعد ما بلغ رسالته، ولو كان حليفاً للحياة لأمهل فقيد للعروبة حتى يضيف إلى أدبه وبيانه آيات من المعجزات الشامخة.
لقد فقدت الأمة العربية الرافعي الذي كان ولن يكون لها مثله في الدفاع عن دينها ولغتها، وتلقى العالم العربي النعي وفي النفس حسرة والتياع.
وماذا يضيرهإذا لم يشيعه إلى مرقده في رمسة المشرق إلا بضع عشرات من زملائه أو من جيرانه؟! لقد شيعته الملائكة التي دافع عن قرآن ربها لتنعم روحه بالخلود الأبدي في موكب تهادى مع الشمس، وماذا يضيره أن عقه الأدباء ولم تقم لإمام الأدب حفلات التأبين وقد كان يراعه أعظم هيبة من صولجان الملوك، وله من المعجبين بأدبه جيوش... وجيوش؟!
والحق أن القلم المرهف، والبيان المشرق ليعجزان عن تعداد ما يتصف به من مناقب عالية، وخلال إنسانية صافية، حيث لا يستطيع التحدث عن الرافعي نفسه، ولكن قضى علينا الواجب التاريخي أن نوجز ترجمته الفذة بهذا القدر من الحديث.
رحم الله الرافعي، فقد كان بينه وبين موكب الشمس موعد للخلود الدائم.
* * *