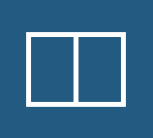مصطفى لطفي المنفلوطي
مصطفى لطفي المنفلوطي([1])
(1876 ـ 1924م)
هو من الأدباء الذين كان لطريقتهم الإنشائية أثر في الجيل الحاضر، ولد في منفلوط من صعيد مصر سنة 1876م، وتلقى علومه في الأزهر، وكان يميل إلى مطالعة الكتب الأدبية كثيراً، ولزم الشيخ محمد عبده فأفاد منه.
آثاره: ومن آثاره: 1 ـ النظرات، وتقع في ثلاثة أجزاء، وهي مجموعة مقالاته وآرائه الاجتماعية، وتذهب آراؤه إلى إحياء الفضيلة الصحيحة والضمير النقي 2 ـ العبرات 3 ـ الشاعر 4 ـ الفضيلة 5 ـ ماجدولين، وهي قصص عربها بالواسطة، وتتميز كتابته بصدق العاطفة في آرائه واندفاعه الشديد من أجل المجتمع، وقد استطاع أن ينقذ أسلوبه النثري من الزين اللفظية والزخارف البديعية، ولكن عيب ترادفه وتنميقه الكثير، واعتناؤه بالأسلوب المصنوع دون المعنى العميق.
أطواره: كان يميل في نظرياته إلى التشاؤم، فلا يرى في الحياة إلا صفحاتها السوداء، فما الحياة بنظره إلا دموع وشقاء، وكتب قطعة (الأربعون) حين بلغ الأربعين من عامه، وقد تشائم فيها من هذا الموقف، وكأنه ينظر بعين الغيب إلى أجله القريب.
شعره: ومن شعره يخاطب نهر النيل فيقول:
| عهدناك صبًّا بالوفاء فما لنا | نرى ماء ذاك العهد قد صار بنضب |
| قسوتَ وما عهدي بقلبك صخرة | فجوهرك السيّال بالرفق أنسب |
| فرحماك نهر النيل بالأنفس التي | إذا لم تداركها برحماك تُعطب |
| فمدّ يداً بيضاء منك تنيلنا | من الخير ما نرجو وما نتطلب |
| وليس لنا إلا الدموع وسيلة | إليك فإن الشبه بالشبه يجذب |
| لقد كان في فيض المدامع ناقع | لغلتنا لو كان مثلك يعذب |
على فراش الموت: بانت به المنية، فبانت عن أنصاره وعشاق أدبه، وهذه العبرة التي كان يزجيها إلى النفوس بعبراته، وهذه المتعة التي كان يهديها إلى القلوب بنظراته، وهذا الأنس الذي كان يظلل كل قارئ لكتبه، وهذا الخلق الكامل الذي كان يتجلى في سيرته وأدبه، وتلك العاطفة الرقيقة التي لا تباريها رقة السلافة ولا خفة النسيم ولا صفاء الماء، وكانت للعاشقين برداً وسلاماً، وللبائسين عطفاً وحناناً ولليائسين عزاء وسلواناً.
رحل كل ذلك عن الأحياء فيما عدا ما بقي من آثاره، وغاض ذلك النبع الفياض، وكان منهلاً عذباً لكل قارئ، ومورداً صافياً لكل متأدب، وانطفأت تلك الجذوة التي كانت أسى وألماً على المساكين، وتلتهب حزناً وشجواً للمحبين، ورقد هذا القلم وقد جفّ عنه المعين الذي كان يستمد منه الحياة والقوة والجمال، وعجز حتى عن رثاء صاحبه.
ووصف فجيعة الأدب به، ولم يكن ليعجز عن وصف المآسي، وندب النوابغ، وبكاء الفواجع، وعزاء المصابين.
مأتم الطبيعة:طوى الموت ما بين المنفلوطي وبين الناس، فهل نعته في يومه ألسنة الناعين؟! وهل بكته في مصابه أعين الباكين؟! وهل شيعته إلى مقره هذه الآلاف التي كانت تعجب به وتتبعه بنبوغه وأدبه؟!
مرضه: أصيب بشلل بسيط قبل وفاته بشهرين، فثقل لسانه منه عدة أيام، فأخفى نبأه عن أصدقائه، ولم يجاهر بألمه، ولم يدع طبيباً لعيادته، لأنه كان لا يثق بالأطباء، ورأيه فيهم أنهم جميعاً لا يصيبون نوع المرض، ولا يتقنون وصف الدواء، ولعل ذلك كان السبب في عدم إسعاف التسمم البولي الذي أصيب به قبـل اسـتفحاله، فقـد كـان قبـل إصابته بثلاثة أيام في صحة تامة وعافية سابغة، لا يشكو مرضاً ولا يتململ من ألم.
وفي ليلة الجمعة السابقة لوفاته، كان يأنس في منزله إلى إخوانه ويسامرهم ويسامرونه، وكـان يفـد إليـه بعض أخصائـه وأصدقائه من الأدباء والموسيقيين والسياسيين، حتى إذا قضى سهرته معهم انصرفوا إلى بيوتهم ومخادعهم، وانصرف هو إلى مكتبه فيبدأ عمله الأدبي في نحو الساعة الواحدة بعد نصف الليل.
ذبحة صدرية: وفي نحو الساعة الثانية عشرة من تلك الليلة انصرف أصدقاؤه كعادتهم وانصرف إلى مكتبه، ولكنه ما كاد يمكث طويلاً حتى أحس يتعب أعصابه وشعر بضيق في تنفسه، فأوى إلى فراشه ونام، ولكن ضيق التنفس أرّقه حتى إذا أقبل الصبح واستيقظ الأحياء كان يضيق بالدنيا ومن فيها، واستمر في ذلك يومه، ودعي له الطبيب، وكان احتباس البول قد سمم دمه، فأصابه بذبحة صدرية كانت هي العلة التي ضايقته، وكان يعاني ضيقاً مستمراً في التنفس، ويتقلب على الفراش يميناً وشمالاً، وجلوساً ونوماً، ولم تكن حالته بالتي تزعج أهله، حتى إذا كانت ليلة عيد الأضحى اشتد الضيق وثقلت العلة، فجعل يضع رأسه مكان قدميه، وقدميه مكان رأسه، ولم تكن تسكن له حركة أو يهدأ له جسم أو يغفو له طرف أو يستقر به مضجع، وانتابته الذبحة، واشتدت آلامها.
دبيب الموت: كتب عليه أن يختم حياته بالتأوه والأنين، كما عاش متأوهاً من مآسي الحياة ساجعاً بالأنين والزفرات، وأدار وجهه إلى الحائط، وكان صبح عيد الأضحى قد أشرقت شمسه ودبت اليقظة في الأحياء، فدب الموت في جسمه في سكون، وارتفعت روحه مطمئنة إلى السماء بعدما عانت آلامها على الأرض سنة 1924م.
* * *