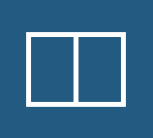ذو النون بن إبراهيم المصري الأنصاري
النُّوْنِ بنُ إِبراهِيمَ المصريُّ الأنصاريُّ
ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،
فقال :
[اسمه: ] ذُوْ النُّوْنِ([1]) بنُ إِبراهِيمَ المصريُّ([2])، الأنصاريُّ، مولاهُم، النُّوْبِيُّ الأصلِ، أبُو الفَيْضِ، ويقـالُ: أبو الفَيَّاضِ، الزَّاهِـدُ، العارفُ، قيل: اسمُه ثَوْبَانُ، وقيل: الفَيْضُ.
وهو إِخْمِيْمِيٌّ من قريةِ إِخْمِيْمَ من أعمالِ مصرَ([3]).
وكان زاهداً مجتهـداً، حكيماً، فاضلاً، واعِظاً، فصيحاً، استخصَّهُ المتوكِّلُ على اللهِ([4]) من مصرَ إلى سُرَّ مَنْ رَأَى([5])، حتَّى رآهُ وسمع كلامَهُ([6]).
[وفاته: ] وأَقـام ببغدادَ مدَّةً، ثم عـادَ إلى مصـرَ إلى أن تُوفِّي بالجِيْزةِ([7]) للثلاثينَ([8]) خليا من ذي القَعدةِ سنةَ ستٍّ وأربعينَ ومائتينِ، وحُمِلَ إلى الفُسْطاطِ في مركبٍ خوفاً عليـه من زحمةِ الناسِ في الجسرِ، ودُفِنَ في مقابرِ أهل المَعَافِرِ رحمةُ الله عليـه([9]). قال أبُو عبدِ الرحمن السُّلَمِيُّ([10]): لمَّا ماتَ أَظَلَّتِ الطيرُ جنازَته([11]). انتهى.
ذكره أبُو محمدٍ هبةُ اللهِ بنُ الأَكْفَانِيِّ في «تسميتِه من روى الموطَّأَ عن مالكٍ» رحمةُ الله عليه([12]).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: يروي عن مالكٍ أحاديثَ فيها نظرٌ([13]). انتهى.
قال الذّهبيُّ: كـان ممَّن امتُحِـن وأُوْذِيَ، لكنّه([14]) أتاهُم بعلمٍ لم يعهدوه، وكان أوّلَ من تكلَّمَ بمصرَ في ترتيبِ الأحوالِ وفي مقاماتِ الأولياء، فقال الجَهلةُ:هو زنديقٌ([15]). انتهى.
222 ـ أخبرنا جماعةٌ منهم أبُو هريرة عبدُ الرحمن بنُ محمدٍ الذَّهبيُّ مشافهةً بالإجازة، عن الحافظِ أبي الحجّاج يوسفَ بنِ الزكي عبدِ الرحمن المزي، أخبرنا أبُو العبـاسِ /[57ـ أ ] أحمدُ بنُ أبي الخير سَلَامةَ بنِ إبراهيمَ الحدَّادُ بقراءتي عليه، أخبرنا أبُو المكارمِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ اللَّبَّانِ كتابةً، أخبرنا أبُو عليٍّ الحسنُ بنُ محمدٍ الحدَّادُ سماعاً، أخـبرنا أبُو نُعيمٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبُو سعيدٍ الحسينُ ابنُ محمدِ بنِ عليٍّ، حدثنا أبُو سعيدٍ الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ المُبَاركِ، حدثنا أبُو جعفرٍ أحمدُ بنُ صُليحِ بنِ رَسْلاَنَ([16]) بمكَّةَ:
حدثنا أبُو الفَيْضِ ذو النُّونِ بنُ إبراهيمَ المصريُّ، حدثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ رضي الله عنه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ للهِ عَزَّ وجلَّ أَهْلِين مِنْ خَلْقهِ» قيلَ: مـنْ هُم يا رسولَ اللهِ؟ قال: «أَهلُ القرآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وخَاصَّتهُ». غريبٌ من حديثِ مالكٍ، قالَهُ أبُو نُعيمٍ([17]).
وهو في الثاني من «غرائبِ هَنَّادِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمدٍ النَّسفِيِّ»([18]) قال:
223 ـ أخبرنا أبُو مسلـمٍ غالبُ بنُ عليِّ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ غالبٍ الرَّازِيُّ الصّوفيُّ بِنَيْسابُوْرَ، حدثنا أبُو طالبٍ أحمدُ بنُ الحسنِ الواسطيُّ، حدثنا أبُو سعيدٍ الحسـنُ بنُ أحمدَ التُّسْتَريُّ، حدثنا أحمدُ بنُ صُليحِ بنِ رَسْلانَ الفَيُّوْمِيُّ، حدثنا ذُو النُّوْنِ، فَذكرهُ.
224ـ ورواهُ أبُو أيوبَ سليمانُ بنُ صَلايَة المَلْطِيُّ وهو متّهمٌ([19])، قال: حدثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الوالشْتَان ببغدادَ، قال: حدثنا ذُو النُّوْنِ المصريُّ، فذكرهُ.
225ـ وقال أبُو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الخطيبُ: أخبرنا القاضي أبُو الفَرجِ محمدُ ابنُ أحمدَ بنِ الحسنِ الشافعيُّ، حدثنا عبيدُ الله بنُ عبدِ الرحمن الزُّهريُّ، حدثنا أبُو القاسمِ المَرْوَزِيُّ:
حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ غَزْوانَ، حدثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ رضـي الله عنه قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لله عزَّ وجلَّ أَهْلِين فِي الأرضِ». قيل: من هُم يا رسولَ اللهِ؟ قال: «هُمْ أَهْلُ القرآنِ»([20]).
تفرَّدَ بـهِ ابـنُ غَزْوانَ، وكان كذَّاباً([21])، ولا([22]) يصحُّ عن مالكٍ، ولا عن الزّهريِّ، قالَهُ أبُو الحسنِ الدّارقُطنيُّ([23]). والمعروفُ ما:
226ـ أنبأنَا الحافظُ أبُو بكـرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله المقدسيُّ، أخبرنا أبُو عبد الله محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ غنائم، وأبو العباسِ/[57ـ ب ] أحمدُ بنُ أبي طالبٍ الصَّالحيُّ، وستُّ الفقهاءِ ابنةُ التَّقِي عليِّ بنِ الواسطيِّ قراءةً عليهم وأنا أسمعُ.
قال ابنُ غَنَائِمَ: أخبرنـا أحمـدُ بنُ العـمادِ إبراهيمَ بنِ عـبدِ الواحدِ المقدسيُّ، وأبو بكرٍ محفوظُ بنُ مَعْتُوقٍ البُزُوْرِيُّ قالا: وابنِ أبي طالبٍ وبنتِ الواسطيِّ: أخبرنا عبدُ اللطيف بنُ محمدِ بنِ القُبَّيْطِيِّ.
قال ابنُ العمادِ ومحفوظٌ: سماعاً، والآخران إجازةً، أخبرنا أبُو المظفّرِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ الكَرْخِيُّ قراءةً عليـه ونحـن نسمعُ، أخبرنـا أبُو بكـرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الطُّرَيْثِيْثِيُّ، أخبرنا أبُو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ الحَمَّامِيُّ، أخبرنا أبُو بكرٍ محمدُ بنُ الحسينِ بمكَّةَ، حدثنا أبُو العباسِ حامدُ بنُ شُعيبٍ البَلْخِيُّ، حدثنا يعقوبُ الدَّوْرَقِيُّ: حدثنا عبدُ الرحمن [بنُ]([24]) مَهديٍّ، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيدَ([25])، عن أبيهِ([26])، عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ للهِ عزَّ وجلَّ أَهْلِين». قيل: من هُم يا رسولَ اللهِ؟ قال: «أَهْلُ القرآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وخَاصَّتهُ»([27]).
تابعَهُ أبُو عُبَيدة عبدُ الواحـدِ بنُ واصلٍ الحدَّادُ([28]) قال: حدثنا عبدُ الرحمن ابنُ بُديلٍ، فذكرهُ([29]).
رجالُه ثقاتٌ.
* * *
([1]) قال الخطيب في «تاريخ بغداد»: (8/393): وذو النـون لقب له. قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: (1/124): وقيل: إن اسمه ثوبان، وذو النون لقب له. قال الذهبي في «مـيزان الاعتدال»: (3/53): قلت: اسمـه ثوبان بن إبراهيم، ويقال: الفيض بن أحمد.
([2]) قال ابن النديم في «الفهرست» (ص503): من كتبه: «الركن الأكبر»، و«الثقة في الصنعة».
ينظر ترجمته في: «الفهرست» (ص503)، «طبقات الصوفية»، محمد بن الحسين الأزدي السلمي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط1/ 1998م: (ص27)، «حلية الأولياء»: (9/331 ـ 410)، «تاريخ بغداد»: (8/393 ـ 396)، «الإكمال»: (3/389)، «تاريخ مدينة دمشق»: (17/398 ـ 442)، «المنتظم»: (11/344)، «صفة الصفوة»: (4/315 ـ 321)، «اللباب في تهذيب الأنساب»: (1/35)، «وفيات الأعيان»: (1/315 ـ 318)، «ميزان الاعتدال»: (3/53)، «تاريخ الإسلام»: (18/265)، «سير أعلام النبلاء»: (11/532 ـ 536)، «العبر»: (1/441)، (2/437)، «شـذرات الذهب»: (2/107 ـ 108)، «هدية العارفين»: (5/245)، «الأعلام» للزركلي: (2/102)، «معجم المؤلفين»: (1/707).
([3]) إِخْمِيم: وهو بلد قديـم على شاطىء النيل بالصعيد. وهي مدينة تقع اليوم في مصر على الشاطئ الشرقي للنيل. ينظر: «معجم البلدان» (1/123)، «أطلس تاريخ الإسلام»، خرائط (ص318).
([4]) المتوكل على الله: جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي، أبو الفضل، وأمه تركية واسمها شجاع، بويع له لست بقين من ذي الحجة سنة 232ﻫ، وقتل ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة 247ﻫ، وله إحدى وأربعون سنة. «وفيات الأعيان»: (1/350).
([5]) مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة، بناها المعتصم سنة إحدى وعشرين ومئتين. «معجم البلدان»: (3/173)، «آثار البلاد وأخبار العباد» (ص 157).
([6]) خرَّجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (17/401)، وابن خلكان في «وفيات الأعيان»: (1/316)، واليافعـي في «مرآة الجنان» (2/150)، والسيـوطي في «تاريخ الخلفاء»، السيوطي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط1/1952م: (ص350).
قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (ص 350): وفي كتاب «المحن» للسلمي: أن ذا النون أول من تكلـم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية، فَأَنكر عليه عبدالله بن عبد الحكـم ـ وكان رئيس مصر ومن جلـة أصحـاب الملك ـ وأنه أحدث علماً لم يتكلم فيه السلف ورماه بالزندقة، فدعاه أمـير مصر وسألـه عن اعتقاده، فتكلم، فرفض أمره وكتب به إلى المتوكـل، فأمـر بإحضاره، فحمل على البريد، فلما سمع كلامه أولع به وأحبه وأكرمه حتى كان يقول: إذا ذكر الصالحون فحيَّ هلا بذي النون.
([7]) الجِيزة: بالكسر، والجيزة في لغة العرب الوادي، والجيزة بليدة في غربي فسطاط مصر. «معجم البلدان»: (2/200).
([8]) هكذا وقع بالأصل: إتحاف السالك [56ـ ب]، والصواب: (لليلتين) كما في «تاريخ بغداد»: (8/396)، و«تاريخ دمشق»: (17/441)، و«الأنساب»: (1/97)، و«المنتظم»: (11/345)، و«تاريخ الإسلام»: (18/269)، وغيرها من المصادر الأخرى.
([9]) قاله الخطيب فـي «تاريخ بغداد»: (8/396)، والسمعاني في «الأنساب»: (1/97)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (17/441)، وابن الجوزي في «صفة الصفوة»: (4/321)، وفي «المنتظم»: (11/345)، وياقوت الحموي في «معجم البلدان»: (1/124)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (18/269) كلهم نقله عن حيان بن أحمد السهمي.
([10]) محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي، السلمي، الإمام، الحافظ، المحدث، شيخ خراسان، وكبير الصوفية، أبو عبد الرحمن النيسابوري الصوفي، صاحب التصانيف، ماتالسلمي سنة (412ﻫ). «سير أعلام النبلاء»: (17/247 ـ 252).
([11]) خرَّجه ابـن عساكر في «تاريخ دمشق»: (17/400)، والذهبي في «ميزان الاعتدال»: (3/53)، و«سير أعـلام النبلاء»: (11/533)، و«تاريخ الإسلام»: (18/266)، والسيوطي فـي «حسن المحاضرة» (ص 170)، وابن العماد في «شذرات الذهب»: (2/108).
([12]) «تسمية من روى الموطأ عن مالك» (ق201ـ أ).
قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: (1/315): وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عنه.
([15]) قاله الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (3/53). وينظر: «سير أعلام النبلاء»: (11/534)، «لسان الميزان»: (1/386).
([18]) هناد بن إبراهيم بن محمـد بن نصـر، أبو المظفر النسفي، ونسـف مما وراء النهـر، سكن بغداد وولي قـضاء بعقوبا وغيرها، وكـان قد سمع وأكثـر ورحل وخرج الفوائد، لكن الغالب على روايتـه الغرائـب والمناكـير، علق عنه الخطيب وأشار إلى تضعيفه. قال ابن العـماد في شـذرات الذهـب (3 / 324): توفي سنـة (465ﻫ)، وكـان من المحدثين المكثرين والحفاظ المشهورين، لكنه ضعيف مكثر من رواية الموضوعات. تاريخ الإسلام (31 / 189/190). و ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد (14/97)، المنتظم (16/153)، التدوين في أخـبار قزوين (4/ 195)، تاريـخ الإسلام (31/189/190)، المعجـم المفهرس (ص377)، تاج التراجـم في طبقات الحنفية (ص 314)، شـذرات الذهـب (3 / 324).
([20]) «تاريخ بغداد»: (2/428 ـ 429). وخرَّجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»(2/428 ـ 429)، و الخليلي في «الإرشاد»: (1/169 ـ 406).
([21]) قال ابن حبان في «المجروحين»: (2/305): من أهل بغداد يروي عن أبيه وغيره من الشيوخ العجائب التي لا يشك مَنْ هذا الشأن صِناعته أنها معمولة أو مَقْلوبة. قال الدارقطني كما في «ميزان الاعتدال»: (6/235): كان يضع الحديث.
قال ابن عـدي في «الكامل في الضعفـاء» (6/290): له أحاديث عن ثقات الناس بواطيل.
([23]) خرَّج قول الدارقطني بتمامه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (2/311).
قال أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (9/396): غريب من حديث مالك، تفرد به محمد ابن عبدالرحمن بن غزوان.
وقال الخليلـي في «الإرشاد»: (1/169) بعـد أن خـرَّج الحديث من طريـق محمـد بن عبد الرحمن بن غزوان: هذا مُنكرٌ بهذا الإسناد، ما لهُ أصلٌ من حديث ابن شهاب، ولا منْ حديثِ مالكٍ، والحَمْلُ فيه على ابنِ غَزْوان، وإنما رواهُ أبو داودَ الطيالسي، عن شيخٍ من أهلِ البصرة، عن أبيه، عن أنس.
وقال الخليـلي في «الإرشاد»: (1/406 ـ 407): منكرٌ موضوعٌ من حديثِ مالك، وحديثِ الزهـري، لم يَرْوهِ غيرُ ابنِ غزوانَ، وهو ضعيفٌ، لهُ مثلُ هذا، وغيره، وإنما الحديثُ يُعرفُ مِنْ حَديثِ عبد الله بن بُديلٍ، عن أنس.
([25]) وقع هكذا بالأصل: إتحاف السالك [57 ـ ب]، والصواب: (بُديل) كما ذكر ابن ناصر الدمشقي فيما يأتي من الكلام، وكما هو مذكور في الكتب التي خرَّجت الحديث من هذا الطريق.
وعبد الرحمن بن بديل كما ترجم له المزي في «تهذيب الكمال»: (16/544 ـ 545) قال: عن يحيى بن مَعِين، وأبي داود، والنَّسَائي قالوا: ليس به بأس. وَقَال أبو داود الطيالسي: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن بُديل العقيلي، وكان ثقةً، صدوقاً.
وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات»، روى له النَّسَائي، وابن ماجه حديثاً واحداً.
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ص337): لا بأس به، من الثامنة، روى له النسائي وابن ماجه.
([26]) بُديل بـن ميسرة العقيلي، البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة (125ﻫ) أو (130ﻫ)، روى له مسلم والأربعة. «تقريب التهذيب» (ص120).
([27]) خرَّجه أحمد في «مسنده»: (3/127) برقم (12301)، (3/242) برقم (13566)، وابن ماجه في «سننه»: في كتـاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل من تعلم القرآن وعلمـه (1/78) برقم (215)، والنسائي في «السنن الكبرى»: في كتاب فضائل القرآن، باب: أهل القرآن (5/17) برقم (8031)، والحاكم في «المستدرك» (1/743) برقم (2046)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: (3/63)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: باب في تعظيم القرآن، فصل في تنوير موضع القرآن (2/551) برقم (2688)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن بديل، عن أبيه بديل بن ميسرة العقيلي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
قال الحاكـم في «المستدرك» (1/743): قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها.
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربيـة، بيروت، ط2/ 1403ﻫ: (1/200): هـذا إسنـاد صحيـح، ورجاله موثقون.