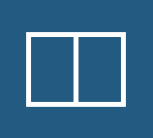أسد بن الفرات بن سنان القروي
أسدُ بنُ الفُرَاتِ بنِ سِنَانٍ القَرَويُّ
ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،
فقال :
[اسمه: ] أسدُ بنُ الفُرَاتِ بنِ سِنَانٍ القَرَويُّ([1])، مولى بني سُلَيمِ بنِ قَيْسٍ، كنيتُه أبو عبد الله، قاضي إفريقيةَ.
[روى عن: ] اختلف إلى عليِّ بنِ زيادٍ التُّونسيِّ بتونسَ، فلَزِمَهُ وتفقَّه بِهِ، ثم رَحلَ إلى المشرقِ، وسمعَ من مالكِ بنِ أنسٍ «موطّأهُ» وغيرَه، ثم رَحلَ إلى العراقِ، فأخذ عن أبي يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ وأبي بكرَ بنِ عيَّاشٍ وغيرِهِم([2]).
قال القاضي عياض: وأخذ عنـه أبو يوسف «موطَّأ مالكٍ»، وذكر يحيى
ابـنُ إسحـاق عنـه أنـه قـال: أَخَذَهُ عنِّي ـ يعني: «الموطَّـأَ» ـ محمدُ بنُ
الحسنِ،
ولا أدري كيف هذا، ومحمدٌ قد سَمِعَ «الموطَّأَ»
من مالكٍ، وسمعَ عليه([3]) كثيراًً([4]). انتهى.
قلت: إنْ صحَّ فلعلّه كان في «موطَّأِ أسدٍ» من الزيادةِ ممَّا ليس في سَمَاعِ محمدِ ابنِ الحسنِ من مالكٍ، فسَمِعَ «الموطَّأَ» من أسدٍعن مالكٍ لما فيه من الزيادة، والله أعلم.
وفي كـلامِ الشيخ أبي إسحاقَ الشّيرازيِّ في «طبقاتِهِ»([5]) رحمة الله عليه
ما يُشعِرُ أنَّ أسـداً فَاتَهُ مالكٌ، ولهذا ذَكرَهُ في أصحابِ أصحابِ
مالكٍ من أهلِ إفريقيةَ.
وعَدَّهُ القاضي عياضٌ وغيرُه من أصحابِ مالكٍ كما تقدَّمَ([6]).
وكذلك ذَكرَهُ أبو محمدٍ هبةُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ الأَكْفانيِّ في «تسميتِه من روى الموطَّأ عن مالكٍ([7])»([8]): كان أَقَامَ بالكوفةِ، وكَتبَ عن أهلِها، وكَتبَ بالرّيِّ عن جريرِ بنِ عبدِ الحميدِ. انتهى.
وقال يحيى بنُ سـلَّامٍ: حدّث أَسَدٌ يوماًًًً بحديثِ الرّؤيا، وسليمانُ الفرَّاءُ المعتزليُّ في مؤخّرِ المسجدِ، فأَنْكرَ، فسَمِعَهُ أَسَدٌ، فقَامَ إليه وجَمعَ بينَ طرفيِهِ ولحيتِهِ واستقبلَهُ بِنعْلهِ حتَّى أَدْمَاهُ وطَرَدهُ /[74ـ أ] من مجلسهِ.
ورُوِيَ([9]): أنَّ أَسَداً كان يُقْرَأُ عليه في «تفسير المُسَيِّبِ بنِ شَرِيْكٍ»([10]): ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾[القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]، وسليمانُ الفرَّاءُ حاضرٌ، فقال سليمانُ: مِنَ الانتظارِ يا أبا عبدِ اللهِ. فَأَخـذَ أَسدٌ بتلبيتِه([11])، ونَعْلاً غليظةً بيدِه الأخرى، وقال: يا زيديُّ([12]) لَتَقولنّهَا ـ يعني: تَنْظُرُ ـ أو لأَبْقَرَنَّ بها عَينَيكَ، فقال سليمانُ: تَنْظُرُ([13]).
[وفاته: ] تُوفِّي أسـدُ بنُ الفُراتِ في حِصارِ سَرَقُسْطَةَ([14]) في غَزوةِ صَقِلِّيَّةَ([15])، وهو أميرُ الجيشِ، وقاضيه مِنْ قِبَلِ زيادةِ اللهِ بنِ إبراهيمَ بنِ الأغلبِ في شهرِ ربيعٍ الآخـرِ سنـةَ ثلاثَ عَشرةَ([16])، وقيل: أربعَ عَشرةَ، وقيل: سنةَ سبعَ عَشرةَ ومائتَينِ بصَقِلِّيَّةَ، وقبرُه بها رحمه الله([17]).
[ولادته: ] وكان مولدُه على قولٍ: في سنةِ خمسٍ وأربعِينَ ومائةٍ بحرَّانَ ([18]).
والمسائل الأَسَديَّةُ([19]) منسوبةٌ إليه.
قال أبو عثمانَ سعيدُ بنُ عمـرِو بنِ عمار البَرْذَعِيُّ في «سؤالاتِـه لأبي زُرْعَةَ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ الكريمِ الرَّازِيِّ»: وذَكَرَتُ لأبي زُرْعَةَ مسائلَ عبدِ الرحمن بن القاسمِ عن مالكٍ، فقال: عندَهُ ثلثمائةِ جِلْدٍ أو نحوُه مسائلَ أسديّةً.
قلت: وما الأَسَدَيَّةُ؟ فقال: كان رجلٌ من أهلِ المغربِ يُقال لَهُ: أَسَدٌ، رَحلَ إلى محمدِ بنِ الحسنِ، فسأله عن هذهِ المسائلِ، ثم قَدِمَ مصرَ، فإذا عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، فَسَأَلَهُ أنْ يسأَلَهُ عن تلكِ المسائلَ. فما كان عندَهُ فيها عن مالكٍ أجابَهُ، وما لم يكن عنده قَاسَ على قول مالكٍ، فَلَمْ يَفْعلْ، فأتى عبدَ الرحمن بنَ القاسمِ، فتوسَّع لَهُ، فأجابَهُ على هذا، فالنَّاسُ يتكلَّمون في هذهِ المسائلِ([20]).
وقال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ([21]): قال لي الشافعيُّ: أشرتُ على بعضِ الولاة أنْ يولي أسدَ بنَ الفراتِ القضاءَ، وقلت: إنه يتخيّر، وهو عالمٌ باختلافِ من مضى([22]).
260 ـ أخبرنا أبو عبدِ الله محمـدُ بنُ المحتسبِ([23]) إجازةً إن لم يكن سماعاً، أخبرتنا فاطمةُ ابنةُ عبدِ الكريمِ إذناً: أنَّ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عُفَيْجَةَ، أخبرها كتابةً /[74ـ ب] عن محمـدِ بنِ عبدِ الملكِ بن خَيْرُونَ([24])، أنبانـا الحافظُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ([25])، أخبرني عبيدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ الصَّيْرَفِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ عمرَ بنِ أحمدَ، حدثنا أحمدُ بنُ الحسينِ بنِ أحمدَ بنِ المؤمَّلِ الدَّقّاقُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سَلَامةَالطَّحَاويُّ، أخبرني محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي ثورٍ يُعرفُ بابنِ عَبْدُونَ قاضي إفريقية قال:
سمعتُ أَسَدَ بنَ الفراتِ يقول: كنتُ أنا وصاحبٌ لي([26]) نَلْزَمُ مالكَ بنَ أنسٍ، فلمّا أردنا الخروجَ إلى العراقِ أتيناه مودِّعَينَ له، فقلنا له: أَوْصِنَا، فالتفتَ إلى صاحبي، فقـال: أوصيك بالقرآن خيراً، والتفتَ إليَّ، فقال: أوصيك بهذه الأُمَّة خيراً. قال أَسَدٌ: فما مات صاحبي حتى أقبل على القرآن والعبادة.
قال: وولي أسدٌالقضاءَ([27]).
* * *
([1]) ينظر في ترجمته: «طبقات الفقهاء» (ص160)، «طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب (ص81 ـ 83)، «رياض النفوس»: (1/254ـ273)، «الإكمال»: (4/454 ـ 455)، «ترتيـب المـدارك»: (1/270 ـ 278)، «المنتظم» (10/252)، «معجم البلدان»: (2/417)، «الحلة السيراء»: (2/380 ـ 381)، (الحلة السيراء، ابن الأبار، تحقيق: الدكتور حسني مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط2/ 1985م)، «وفيات الأعيان»: (3/181 ـ 182)، «البيان المُغرب»: (1/97 ـ 102 ـ 104)، «تاريخ الإسلام»: (15/66 ـ 69)، «العبر»: (1/364)، «سير أعلام النبلاء»: (10/225 ـ 228)، «الإحاطة في أخبار غرناطة»: (1/231)، (الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، لبنان / بيروت، ط1/ 2003م)، «الديباج المذهب» (ص98)، «شذرات الذهب»: (2/28)، «هدية العارفين»: (5/203)، «شجرة النور الزكية»: (ص62)، «الأعلام»: (1/198).
([5]) «طبقات الفقهاء» (ص160). قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (1/272): لم يذكر أبو إسحاق أسداً فيمن أخذ عن مالك، ولا أن له عنه سماعاً، وإنما ذكره في أتباع أصحابه، وأرى أنه لم يبلغـه ذلك، وإلا فأخذه عنه صحيح مشهور، قال ابن الحارث: فقال أسد عن ذلـك: إن كان فاتني لزوم مالك فلا يفوتني لزوم أصحابه، والله تعالى أعلم.
([7]) قال محمد مصطفى الأعظمي في مقدمة تحقيقه «للموطأ» برواية يحيى الليثي (1/195): ولم أجـد ذِكْرهُ في نسخةٍ من كتاب الأكفاني، إلا أنه ذكر إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم، وهو غير أسد بن الفرات.
قلت: ذكره في رواة «الموطأ» عن مالك القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (1/108)، والسيوطي في «تنوير الحوالك» (1/10).
([8]) زاد في النسخة ب من إتحاف السالك [8ـ ب]: وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخه»: وكان عنده «الموطأ» عن مالك، كان أقام بالكوفة... إلخ.
([10]) المسيب بن شريك، ويكنى أبا سعيد، ولد بخراسان ونشأ بالكوفة وسمع الحديث من الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم، وكان ضعيفاً في الحديث لا يحتج به، ثم قدم بغداد فنزلها، وولي بيت المال لهارون أمير المؤمنين، وتوفي ببغداد سنة (186ﻫ). «طبقات ابن سعد»: (7/332). قلت: وله تفسير: اسمه «تفسير المسيب بن سعيد» نسبه له حاجي خليفة في «كشف الظنون» (1/458) قال: «تفسير المسيب بن شريك» ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان». قلت: كان أسد بن الفرات محدثاً يحدث الناس، وكان كذلك مفسراً لكتاب الله، فيقرأ عليهم من هذا التفسير.
([14]) سَرَقُسْطَة: بلدة مشهورة بالأندلس، ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الأندلس، مبنية على نهر كبير. اشتهرت زاراغوسا باسم سرقسطة أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا. تقـع على نهـر إبرو. «معجم البلـدان»: (3/212)، «الموسوعة التاريخية الجغرافية»: (1/305).
([15]) صِقِلِّيَّةُ: بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضاً مشددة، وبعض يقول بالسين، وأكثر أهل صِقِلّيّة يفتحـون الصاد واللام: من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية، وهي مثلثة الشكل بين كل زاوية والأخرى مسيرة سبعة أيام.
قلت: جزيرة إيطالية تقع في جنوبها، ومن أكبر جزر البحر المتوسط. «معجم البلدان»: (3/416)، «أطلس التاريخ العربي والإسلامي» (ص4).
([16]) قاله أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» (1/255) وفيه: ولاه زيادة الله بن إبراهيم=
= ابـن الأغلب قضاء إفريقية سنـة ثلاث ومئتين، فأقام قاضياً عليها يقضي بين أهلها بالكتاب والسنة، حتى خرج لغزو صقلية، فجاهد بها الروم وقاتلهم قتالاً عظيماً، وكانتله بها آثار مشهورة ومقامات مذكورة، وافتتح منها مواضع كثيرة، ثم توفي رحمه الله من جراحات أصابته وهو محاصر لسرقوسة في شهر ربيـع الآخر سنة ثلاث عشرة ومئتين، ودفن في ذلك الموضع.
([18]) «ترتيب المدارك» (1/278).
ونقل أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» (1/254) عن سليمان بن عمران: أنه ولد سنة (142ﻫ).
([20]) «سؤالات البرذعي» (ص533 ـ 534). وينظر «رياض النفوس» (1/256 ـ 257).
وهذه المسائل تكلم عليها عبد الرحمن بن القاسم، قال أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (ص160): ثم ارتحل سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم، فعرضها عليه، فقال ابن القاسم: فيها شيء لا بد من تغييره، وأجاب عما كان شك فيه، واستدرك منها أشياء، وكتب إلى أسد أَنْ عارِضْ كتبك بكتب سحنون، فلم يفعل أسد ذلك، فبلغ ابن القاسم فقال: اللهم لا تبارك في الأسدية، فهي مرفوضة عندهم إلى اليوم.
وقال أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» (1/263): كتب عبد الرحمن كتاباً إلى أسد يأمره فيه أن يرد «مدونتـه» على «مدونة سحنون» فلما قدم سحنون بالكتاب دفعه إلى أسد، فلما قرأه أراد أن يفعـل مـا أمره به مـن ذلك، فشاور في ذلك جماعة من تلامذته فقالوا له: لا تفعل، فإنك تتضع عند الناس إن رددت كتبك على كتب سحنون ويسود بذلـك عليـك وترجـع لـه تلميذاً، وأنت قـد أدركت مالكاً وأخذت عنه، ثم دخلتَ الكوفـة وأخذت عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فاترك هذا واحمل عن هؤلاء، فقبل منهـم كلامهـم وفعـل مـا قالوا له، ولم يقبل كتاب ابن القاسم في ذلك، وتمسك بكتابه«الأسدية» ونَشْرِ مذاهب أهل العراق، وتمسك سحنون «بمدونته» التي قدم بها، ونشرها وسمعها عليه أهل المغرب، وانتشر ذكرها في الآفاق، وعول الناس عليها وأعرضوا عن«الأسدية» وغلب عليها اسم سحنون.
والمشهور عن أسـد رحمه الله تعالى أنه كان يلتزم من أقوال أهل المدينة وأهل العراق ما وافق الحق عنده، ويحق له لاستبحاره في العلوم وبحثه عنها وكثرة من لقي من العلماء والمحدثين.
وكـان أسد بعد وصول كتاب ابن القاسم إليه، إذا ذُكِرَ عنده ابـن القاسـم، مشـرفـاً له ومعظماً.
([21]) محمد بن عبد الله بن عبـد الحكم بـن أعين بن ليث الإمـام، أبو عبد الله المصري، أخـو عبد الرحمن وسعد، ولد سنة (182ﻫ)، ولازم الشافعي رضي الله عنه مدة، وقيل: إن الشافعي كان معجباً به لفرط ذكائه وحرصه على الفقه، وقال النسائي: ثقة، وقال أبو بكرابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبـد الله بـن عبـد الحكـم. توفي سنة (268ﻫ). «طبقـات الشافعية الكبرى» للسبكي: (2/67 ـ 69).
([22]) لم أقف على قول ابن عبد الحكم، وقد أشار القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (1/276) إلى توليه القضاء، فقال: ولَّى زيادة الله ـ هو ابن إبراهيم بن الأغلب (ت 304ﻫ) ـ أسداً القضاء شريكـاً لأبي محـرز الكناني، سنة ثلاث، أو أربع ومئتين، فاشتركا في القضاء، وكان ما بينهما غير جميل، فكان أسد أغزرهما علماً وفقهاً، وأبو محرز أسدهما رأياً، وأكثرهماصواباً، قام قاضياً إلى أن خرج إلى صقلية، سنة اثنتي عشرة والياً على جيشها.
([27]) خرجه الخطيب البغدادي فيما نقله عنه الرشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص24).
وينظر: «رياض النفوس»: (1/257)، «ترتيب المدارك»: (1/126).
قال أبو بكـر المالكي في «رياض النفوس» (1/255 ـ 256): ومن بعض ما أسند عنه من الحديث: عنه ـ أي أسد بن الفرات ـ عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكلّ عبدٍ لا يشرك بالله شيئًا إلّا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتّى يصطلحا، أنظروا هذين حتّى يصطلحا».