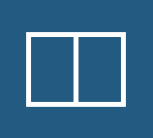الوليد بن مسلم بن السائب القرشي
الولِيدُ بنُ مُسلمِ بنِ السَّائبِ القُرشيُّ
ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439هـ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم،
فقال :
[اسمه: ] الولِيدُ [بنُ مُسلمِ]([1]) بنِ السَّائبِ القُرشيُّ([2])مولاهُم، أبو العبَّاسِ، الدِّمشقيُّ، مولى بني أُمَيَّةَ([3])، وقيل: مولى العبَّاسِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ الهاشميِّ([4]).
أحدُ الأعلامِ المشْهُورينَ والثِّقاتِ المُكْثرينَ([5]).
حدَّث عن: يحيى بنِ الحارثِ الذِّمَارِيِّ([6])، وثَوْرِ بنِ يزيدَ، ومالكٍ، وابنِ جُرَيْجٍ، والأَوزاعِيِّ([7])، وكان مختصًّا بهِ([8]).
وحدَّث أيضاً: عن اللَّيْثِ بنِ سعدٍ، والسفيانَينِ، وخلْقٍ([9]).
روى عَنهُ: منَ الكبارِ: اللَّيثُ بنُ سعدٍ.
وروى عنهُ: أحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ بنُ رَاهَويْه، وابنُ المَدِيْنِيِّ، وهشامُ بنُ عَمَّارٍ، وصَفْوانُ بنُ صالحٍ، وآخرُون([10]).
قال إبراهيمُ بنُ المنذرِ: قدمتُ البَصرةَ، فجاءنِي عليُّ بنُ المَدِيْنِيِّ، فقال: أوَّلُ شيءٍ أطلبُ أخرج إِليَّ حديثَ الولِيدِ بنِ مُسلِمٍ.
فقلتُ: يا ابنَ أُمِّ! سبحـانَ اللهِ! وأينَ سـمَاعِي من سـماعِكَ؟ فجعلتُ آبى، ويُلِحُّ، فقلتُ: أخبرني إلحاحـكَ هذا ما هو؟ قال: أخبرك: إنَّ الوليدَ رجلُ الشَّامِ [29ـ أ]، وعندَهُ علمٌ كثيرٌ، ولم أسْتمكِنْ منهُ، وقد حدَّثَكُم بالمدينةِ في المواسمِ، وتقعُ عندَكُم الفوائدُ؛ لأنَّ الحُجَّـاجَ يجتمعُونَ بالمدينةِ من آفَاقٍ شتّى، فيكونُ معَ هذا بعضُ فوائدهِ، ومعَ هذا بَعْضٌ.
قال: فأخرجتُ إليـه، فتعجَّبَ من فوائدهِ، وجعـلَ يقول: كان يكتُبُ على الوجهِ. انتهى([11]).
وأثْنى عليـه أبو مُسْهـرٍ الدِّمشقيُّ، وأحمـدُ بنُ حنبلٍ، وأبـو حاتمٍ الرَّازِيُّ، ويعقوبُ بنُ سفيانَ، ومحمدُ بنُ سعدٍ، وغيرهُم([12]). لازمَ مالكاً، فأخذَ عنه «الموطَّأ» وحديثاً كثيراً، والمسائلَ([13]).
[ولادته: ] ولد سنةَ تسعَ عشرةَ ومائةٍ([14]).
[وفاته: ] وتوفي منصرفه من الحجِّ في الطريقِ بذي المَرْوةِ سنةَ خمسٍ وتسعِينَ ومائةٍ في قول أبي داود([15])، والتِّرمذيِّ([16]).
وقال صفوانُ بنُ صالحٍ: توفي سنةَ أربعٍ وتسعينَ رحمةُ الله عليه([17]).
138 ـ أخبرنا أبو هريرة عبدُ الرحمن بنُ الحافظِ أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ الذَّهبيِّ، أخبرنا أبو الطَّاهـرِ إسماعيلُ بنُ عبـدِ الرحمن بنِ المُنَادِي، أخبرنا محمدُ بنُ السِّنْدِيِّ أبي لُقْمَةَ الصَّفَّارُ، أخبرنا الخَضِرُ بنُ الحسينِ بنِ عبدَانَ الأزْدِيُّ، أخبرنا أبو القاسم عليُّ بنُ محمدٍ المَصِّيْصِيُّ الفَقِيهُ، أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلَامِ، أخبرنا محمدُ بنُ سليمانَ،أخبرنا عليُّ بنُ الحسينِ الجُهَنِيُّ، حدثنا هشامُ بنُ خالدٍ:
حدثنا الولِيدُ بنُ مُسْلمٍ، عن مالك، عن زيد بنِ أَسْلمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَسْلمَ، وحَسُنَ إسْلَامُهُ، كَتبَ اللهُ له ما ازْدلفَ منَ الحسناتِ، ومَحَـا عنـه ما ازْدلفَ منَ السَّيِّئاتِ، وما عملَ من حسنةٍ كان له بهَا عَشْرُ حسنَاتٍ إِلى سَبْعمائَةٍ، وما عملَ من سَيِّئَةٍ، كُتبَتْعليهِ سَيِّئةٌ، إلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللهُ عَنهُ»([18]).
139 ـ تابعـهُ إبراهيمُ بـنُ المختارِ الرَّازِيُّ، وإسحـاقُ بـنُ محمـدٍ الفَرْوِيُّ، وإسماعيلُ بنُ أبي أُويْسٍ([19])، وطَلْحَـةُ بنُ يحيـى بنِ النُّعْمَانِ بـنِ أبي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ، وعبدُ اللهِ([20]) بنُ نافعٍ الصَّائِغُ، وعبدُ اللهِ بنُ وهْبٍ([21])، وعبدُ العزيزِ بنُ يحيى المَدَنِيُّ([22]) /[29ـ ب]، وغيرُهم([23])، عن مالكٍ([24]).
140 ـ وعنه: علَّقَهُ البخاريُّ في «صحيحه» لكنَّهُ باختصارٍ، فقال:
وقال مالكٌ: أخبرني زيدُ بنُ أَسْلمَ: أنَّ عطاءَ بنَ يَسارٍ أخْبرهُ: أنَّ أبا سعيد الخُدْريَّ رضي الله عنه أخْبرهُ: أنَّه سَمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أَسْلمَ العبدُ فَحَسُنَ إِسْلامهُ، يُكفِّرُ اللهُ عنه كُلَّ سَيِّئةٍ كان زَلفهَا، وكان بَعْدَ ذلك القِصَاصُ، الحَسنـةُ بِعشْرِ أَمْثالِـها إلى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ، والسَّيِّئةُ بمثْلهَا إلَّا أَنْ يَتجاوزَ اللهُ عنها»([25]).
لم يذكُر في روايةِ البخاريِّ: «كَتبَ اللهُ له ما ازْدلفَ منَ الحَسناتِ».
وهذا ثابتٌ بنحوهِ في روايةِ من ذَكرنَاهُ ممَّن رواهُ عن مالكٍ([26])، فقال بعضُهم: إنَّما أَسْقطَ البخاريُّ ـ يعني: هذا والله أعلمُ ـ لأنَّ مذهبَهُ: أنَّ ما عملَ الكافرُ من خيرٍ إنَّما هو عنوانٌ، لا أنَّه يُكتَبُ لهُ([27]).
وهي مسألةُ خلافٍ بين المُتكلِّمِينَ([28]).
حكاهُ الإمامُ الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ العَظيمِ بنُ عبدِ القوِيِّ المنذرِيُّ([29]). ([30])
وقال أبو بكـرٍ أحمـدُ بنُ عمـرو بنِ عبدِ الخَالقِ البَزَّارُ([31])، بعدَ أنْ خرَّجَ الحديث كاملاً في «مسنده»: عن عبدِ اللهِ بنِ شبيْبٍ، عن إسحاقَ بنِ محمدٍ الفَرْوِيِّ،عن مالكٍ بهِ، قال: هذا الحديث لا نعْلَمُ رواهُ عن زيد
ابنِ أَسْلمَ، عن عطاءٍ، عن أبي سعيد، إلَّا مالك([32]). انتهى.
وقد تابعهُ سفيانُ بنُ عُيينةَ، لكن حديثهُ مرسلٌ.
141 ـ أخبرناهُ أبو هريرة عبدُ الرحمن بنُ الذَّهَبيِّ، أخبرناهُ يحيى بنُ سعدٍ سماعاً، وأبو الفضلِ سليمانُ بنُ حمزةَ إجازةً، قالا: أنبأنا الحسنُ بنُ يحيى بنِ صَبَّاحٍ، زَادَ أبو الفضلِ، فقال: وأنبأنا محمدُ بنُ عمادٍ الحرَّانيُّ، قالا: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ رِفاعةَ قراءةً عليه ونحنُ نَسمعُ، أخبرنا عليُّ بنُ الحسنِ الشَّافعيُّ في سنة تسعينَ وأربعمائةٍ، أخبرنـا أبو محمد عبدُ الرحمن بنُ عمـرَ بنِ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ النَّحَّاسِ، أخبرنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمـدِ بنِ زيادِ بنِ بشْرٍ الأعرابيُّ بمكَّةَ، حدثنـا سعدانُ بنُ نَصْرِ بنِ منصُورٍ المخْرَمِيُّ:
حدثنـا سفيانُ /[30 ـ أ] ابنُ عُيينةَ، عن زيدِ بنِ أَسْلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، يُخبِرُ عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أَسْلـمَ العبدُ فحَسُنَ إسْلَامهُ، تَقبَّلَ اللهُ مِنهُ كُلَّ حسنَةٍ زَلَفهَا، وكَفَّرَ عنـهُ كلَّ سَيِّئةٍ زَلَفهَا، وكانَ في الإسْلامِ ما كانَ الحسنةُ بعشْرِ أمْثالـِهَا إلى سبْعمائَةٍ، والسَّيِّئةُ بمثْلهَا، أوْ يمْحُوهَا اللهُ عَزَّ وجَلَّ».
خرَّجَهُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسينِ البيهقيُّ في كتابهِ «شُعبُ الإيمانِ»، من طريقِ إسماعيلَ بنِ محمدٍ الصَّفَّارِ، عن سعدانَ بنِ نَصرٍ به مرسلاً([33]).
تابعهُ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الشافعيُّ وغيره عن سفيانَ كذلك([34]).
وقد خالفَ أصحابَ مالكٍ: مَعْن بن عيسى القَزَّاز، فرواهُ عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أَسْلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والصَّحيحُ الأوّلُ([35])، والله أعلمُ.
* * *
([1]) في المصادر: بن مسلم، فالسائب هو جد الوليد وليس أباه. ينظر: «الطبقات الكبرى»: (7/470)، «التاريخ الكبير»: (8/152)، «الجرح والتعديل»: (9/16).
([2]) ينظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى»: (7/470)، «التاريخ الكبير»: (8/152)«الجرح والتعديل»: (9/16)، «معرفة الثقات»: (2/342)، «الثقات»: (9/222)، «التعديل والتجريح»: (3/1189)، «ترتيب المدارك»: (1/240)، «تاريخ دمشق»: (63/274 ـ 295)، «تهذيب الكـمال»: (31/86 ـ 99)، «ميـزان الاعتدال»: (7/141 ـ 143)، «تهذيب التهذيب»: (11/133 ـ 135)، «تقريب التهذيب»: (ص584).
([3]) قال ابن سعد في «الطبقات» (7/470): قال سعيد بن مسلمة بن عبد الملك: جاءني الوليد بن مسلم فأقر لي بالرق، فأعتقته.
([4]) قال ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»: (63/283): حدثنا ابن أبي السري قال: سألت الوليد بن مسلم عن ولائه، فقال: ولاؤنا للعباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسبن عبد المطلب.
([5]) قال أحمد كما في «تهذيب الكمال»: (31/92): ليس أحد أروى لحديث الشاميين منه ومن إسماعيل بن عياش. وقال العجلي في «معرفة الثقات»: (2/342): ثقة. وقال ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: (9/16): صالح الحديث. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ص584): ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.
([8]) قال ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (63/287): قال مروان بن محمد: كان الوليد ابن مسلم عالماً بحديث الأوزاعي.
قلت: لكنه كان يدلس في حديثه عن الأوزاعي تدليس التسوية.
قال الدارقطني كما في «الضعفاء والمتروكين» (3/187)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (63/292): الوليـد يروي عن الأوزاعي أحاديث، هي عند الأوزاعي عن ضعفاء، عن شيوخ أدركهم الأوزاعيّ، كنافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء مثل: عبد الله بن عامر الأسلمي، وإسماعيل بن مسلم.
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (7/142): إمام مشهور، صدوق، لا نزاع في حفظه، لكنه يدلس عن ضعفـاء، لا سيما عن الأوزاعي. فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن، فإذا صرح بالسماع، فقال: حدثنا، فهو حجة.
([11]) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (2/246) قال: سمعت إبراهيم بن المنذر قال: قدمت البصرة... فذكره.
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (63/286) بسنده إلى إبراهيم بن المنذر قال: قدمت البصرة... فذكره
وخرجه المزي فـي «تهذيب الكمال»: (7/487)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (9/214)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (11/134) جميعاً من طريق إبراهيم بن المنذر به.
([13]) قاله القاضي عياض فر «ترتيب المدارك»: (1/240).
وذكره في رواة الموطأ عن مالـك ابن الأكفـاني في تسميـة مـن روى الموطـأ عن مالك (ق 201 ـ أ).
([16]) نقـل قول الترمـذي: ابن طاهـر المقدسي في كتابه «الجمع بين رجال الصحيحين»: (2/537). (الجمع بين رجال البخاري ومسلم، ابن القيسـراني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2/ 1405ﻫ).
ووافق الترمذي وأبا داود جماعة من العلماء، مثل البخاري، وابن خيثمة، وابن وضاح، وهشـام بـن عـمار، ودحيم. ينظـر: «التاريخ الكبير»: (8/152)، «ترتيـب المدارك»: (1/240)، «تاريخ دمشق»: (63/293 ـ 294).
([17]) خرَّج قول صفوان بن صالح: ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (63/283)، وقاله أيضاً ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (7/470)، ونقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك»:(1/240) عن ابن شعبان.
فالحاصل والله أعلم أن وفاته رحمه الله كانت نهاية سنة (194ﻫ)، وبداية سنة (195ﻫ).
وقال ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»: (63/294): وله ثلاث وسبعون سنة.
([18]) خرَّج الحديث النسائـي في «السنن الصغرى»: كتاب: الإيمان، باب: حسن إسلام المرء (8/105) برقم (4998) من طريق الوليد بن مسلم عن مالك به.
([19]) أخرج الحديث البيهقي في «شعـب الإيمان»، باب: الدليل على أن الإيمان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين واحد (1/126) برقم (25) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به.
([20]) لفظ الجلالة سقط في المخطوط، والصواب إثباته. وعبد الله هو: ابن نافع الصائغ المخزومي، مولاهـم، أبو محمد المدني، ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين، من كبار العاشرة، مات سنة (206ﻫ). «تقريب التهذيب»: (ص326).
([21]) أخرج الحديث ابن منده في كتابه «الإيمان»، باب: ذكر ما يدل على درجات المرء المسلم المحسن (1/490) برقم (374) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به.
([22]) خرج أغلب هذه المتابعات الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «تغليق التعليق»: (2/45 ـ 47)، وخرج الباقي ابن حجر في «تغليق التعليق»: (2/45 ـ 47).
([23]) منهم: زين بن شعيب، وسعيد بن داود الزنبري عند الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «تغليق التعليق على صحيح البخاري»، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت /دار عمار، عمان، ط1/ 1405ﻫ: (2/47).
ومنهم: عبد الله بن بكير عند ابن حجر في «تغليق التعليق»: (2/45).
([24]) قال الدارقطني: اتفق هؤلاء التسعة فرووه عن مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد.
وقال الدارقطني كما في «تغليق التعليق»: (2/47): هذا الحديث ثابت من حديث مالك.
قال ابن حجر في «تغليق التعليق»: (2/48): اتفق هؤلاء وهم عشرةٌ على هذا الإسناد.
([25]) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب: الإيمان، باب: حسن إسلام المرء: (1/24) برقم (41).
قال ابن حجر في «الفتح»: (1/98 ـ 99): هكذا ذكره معلقاً، ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح.... عن الوليد بن مسلم، عن مالك به.
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم: حدثنا مالك، فذكره.
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعـيلي من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في «الشعب» من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك.
وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك.
([26]) قال ابن بطال في «شـرح صحيح البخاري»: (1/99): ذكره الدارقطني في «غريب حديث مالك»، ورواه عنـه من تسعة طرق، وثبت فيها كلها ما أسقطه البخاري: أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك، ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لأحد عليه.
قال ابن حجـر في «فتح الباري»: (1/99): وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري، وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام.
([27]) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (1/99): قيل: إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمداً، لأنه مشكل على القواعد. وقال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منـه في شركـه، لأن من شرط المُتَقربِ أن يكون عارفاً لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك.
والذي أراه: أن الإمـام ابن حجر عندما أورد كلام المازري أشار بذلك لمذهب الإمام البخاري رحمه الله، و هو أن الكافر إذا أسلم لا يكتب له شيء من أعماله السابقة، وهذا محل خلاف بين العلماء سيأتي تفصيله فيما يأتي من الكلام إن شاء الله.
([28]) اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: أن الكافر إذا عمل حسنة حال كفره ثم أسلم، فإنه يثاب عليها، ويكون إسلامه المتأخر كافياً له في حصول الثواب على حسناته السابقة منه قبل إسلامه، بشرط أن يَحْسُنَ إسلامه، ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه، قال بذلك جماعة من العلماء كإبراهيم الحربي وابن بطال والقرطبي وابن المنير والنووي وغيرهم كما في «شرح صحيح مسلم»: (2/140 ـ 141)، و«فتح الباري»: (1/99)، واستدلوا بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: ما ورد في «صحيح مسلم» في كتاب: الإيمان، باب: هل يُواخذُ بأعمال الجاهلية؟(1/111) برقم (120) عن ابـن مسعـود قال: قال أُناسٌ لرسُول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: أَنُؤَاخَذُ بما عَمِلنَا في الجاهليَّة؟ قال: «أمَّا من أَحْسَنَ مِنكُم في الإِسلام فلا يُؤَاخذ بها، ومن أَساء أُخِذ بعملِهِ في الجاهليَّة وَالإِسلام».
الدليل الثاني: ما خرجه النسائي في «السنن الصغرى»: كتاب: الإيمان، باب: حسن إسلام المرء (8/105) برقم (4998) من حديث مالك الذي علقه البخاري هنا، وزاد في أوله: «كتب الله كل حسنة كان أزلفها».
الدليل الثالث: ما أخرجه مسلم في «صحيحه»: في كتاب: الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (1/114) برقم (123) عن حكيم بن حِزَامٍ أَنَّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ أُموراً كنت أَتَحَنَّثُ بها في الجاهلية من صَدقةٍ أو عَتَاقَةٍ أو صِلة رَحِمٍ أفيها أجرٌ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خَيْرٍ».
القول الثاني: الأعمال في حال الكفر حابطةٌ لا ثواب لها بكل حال، وهذا قول أبي عبد الله المازري، وتبعه القاضي عياض على ذلك، وهو رأي طوائف من المتكلمين وغيرهم كما في «شرح صحيح مسلم»: (2/140 ـ 141)، وأولوا حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خيرٍ» من وجوه كما في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»، القاضي عياض اليحصبي، تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، ط1/1998م: (1/415/416) قال: الأول: أنَّك اكتسبت طباعـاً جميلة، وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونةً على فعل الخير والطاعات.
والثاني: أنك اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً، فهو باق عليك في الإسلام.
والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة، وقد قالوا في الكافر: إنه إذا كان يفعل الخير فانه يُخفَّف عنه به، فلا يبعد أن يُزاد هذا في الأجور.
والرابع: وقيل: معناه: ببركة ما سبق لك من الخير هداك الله تعالى إلى الإسلام، أي: سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله في جاهليتك وعلى خاتمة الإسلام لك، وأنَّ من ظهر منه خير في مبتدئه فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته.
قال ابن حجر في «فتح الباري»: (1/99): واستضعف ذلـك النووي، فقال: الصواب الـذي عليـه المحققون، ـ بل نقل بعضهم فيه الإجماع ـ: أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلةً كالصدقة وصلة الرحـم، ثم أسلـم ومات على الإسلام: أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى: أنه مخالف للقواعد، فغير مُسلَّمٍ، لأنه قد يُعتدُّ ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه.
قال ابن المنـير كما في «فتح الباري»: (1/100): المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حـال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيراً فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط.
قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»: (1/99): لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه.
قال ابن حجر في «فتح الباري»: (5/169): الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم، لما حصل له من التدرب على فعل الخير، فلم يحتج إلى مجاهدة جديدة، فيثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه.
والذي أراه: أن الراجـح والله أعلم هو رأي الفريق الأول، وهـو أن الله سبحانه وتعالى يكتب للكافـر ثواب أعمالـه الصالحة إذا أسلـم وحسن إسلامـه، لقوة الأدلة المذكورة ودلالتها الصريحة على هذا المعنى، ولأن هذا يتناسب مع فضل الله وكرمه، فإن من أَجَلِّ صفاته العفو والصفح.
ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطـال: (1/99)، «المفهم»: (1/332)، «إكمالالمعلم»: (1/114 ـ 116)، «شرح صحيح مسلم»: (2/140 ـ 141)، «فتح الباري»: (1/134) (5/212)، «عمدة القاري»: (1/253).
وفي الحديث جملة من الفوائد العقدية كما في «عمدة القاري»: (1/253) قال:
منها: أن فيه الحجة على الخوارج وغيرهم من الذين يكفرون بالذنوب ويوجبون خلود المذنبين في النار.
ومنها: أن قوله: «إلاّ أن يتجاوز الله عنها» دليل لمذهب أهـل السنة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله تجاوز عنه، وإن شاء أخذه.
ومنها: أن فيه دليلاً لهم في أن أصحاب المعاصي لا يقطع عليهم بالنار، خلافاً للمعتزلة، فإنهم قطعوا بعقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة.
ومنها: ما قـال بعضهم: أول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان، لأن الحسن تتفاوت درجاته.
([29]) عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة، أ بو محمد المنذري، الشامي، ثم المصري، الشافعي، صاحب التصانيف، ولي مشيخـة دار الحديث الكامليـة، وانقطع بها عشرين سنة، كان عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه، عالماً بصحيحه وسقيمه، إماماً، حجـة، ثبتاً. من مؤلفاتـه: «الترغيب والترهيب» في مجلدين، و«مختصر صحيح مسلم» وغيرها. توفي سنة (656ﻫ). ينظر: «تذكرة الحفاظ»: (4/1436 ـ 1438)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: (8/259 ـ 261)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (2/111 ـ 113).
([30]) إن ما نقله الإمام المنذري حكاية عن الإمام البخاري هو مذهب المازري والقاضي عياض كما مر، وبعد البحث لم أوفّق في الوقوف على قول الإمام المنذري، وإنما من وافق الإمام البخاري في قوله هذا.
ينظر: «شرح صحيـح البخاري» لابن بطال: (1/99)، «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، القرطبي، تحقيق محي الدين مستو، دار ابن كثير، دمشق/ دار الكلم الطيب، بيروت، ط1/1996م: (1/332)، «إكمال المعلم»: (1/114 ـ 116)، «شرح صحيح مسلم»: (2/140 ـ 141)، «فتح الباري»: (1/134) (5/212)، «عمدة القاري»: (1/253).
([31]) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصري، البزار، أبو بكر، صاحب «المسند الكبير»، الذي تكلم على أسانيده. صدوق، ارتحل في آخر عمره إلى أصبهان وإلى الشام والنواحي ينشرعلمه، مات سنة (292ﻫ).
قال الدارقطني: ثقة يخطئ ويتّكـل على حفظه. قال أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن. ينظر: «سير أعلام النبلاء»: (13/554 ـ 557)، «تاريخ الإسلام»: (22/58 ـ 59).
([33]) أخرجـه البيهقي في كتابه «شعب الإيمان»، باب: الدليل على أن الإيمان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين واحد: (1/59) برقم (25).