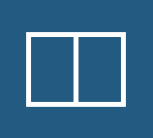محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بـن المطلب بن عبـد مناف بن قصي القرشي المطلبي
محمدُ بنُ إِدريسَ بنِ العبّاسِ بنِ عثمانَ بنِ شَافعِ بنِ السَّائبِ بنِ عبيدِ بنِ عبدِ يَزيد بنِ هَاشمِ بنِ المُطَّلبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصَيِّ القُرشيُّ المُطَّلبيُّ
ترجم له الإمام ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك والذي صدر عن دار المقتبس في طبعته الأولى سنة 1439ﻫ - 2018م بتحقيق الدكتور إبراهيم حمود إبراهيم، فقال :
[اسمه:] محمدُ بنُ إِدريسَ([1]) بنِ العبّاسِ بنِ عثمانَ بنِ شَافعِ بنِ السَّائبِ بنِ عبيدِ بنِ عبدِ يَزيد بنِ هَاشمِ بنِ المُطَّلبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصَيِّ القُرشيُّ المُطَّلبيُّ، الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الشَّافعيُّ، المَكِّيُّ، نَزيلُ مصرَ([2]).
وجَدُّهُ: شَافِعٌ الَّذي يُنسبُ إليهِ: له رُؤيةٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ذكرهُ عِدَّةٌ في الصَّحابةِ([3]).
وأبوه: السَّائبُ أُسرَ يوم بَدرٍ، ففَدى نفسَهُ، ثم أسْلمَ، فقيل له: لِمَ لَمْ تُسْلِمْ قبلَ أَنْ تَفتَدي؟ فقال: ما كنت أحْرِمُ([4]) المؤمنينَ طُعْماً لَهُم([5]).
وهو أحدُ الَّذين كانوا يُشَبَّهُونَ بالنّبيِّ صلى الله عليه وسلم([6]) صُورةً وخَلْقاً([7]).
[أمه: ] وأُمُّ الشَّافِعيِّفي قولٍ غريبٍ: فاطمةُ بنتُ عبدِ اللهِ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ ابنِ أبي طالبٍ([8]).
والمشهورُ وعليه الجمهورُ: أنَّ أُمَّه إمرأةٌ من الأزْدِ([9])ولدتهُ بغزَّةَ، وقيل: بعَسْقلانَ، وقيل: باليمنِ، وقيل: بخَيْفِ مِنى من مكَّةَ، والأَوّلُ المشهورُ([10]).
قال أبو بكرٍ البَيهقِيُّ: الرِّوايَةُ في ولادتِهِ بغَزَّةَ أَصحُّ، وهي من الأرضِ المُقدَّسةِ، ويُحتمَلُ أَنْ يكون قَوله: «وُلِدتُ باليمنِ» أرادَ به بأرضٍ تسْتولي عليها بُطُون اليمنِ([11]).
قالهُ في كتابهِ «المَدْخَل»([12]).
[مولده: ] كان مولدُ الشَّافعيِّ سنةَ خمسينَ ومائةٍ([13]).
ورُوِيَ: أنَّ أمَّهُ لمَّا ولدتهُ رأتْ كأنَّ النَّجْمَ الَّذي يقال له: المُشْترِي قد خرجَ من فرجهَا، حتَّى انْقضَّ بمصرَ، ثمَّ في كُلِّ بلدٍ منه شظِيَّةٌ([14]). نشأَ الشَّافعيُّ بمكّةَ، وأقبلَ على العلمِ وطلبهِ إلى أنْ صارَ إلى ما صارَ إليهِ من الإمامةِ والقدوةِ والتَّقدُّمِ في العلومِ.
125- أنبأنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ الصَّائغِ وغيرُه، عن أبي العباس أحمدَ بنِ محمدٍ الدَّشْتِيِّ، أنَّ يوسفَ بنَ خليلٍ الحافظَ أخبرهُ سماعاً، أخبرنا خليلُ بنُ بَدْرٍ، أخبرنا الحسنُ بنُ أحمدَ الحَدَّادُ / [25 أ]، أخبرنا أبو نُعَيْمٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ، أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ، حدثنا يونسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داود([15])، حدثنا جعفرُ ابنُ سليمانَ، عن النَّضْرِ بنِ مَعْبَدٍ الكِنْدِيِّ أو العَبْدِيِّ: عن الجارُوْدِ، عن أبي الأحْوصِ، عن عبدِ اللهِ رضي الله عنه([16])، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُّوا قُريْشاً، فإنَّ عالِمهَا يمْلأُ الأرضَ عِلماً، اللهُمَّ إنَّكَ أَذَقْتَ أولَها عذاباً أوْ وبَالاً، فأَذِقْ آخرَهَا نَوالاً»([17]).
126- وأخبرناهُ أبو المَعَالي عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ الزُّبَيْدِيُّ بقراءتِي عليه مراراً، أخبرنا إسماعيلُ بنُ أبي بكرٍ الحَرَّانِيُّ، أخبرنا أحمدُ بنُ شَيْبانَ، أخبرنا عمرُ ابنُ محمدٍ الحسَّانيُّ، أخبرنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ أبو القاسم، أخبرنا أبو القاسم عبدُ اللهِابنُ أبي محمدٍ الحسنِ بنِ محمدٍ الخَلَّالُ الحافظُ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، أخبرنا عمرُ بانُ إبراهيمَ بنِ كَثيرٍ الكَتَّانِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ أخو زَنْبَرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ([18]) إسرائيلَ، حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ، أخبرنا النَّضْرُ بنُ مَعْبدٍ الكِنْديّ:
أخبرنا أبو الجَارُود، عن أبي الأحوصِ، عن عبدِ اللهِ رضي الله عنه، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُّوا قُريْشاً، فإنَّ عالِمَهَا يمْلأُ الأرْضَ عِلْماً، اللَّهمَّ أَذَقْتَ أولَها نَكالاً، فأذِقْ آخرهَا نَوالاً، ألَا لَا يُعجبْكَ امْرُءاً اكْتسبَ مالاً من حرامٍ، فإنَّه إنْ أنْفقَمنهُ لَمْ يُتَقَبَّلْ منْهُ، وإِنْ أمْسكَه لم يُبَارَكْ له فيهِ، وإنْ ماتَ وتركَهُ كانَ زادهُ إلى النَّارِ»([19]).
127- ورواهُ أبو أُميَّةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ الطَّرَسُوْسِيُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ هشامٍ، حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ، فذَكرهُ بطولهِ.
ولهُ شاهدٌ من حديثِ ابن عباسٍ، عن عليٍّ رضي الله عنهم([20])، ومن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه([21]).
وفي إسنادِهمَا فيما قالهُ أبو بكرٍ البيهقيُّ ضعفٌ.
وكذلك في إسنادِ ابن مَسعُودٍ السَّابق اختلافٌ، فقيل فيه: النَّضْرُ بنُ مَعْبدٍ، عن الجَارُودِ. وقيل: عن أبي الجَارُودِ، كما تقدَّمَ.
ورُوِيَ عن النَّضْرِ بنِ حُمَيْدٍ قال: حدثني أبو الجَارُوْدِ.
والنَّضْرُ بنُ حُميدٍ: مُنكرُ الحديثِ، فيما قاله/[25 ب] البخاريُّ([22]). وقال أبو حاتمٍ: مترُوكُ الحديثِ([23]).
وقال البيهقيُّ أيضاً حينَ روى حديث الجَارُودِ المُتَقَدِّم من طَريقِ أَبي داود الطَّيَالِسيِّ: حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ، عن النَّضْرِ، يعني: ابنَ حُمَيدٍ، أَوْ ابنَ مَعْبدٍ، عن الجَارُودِ.
كذا قال البَيْهقيُّ، وقال: وقد حملَهُ جماعةٌ من أئمَّتِنَا على أنَّ هذا العالِمَ الَّذي يمْلأُ الأرْضَ عِلماً من قُريشٍ هو الشَّافِعيُّ، رُوِيَ ذلك عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، وقالهُ أبو نُعَيْمٍ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الفَقِيهُ الأسْتَرَابَاذِيُّ([24])
وغيرهما. انتهى([25]).
وأبو نُعَيمٍ المذكورُ روى الحديث فقال:
128- حدثنا محمدُ بنُ عَوْفٍ، حدثنا الحَكَمُ بنُ نافعٍ، حدثنا ابنُ عيَّاشٍ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عبيدِ اللهِ:
عن وهْبِ بنِ كَيْسانَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «اللَّهُمَّ اهْدِ قُرَيْشاً، فَإِنَّ عالِمَهَا يَمْلأُ طِبَاقَ الأرضِ عِلْماً، اللَّهُمَّ كما أذقْتَهُم عَذَاباً فأذِقْهُم نَوالاً». دعا بها ثلاثَ مرَّاتٍ([26]).
قال أبو نُعَيمٍ في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: وذكرُ الحديثِ علامةٌ منه للمُمَيِّزِ أنَّ المُرادَ بذلك رَجلٌ من عُلماءِ هذه الأمَّةِ من قريشٍ قد ظهرَ عِلمُهُ، وانتشرَ في البلادِ، وكتبُوا تأْليفَهُ كما تُكتَبُ المصاحِفُ، واستظهرُوا أقوالهُ، وهذه صِفةٌ لا نعلمُها قد أحاطَتْ إلَّا بالشَّافِعيِّ؛ إذْ كان لكلِّ واحدٍ منهم نُتفٌ وقِطعٌ من العلمِ، ومُسَيئلاتٌ، وليسَ في كُلِّ بلدٍ من بلادِ المسلمِينَ مُدرِّسٌ ومُفتٍ ومُصنِّفٌ يُصنِّفُ على مذهبِ قُرَشيٍّ إلَّا على مذهبِه، فعُلمَ أنَّه بعيْنهِ لا غيرُهُ، وهو الذي شَرحَ الأصُولَ والفُروعَ، فازدَادت على مَرِّ الأيَّامِ حُسْناً وبَياناً([27]). انتهى.
وقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ الحميدِ المَيْمُوْنِيُّ([28]): كنتُ عندَ أحمدَ بن حنبلٍ رضي الله عنه، وجرَى ذكرُ الشَّافعيِّرضي الله عنه، فرأيتُ أحمدَ يَرفَعهُ وقال:
129- يُروى عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَبْعثُ لِهذهِ الأُمَّةِ عَلى رَأْسِ كُلِّ مائَة سنةٍ مَنْ يُقَرِّرُ لهَا دِينَهَا»([29]). وكان عمر بنُ/[26 أ] عبدِ العزيزِ رضي الله عنه على رأْسِ المائةِ، وأَرْجُو أَنْ يكون الشَّافِعيُّ على رأْسِ المائةِ الأخرى([30]).
130- وفي روايةٍ عن الإمام أحمدَ قال: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُقَيِّضُ للنَّاسِ في كُلِّ رَأْسِ مائَةٍ مَنْ يُعلِّمُهُمُ السُّنَنَ، ويَنْفِي عَنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الكذبَ»، فنظرنَا، فإذا في رأْسِ المائةِ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رضي الله عنه ونَحوُهُ، وفي رأْسِ المائتَينِ الشَّافعيُّ رحمةُ الله عليه، ونَحوُهُ([31]).
حَفظَ الشَّافِعيُّ القرآنَ وهو ابنُ سبعِ سنينَ، و«الموطَّأَ» وهو ابنُ عشرِ سنِينَ([32]).
قيل: حَفظَ «الموطَّأَ» في تسع، وقيل: في ثلاثِ لَيالٍ([33]).
ورحلَ من مكَّةَ إلى المدينةِ للقَاءِ إمامِها وعالمِها مالكِ بنِ أنسٍ، فقرَأَ عليه «الموطَّأَ» حفظاً، وأعجبَتهُ قراءتهُ، وعمرهُ إِذْ ذاكَ ثلاثَ عشرةَ سنةً([34]).
131- قال الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ: سمعتُ أبا العباس محمدَ بنَ يعقوبَ: سمعتُ الرَّبيْعَ بنَ سليمانَ يقول: قال الشَّافِعيُّ: جِئتُ مالكاً وقد حَفظْتُ «الموطَّأَ» ظاهراً([35])، فقال لي: اطلُب من يَقرأ لك، فقلتُ: لا عليكَ أَنْ تسْمعَ قراءتي، فإِنْ خفَّت([36]) عليكَ، قرأتُ لِنَفسِي([37]).
قال: فلمَّا سَمِعَ قراءتِي، قرَأتُ لنَفسِي([38]).
وقد رُويَ أنَّ الشَّافِعيَّأقامَ بالمدينةِ حتَّى تُوفي مالكٌ، ثم قَدِمَ المدينةَ والي اليمنِ، فكلَّمهُ بعض القرشيِّينَ أَنْ يَصْحَبَ الشَّافِعيَّ معهُ إلى اليمنِ، ففعلَ، واستعْملَالشَّافِعيَّ في أعمالٍ باليمنِ، فحملَ النَّاسَ على السُّنَّةِ والطَّريقةِ الحسنةِ، وحُمِدَتْ سيرتُهُ، ومُدِحَتْ طريقتُهُ إلى أنْ وشَوْا بهِ وبالعَلَوِيِّ الَّذي كان صَحِبَهُ الشَّافِعيُّ، وهو عبدُ اللهِ بنُ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فوشوْا بهمَا إلى هارونَ الرّشيدِ، فأَرسلَ إلى اليمنِ في طلبِهِمَا، فجُهِّزَا إلى العراقِ معَ العَلَوِيِّينَ، وبها كانت مِحنةُ الشَّافِعيِّ([39]). وكان قد تركَ الولايةَ وأخذَ في الاشتِغالِ بالعُلُومِ إلى أنْ صارَ عَلماً بهِ يُهْتَدَى، وإِمَاماً باتِّباعهِ /[26/ب] يُقْتَدَى.
ولهُ مُصنَّفاتٌ عولَ النَّاسُ عليها، منها مُبْتكرَاتٌ لم يُسبق إليها، مِثلُ كتاب «الرِّسالةِ» المنقُولِ إلى عبدِ الرحمن بنِ مَهْديٍّ([40])، وهو أوّل مُصنَّفٍ في الأصُول.
قال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل: كان الشَّافِعيُّ كالشَّمسِ للدُّنيَا، والعافيةِ للنَّاسِ، فانظُر هل لهذينِ من خَلفٍ، أو منهما عِوضٌ؟([41]).
وثناءُ الأئمَّةِ علىالشَّافِعيِّ كثيرٌ مقبولٌ، وقد صنّفَ في مَناقبهِ غَيرُ واحدٍ من أئمَّةِ المَنقُولِ([42]).
روى عن:
طائفةٍ من المَكِّيِّيْنَ، منهم:
سفيانُ بنُ عُيينةَ، وعبدُ المجيدِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوّادٍ، وعَمُّهُ محمدُ بنُ عليِّ بنِ شَافِعٍ.
وعن جماعةٍ من المَدنيِّيْنَ، منهم: مالكُ بنُ أنسٍ، وعبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّرَاورْدِيُّ، وإِبرَاهيمُ بنُ سعدٍ الزُّهريُّ([43]). وروى عن خَلْقٍ منَ اليمنِ، والشَّامِ، ومصرَ، والعراقِ، وغيرها من الآفاقِ.
حدَّث عنه: خَلْقٌ، منهم: أحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو عبيد القاسمُ بنُ سَلَّامٍ، وأبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ الحُمَيْدِيُّ، وأبو أَيُّوب سليمانُ بنُ داود الهَاشميُّ، والحسنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، وأبو محمدٍ الرَّبيْعُ ابنُ سليمانَ بنِ عبدِ الجبَّارِ المرَادِيُّ، وابنهُ أبو عثمانَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إدْرِيسَ قاضي الجَزِيرَةِ([44])، ([45]) وبها توفي بعدَ سنةِ أرْبعينَ ومائتَينِ، وهو محمدٌ الأكبرُ، وأمَّا ابنُهُ محمدٌ الأصغرُ فهو أبو الحسنِ محمدٌدَرَجَ([46]) طِفْلاً، وهذا من سُرِّيَّةٍ كانت للشَّافِعيِّ، اسمُهَا: دَنَانِيرُ، فيما قيل([47])، وابنهُ أبو عثمانَ من حَمْدَةَ بنتِ نافعٍ العُثمَانيَّة([48]).
[وفاته: ] وقال أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ: سمعتُ الرَّبِيْعَ يقول:
ماتَ الشَّافعيُّسنةَ أربعٍ ومائتَينِ، وهو ابنُ أربعٍ وخمسِينَ سنةً([49]).
وقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلى: سنةَ أربعٍ أو خمسٍ ومائتَينِ، وهو ابنُ سِتّ([50]) وخمسينَ سنةً([51]).
وذكرَ حفيدُهُ عبدُ الرحمن بنُ أحمدَ بنِ يونسَ بنَ عبدِ الأعلى: أنَّ الشَّافعيَّ قَدِمَ مصرَ معَ عبيدِ اللهِ بنِ العباسِ بنِ موسى الهَاشِميِّ سنةَ تسعٍ /[27 أ] وتسعِينَ ومائةٍ([52])، فأقامَ بمصرَ، وحدَّثَ بكُتُبهِ الفقهيَّةِ، وكان كريماً إلى أنْ تُوفي آخرَ ليلةٍ من رجبٍ بمصرَ سنةَ أربعٍ ومائتَينِ([53]). انتهى.
132- أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، قال: قرأتُ على أُمِّ عبدِ اللهِ زينبَ ابنةِ أحمدَ بنِ عبدِ الرَّحيمِ، عن أحمدَ بنِ المُفَرَّجِ بنِ مَسْلَمَة، أنبأنا السّيِّدُ الإمامُشيخُ الإسلامِ أبو محمدٍ عبدُ القادرِ بنُ أبي صالحٍ الحُبُليُّ، أخبرنا هبةُ اللهِ بنُ المباركِ السَّقَطِيُّ سماعاً، أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ قَفَرْجَلَ، أخبرنا أبو أحمدَ عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ الفَرَضِيُّ، أخبرنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ الحسينِ المُسْتَمْلي إملاءً، سمعتُ أبا نُعَيمٍ، يعني: عبدَ الملك بنَ محمدِ بنِ عَدِيٍّ الجُرْجَانِيّ:
سمعتُ الرَّبِيْعَ يقول: قَدِمَ علينا الشَّافعيُّ مِصرَ وأقامَ، وتُوفي ليلةَ الجمعةِ بعدَ المغربِ وأنا عندهُ، ودُفِنَ بعدَ العصْرِ، وانصرفنا من جنازتهِ، ورأينَا هلالَ شعبان سنةَ أربعٍ ومائتَينِ([54]).
كان الَّذي صلَّى على الشَّافِعيِّ رضي الله عنه السَّرِيُّ بنُ الحَكمِ أميرُ مصرَ، وكان قاضيها يومئذٍ لَهِيْعَةُ بنُ عيسى الحَضْرَمِيُّ، ودُفِنَ بمقبرةِ القُرَشِيِّينَ من جبلِ المُقَطَّمِ([55]) بمصرَ، وقبرُهُ بها في مَشْهدٍ معرُوفٍ رحمةُ الله عليه([56]).
قال الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ: كان الشَّافعيُّ يَخْضِبُ بالحِنَّاءِ([57])، وكان خفيفَ شَعْرِ العَارِضَينِ. انتهى([58]).
ومن غُرَرِ كلامِهِ، ودُرَرِ حِكَمِهِ:
133- ما أخبرنا أبو هريرة عبدُ الرحمن بنُ الحافظِ أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ الذَّهَبيِّ، فيما قُرِئَ عليه وأنا أسمعُ في ذِي القَعْدَةِ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ وسبعمائةٍ، أخبرنا العَفِيْفُ إسحاقُ بنُ يحيى بنِ إسحاقَ الآمِديُّ سماعاً، أخبرنا أبو الحَجَّاجِ يوسفُ بنُ خليلٍ الحافظُ، أخبرنا عبدُ اللَّطيفِ بنُ محمدٍ الخُوارِزْميُّ بأَصْبهانَ، أخبرنا أبو طاهرٍ زاهرُ بنُ طاهرٍ، أخبرنا أبو أحمدَ عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ الفَامِيُّ، أخبرنا أبو عمرو أحمدُ بنُ أبي الفُراتِيِّ، سمعتُ أبا العباس الحسنَ بنَ سعيدٍ المُقْرِئَ البَصْريَّ يقول: سمعتُ /[27 ب] محمدَ بنَ زُغْبَةَ يقول: سمعتُ يونسَ بنَ عبدِ الأعلى الصَّدَفيَّ يقول: سمعتُ الشَّافعيَّ يقول: «مَن حَفِظَ القُرْآنَ عَظُمَتْ قيمتهُ، ومَنْ تَفقَّهَ نَبُلَ قَدْرهُ، ومَنْ كتبَ الحديثَ قَوِيتْ حُجَّتهُ، ومَنْ نَظرَ في اللُّغَةِ والعربيَّةِ رَقَّ طَبْعُهُ، ومَنْ لم يَصُنْ نفْسَهُ لم ينْفعْهُ علْمُهُ»([59]).
وقال الحافظُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ الواحِدِ بنِ محمدٍ الدَّقَّاقُ([60]):
134- أخبرنا أبو عبدِ اللهِ بنُ أبي الحسينِ الفَسَوِيُّ فيما قرأْتُ عليه، أخبركُم محمدُ بنُ أبي زكريّا في كتابهِ أنَّه سمعَ أبا إسحاقَ إبراهيمَ بنَ محمدٍ الطِّرِمَّاحَيَّ من مرضهِ الَّذي توفي فيهِ يقول: سمعتُ أبا العباس الأصَمَّ يقول: سمعتُ الرَّبيْعَ بنَ سليمانَ يقول: سمعتُ الشَّافعيَّيقول لأصحابهِ: «إذا دخلْتُم خُراسَانَ، فعَيْكُم بالفقْهِ فإنَّه درْهمٌ في دِينارٍ، ودِينارٌ في درْهمٍ، وشَرفٌ في شَرفٍ، ونِعْمةٌ في نِعْمةٍ، وعافِيةٌ في عافِيةٍ، وعِزٌّ في عِزٍّ، وإيَّاكُم والكلامَ فَإنَّه لِطَامٌ في لِطَامٍ، وصَفْعٌ في صَفْعٍ، وسيْفٌ في سِكِّيْنٍ، وسكِّينٌ في سَيْفٍ، وشَرٌّ في شَرٍّ، وفِتْنةٌ في فِتْنةٍ، وبَليَّةٌ في بَليَّةٍ ([61])»([62]).
135- أخبرنا أبو المَحَاسِنِ يوسفُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حاتمِ بنِ حاتمٍ إجازةً مُطْلقةً، وقرأتُه على أبي الحسنِ عليِّ بنِ إسماعيلَ بنِ محمدٍ المُؤَذِّنُ عنه سماعاً، أخبرنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ أبي الحسينِ الحافظُ قراءةً عليه ونحنُ نسمعُ، أخبرنا الحسنُ والحسينُ ابنا المباركِ، وعبدُ السَّلامِ بنُ سُكَينةَ، ومحمدُ بنُ سعيدِ بنِ الخَازِنِ، ومحمدُ ابنُ الوسْطَانِيِّ، وعليُّ بنُ عبدِ الرحمن بنِ الجَوزيِّ، قالوا: أخبرنا طاهرُ بنُ محمدٍ، أخبرنا مكِّيُّ بنُ منصُورٍ، أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضي، حدثنا أبو العباس محمدُ بنُ يعقوبَ، أخبرنا الرَّبيْعُ بنُ سليمانَ المصريُّ: حدثنا محمدُ بنُ إِدريسَ الإمامُ، أخبرنا مالك، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرجِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
«صلاةُ الجماعةِ أفْضلُ من صلاةِ أحدكُمْ وحْدَهُ بخمْسةٍ /[28 أ] وعشْرينَ جُزْءاً».
هو غريبٌ من حديثِ مالكٍ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرَجِ، عن أبي هريرة.
وغريبٌ أيضاً من حديثِ الشَّافِعيِّ، عن مالكٍ، تفرَّدَ بروايتهِ عنه الرَّبيعُ بنُ سليمانَ.
وقيل: إنَّه وهِمَ فيهِ عن الشَّافِعيِّ، وصوابُه: عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن أبي هريرة، والله أعلمُ. قالهُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الخطيبُ([63]).
وهكذا رواهُ أصحاب مالك على الصَّوابِ، كعبدِ اللهِ بنِ وهْبٍ([64])، وعبدِ اللهِ ابنِ مَسْلَمةَ القَعنبِيِّ([65]): عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه([66]).
136- وقال أبو نُعَيْمٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأصْبهانِيُّ: حدثنا أحمدُ بنُ جعفرِ ابنِ سَلْمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ عليٍّ الأبَّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ خالدٍ قال:
قال الشَّافِعيُّ: قيل لمالكِ بنِ أنسٍ: عندَ ابن عُيينةَ عن الزُّهريِّ أحاديثُ لَيستْ عندكَ؟ فقال: وأنا أُحَدِّثُ عن الزُّهرِيِّ بكُلِّ ما سمعتُ؟! إِذَنْ أُرِيْدُ أَنْ أضِلَّهُمْ([67]) .
* * *
([1]) قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ص 467): نزيل مصر، رأس الطبقة التاسعة، وهو المجدد لأمر الدين على رأس المئتين. ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير»: (1/42)، «الجرح والتعديل»: (7/201 202)، «الثقات»: (9/30 31)، «حلية الأولياء»: (9/156 161)، «تاريخ بغداد»: (2/56 73)، «طبقات الفقهاء»: (ص187)، «ترتيب المدارك»: (1/221 231)، «المنتظم»: (10/134 140)، «تاريخ مدينة دمشق»: (51/267 438)، «تهذيب الكمال»: (24/335 381)، «سير أعلام النبلاء»: (10/5 98)، «طبقات الشافعية الكبرى»: (2/71 74)، «الديباج المذهب»:(ص227 230)، «تهذيب التهذيب»: (9/23 27).
([2]) «تاريخ بغداد»: (2/57)، «معرفة السنن والآثار»: (1/102)، «فضائل الشافعي»: (1/76 77)، «ترتيب المدارك»: (1/221 231).
([3]) قاله الخطيب في «تاريخ بغداد»: (2/58)، وزاد: ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع. وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (10/9): له رؤية، وهو معدود في صغار الصحابة. وينظر: «الإصابة» (3/310)، «أسد الغابة» (2/501).
([4]) في المصادر: لأحرم. ينظر: «تاريخ بغداد»: (1/218)، «فضائل الشافعي»: (1/76 77)، «تاريخ دمشق»: (51/274)، «المنتظم»: (10/134)، «تهذيب الكمال»: (24/360)، «الإصابة»: (3/23).
([6]) قال محب الدين الطبري في كتابه «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» دار الكتب المصرية، مصر: (ص242): ويقال: إن الذين كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، والحسن بن علي، وقثم بن العباس، وأبو سفيان بن الحارث، والسائب بن عبيد بن عبد نوفل بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف.
([7]) قاله الخطيب في «تاريخ بغداد»: (1/218)، وزاد: كان صاحب راية بني هاشم، فأسر وفدى نفسه، ثم أسلم. وينظر: «معرفة السنن والآثار»: (1/205)، «فضائل الشافعي»: (1/76 77)، «تاريخ دمشق»: (51/274)، «المنتظم»: (10/134)، «تهذيب الكمال»: (24/360)، «سير أعلام النبلاء»: (10/9)، الإصابة (3/23).
([8]) قال البيهقي في «فضائل الشافعي»: (1/85) بعد ذكره لهذا القول: فهذه رواية لا أعلمها إلا من جهة أبي نصر، وسائر الروايات تخالفها.
([10]) ورجحه البيقهي أيضاً في «فضائل الشافعي»: (1/75) قال: والذي يدل عليه سائر الروايات من ولادته بغزة، ثم حمله منها إلى عسقلان، ثم إلى مكة، وَالله أعلم.
([11]) قال ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص 52) في تعليقه على قول الشافعي: (ولدت باليمن): قال الحافظ شمس الدين الذهبي شيخ شيوخنا: هذا القول غلط إلا أن يريد باليمن القبيلة!
قلت (القائل ابن حجر): سبقه إلى ذلك البيهقي في «المدخل»، وهو محتمل، أو وَهِمَ أحمد ابن عبد الرحمن في قوله: (وُلِدْتُ)، وإنما أراد (نشأتُ).
فالذي يجمع الأقوال أنّه وُلد بغزة عَسقلان، ولَمّا بلغ سنتين حوّلته أمه إلى الحجاز، ودخلتْ به إلى قومها وهم من أهل اليمن لأنَّها كانت أزدية، فنزلت عندهم، فلمَّا بلغ عشراً خافتْ على نسبه الشريف أنْ يُنْسى ويضيع، فحوّلته إلى مكة.
([12]) وهذا الكتاب مطبوع، واسمه: «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، 1404ﻫ. وقد راجعت الكتاب من أوله لآخره ولم أقف على هذا القول للبيهقي. لكن أشار البيهقي إلى هذا القول في كتابه الآخر «مناقب الشافعي»: (1/74 75).
([13]) ينظر: «تاريخ بغداد»: (2/59). وقال البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/71): لا أعلم خلافاً بين أصحابه أنه ولد سنة خمسين ومئة في السنة التي مات فيها أبو حنيفة.
([14]) خرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (2/59)، وزاد: فتأول أصحاب الرؤيا أنه عالم يخص علمه أهل مصر ويفترق منها في كل البلاد. وخرجها القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: (1/228)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»: (51/278 279)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (4ا/307)، وفي «سير أعلام النبلاء»: (10/10) وقال: هذه روايةمنقطعة. وخرجها ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (9/24). وهذا الخبر يكاد يكون متواتراً في كتب التراجم.
([17]) خرجه أبو داود الطيالسي في«مسنده»، دار المعرفة، بيروت: (ص39) برقم (309)، ومن طريقه: خرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (6/295)، (9/65)، وابن حزم في «الإحكام»: (6/286)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (2/60)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»: (51/326).
([19]) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير»: (4/289) برقم (1883) بسنده إلى جعفر بن سليمان... ثم ساق بقية السند به، وزاد: (ولا يعجبنك رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله عز وجل قاتلاً لا يموت). قال في آخر الحديث: ولا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه.
وخرجه الشاشي في«مسنده»: (2/169) برقم (728) بسنده إلى جعفر بن سليمان... و ساق بقية السند به.
وخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي»: (1/26) بسنده إلى سعيد بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل... وساق بقية السند بلفظ: «لا تَسبُوُّا قُريشاًً، فإن عالمها يملأُ الأرضَ علماً، اللَّهُمَّ أذقتَ أوَّلَها نكالاً، فأذِقْ آخِرَها نوالاً»، فذكره مختصراً.
([20]) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» تحقيق أحمد صقر، دار التراث، مصر، ط1/ 1970م): (1/24 25) بسنده إلى عدي بن الفضل، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي حَثْمَةَ، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال لي علي بن أبي طالب... وذكر الحديث. قال ابن حجر في «توالي التأسيس» حققه أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1986م: (ص 46 47): أخرج بعض هذا الحديث أبو بكر البزار في «مسنده»، وأبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» من طريق عدي بن الفضل. قال البزار: لا نعلم لأبي بكر ولا لأبيه غيره. قال ابن حجر: وهما مجهولان، وفي عدي بن الفضل مقال.
([24]) عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق، الأزهري، أبونعيم الإسفراييني، راوي «المسند الصحيح» عن خال أبيه أبي عوانة، الحافظ، وكان صالحاً، ثقة، واعتنى به أبو عوانة، وأسمعه كتابه، وأحضروه إلى نيسابور، ولد (310ﻫ)، ومات (400ﻫ). ينظر: «العبر»: (3/75)، و«المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور»، لعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، انتخبه إبراهيم بن محمد الصيرفيني، تحقيق: خالد حيدر، دار الفكر، بيروت، 1414ﻫ: (ص356).
([26]) خرجه البيهقي في «مناقب الشافعي»: (1/27) بسنده إلى أبي نعيم عبد الملك بن محمد قال: أنبأنا محمد بن عوف... وساق بقية السند به. ومن طريق أبي نعيم خرجه الخطيب في «تا ريخ بغداد»: (6/60)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»: (51/326).
قال فيه ابن حجر في «توالي التأسيس»: (ص43): في إسناده عبد العزيز يعني ابن عبد الله وهو ضعيف، ورواية إسماعيل يعني ابن عياش عن غير الشاميين فيها ضعف.
قال البيهقي في «مناقب الشافعي»: (1/27): أسانيد هذا الحديث إذا ضُم بعضها إلى بعض مع ما تقدم صارت قوية.
([27]) خرج قول أبي نعيم بتمامه البيهقي في «مناقب الشافعي»: (1/29)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (2/60)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»: (51/326 327)، وغيرهم.
([28]) عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري، الرقي، أبو الحسن الميموني، ثقة فاضل، لازم أحمد أكثر من عشرين سنة، مات سنة (274ﻫ) وقد قارب المائة، روى له النسائي. «تقريب التهذيب»: (ص363).
([29]) خرجه أبو داود في«سننه» في كتاب الملاحم، باب: ما يذكر في قرن المائة: (4/109) برقم (4291)، والطبراني في «المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط2/ 1983م: (6/324) برقم (6527)، وابن عدي في «الكامل»: (1/114)، والحاكم في «المستدرك»: كتاب الفتن والملاحم، باب: يعقر الله أرحام النساء ثلاثين سنة: (4/567) برقم (8592)، والداني في «الفتن»: (3/743)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»: (1/208) برقم (412)، وفي «فضائل الشافعي»: (1/53)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (2/61 62)، وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3/ 1404ﻫ: (ص51)، وفي «تاريخ دمشق»: (51/338) كلهم من طريق شراحيل بن يزيد، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
قال ابن حجر في «توالي التأسيس»: (ص49) بعد أن ذكر هذه الرواية وجميع من خرجها وأقوالهم: وهذا يُشْعِرُ بأن الحديث كان مشهوراً في ذلك العصر، ففيه تقوية للسند المذكور، مع أنه قوي لثقة رجاله.
([30]) خرَّجه من طريق الميموني بهذه الزيادة: البيهقي في «مناقب الشافعي»: (1/55)، و ابن عبد البر في «الانتقاء»: (ص75)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (51/339).
([31]) خرجها الخطيب في «تاريخ بغداد»: (2/62)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (51/339)، وابن الجوزي في «المنتظم»: (10/139) وغيرهم.
قال الصفدي في «الوافي بالوفيات»: (4/140): إن الله بعث على رأس المئة الأولى عمر ابن عبد العزيز، وعلى رأس الثانية الشافعي، وعلى رأس المئة الثالثة ابن سريج، وعلى رأس المئة الرابعة أبا حامد الإسفراييني، وعلى رأس المئة الخامسة أبا حامد الغزالي، وعلى رأس المئة السادسة الإمام فخر الدين الرازي، وعلى رأس المئة السابعة الشيخ تقي الدينابن دقيق العيد.
وزاد السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (1/204): وفي الثامنة البلقيني أو العراقي، وفي التاسعة المهدي ظناً أو المسيح عليه الصلاة والسلام، فالأمر قد اقترب والحال قد اضطرب فنسأل الله حسن الخاتمة.
قال ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم»، تحقيق الأستاذ عبد الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط1/ 1988م: (1/18): وقد ادعى كل قومٍ في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر والله أعلم أنه يعمُّ جملةَ أهلِ العلمِ من كلِّ طائفةٍ، وكل صنف من أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف، والله أعلم.
([32]) خرج الخطيب هذا القول في «تاريخ بغداد»: (2/63) من طريق المزني قال: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن... وذكره. والخبر مذكور في «المنتظم»: (10/139)، و«سير أعلام النبلاء»: (10/11)، و«توالي التأسيس»: (ص54)، وغيرها.
([34]) قاله ابن حجر في «توالي التأسيس»: (ص55 56).
وذكره في رواة الموطأ عن مالك: ابن الأ كفاني في تسمية من روى الموطأ عن مالك (ق201 أ)، والقاضي عياض في ترتيب المدارك (1/107/108)، والسيوطي في تتوير الحوالك (1/10).