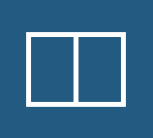الموقف الإسلامي
الموقف الإسلامي
كتب الدكتور تيسير خميس العمر حول هذا الموضوع في كتابه ( العنف والحرب والجهاد) الصادر عن دار المقتبس – بيروت – سنة (1439هـ - 2018م)
فقال :
قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[البقرة: 213]. إن الناس يرجعون إلى أصل تكويني واحد، ومنشأ روحي ومادي واحد، لا يختلف أحدهمعن الآخـر: فهـم أمة واحـدة حملوا التركيب نفسه منذ كانوا نسمات في عالم الذر «فإنهم كانوا حين أشهدهم الله على أنفسهم أمة واحدة ولدوا على الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولـد على فطـرة الإسلام فأبـواه يهودانـه أو ينصرانـه أو يمجسانـه»([1]) ولم يقـل عليه السـلام ويسلمانه لأن الكفـر يحصل بالتقليد لكن الإيمان الحقيقي لا يحصل به...»([2]).
وأن ما يـدور الآن بين الناس من تساؤلات حـول (أيولد الإنسان شريراً أم خيّراً؟)... يبعث على النظـر في عنصر الإنسان المادي، وما ركب فيه من أهواء وشهوات، فيرى للوهلـة الأولى أن الإنسان شرير بطبعـه وهـذا ما دفع الملائكة للتساؤل: ﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾[البقرة: 30]. وربما طرح السؤال منهم ولم يزل آدم عليه السلام في طور الخلق المادي. إلا أن الذي يعلم ما دق وما لطف قد بين لعبـاده من ملائكة وغيرهـم ذلـك الجانب بقولـه تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 30].
وهـذا يعني أن هنـاك جانباً لم تبصروه بعد ولم تعلموه «إن المراد من الآية بيان الحكمة من الخلافة على أدق وجـه وأكملـه، فكأنـه قال تعالى: أريد الظهور بأسمائـي وصفاتـي ولم يكمـل ذلـك بخلقكم، فإني أعلـم ما لا تعلمون لقصور استعدادكم ونقصان قابليتكم، فلا تصلحون لظهور جميع الأسماء والصفات فيكم، فلا تتـم بكـم معرفتي، ولا يظهر عليكم كنزي فلابد من إظهار من تم استعداده وكملت قابليته، ليكون مجليا لي ومرآة لأسمائي وصفاتي ومظهراً للمتقابلات فيَّ، مظهراً لما خفي عندي وبي يسمع وبي يبصر وبي وبي...»([3]).
تعرضت آيات القرآن الكريم كذلك لهذه المسألة وجلتها أوضح تجلية في قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾[البلد: 10] أي: طريقي الخير والشر([4]). أي: بينّا له طريـق الهـدى بأدلـة العقل والسمع([5]) وقوله تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾[الشمس: 7 ـ 10].
تبين من الآيات الكريمة أن الإنسان عنده القابلية للفعلين معاً من شر وخير وعنف ورفق. يقول ابن خلدون: «إن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئـة بقبـول ما يرد عليهـا ويتطبع فيها من خير أو شر. قال صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»([6]) وبقدر ما سبـق إليهـا من أحـد الخلقين تبعـد عن الآخـر، ويصعب عليها اكتسابه. فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسـه عوائد الخير وحصلت لها مَلَكَتَهُ، بعُد عن الشر وصعُب عليه طريقه كذا صاحب الشر...»([7]).
فإذا كـان هناك تأثير للفطـرة أو التكوين الطبيعـي على الإنسان في شيء، فإن الإسلام يأمر بتدريب النفس على فعل الخير، وتربيتها تربية حسنة، وتعويدها على مكارم الأخلاق، ويكون هذا بالتدريب والممارسة كما جاء في الحديث الشريف: «إنما العلـم بالتعلـم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرَّ الخير يعطَـه ومـن يتق الشر يوقه»([8]) .
يولي الإسلام البيئـة الاجتماعية أهميـة كبيرة، تبين لنا ذلك من خلال قوله تعالى في وصـف مريـم: ﴿وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّـهِ ۖ إِنَّ اللَّـهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾[آل عمران: 37] أي: هيأ لها بيئة تقى وعلم لتتربى في كفالة نبي، فمريم زكية المنبت طاهرة التربية. «وللبيئـة بنوعيهـا ـ الاجتماعية والطبيعية ـ أثران متضادان فقد تغذي الإنسان وترقيه وقد تضعفه وتضنيه كالنبات في المنبت السوء لا تزال بيئته به حتى تضعفه أو تميته، وفي المنبت الصالح يربـو وينبت من كـل زوج بهيـج قـال تعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ [الأعراف: 58] كذلك الإنسان إن نشأ في بيئة صالحة من بيت طيب، ومدرسة راقية مؤدبة، يحكمه قانون عادل، ويدين بدين صحيح، نبت خير منبت، وكوِّن أحسن تكوين وإلا فما أحراه أن يكونه شريراً»([9]).
ولم يـأل علـماء المسلمين جهداً في بحث جميـع المسائـل في شتى المجالات ومن بينها هذه المسألة، فقد درسوهـا، وقدموا جواباً شافياً وموقفاً بيِّناً لا ظنـون فيه ولا تخمينات، فهـذا الغـزالي يرد على المعطلين الذين يرون أن الأخلاق لا تقبل التغيير فيقـول: «لـو كانت الأخـلاق لا تقبـل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديب، ولما أمـر الشارع بوجوب تحسين الأخـلاق في آيات وأحاديث كثيرة، وكيف ينكـر هـذا في حـق الآدمي وتغيير خلـق البهيمة ممكن؟! إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس، والفـرس من الجماح إلى السلاسـة والإنقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق»([10]).
ويؤكـد هـذا الكـلام الماوردي بقولـه: «اعلـم أن النفس مجبولة على شيممهملة، وأخلاق مرسلة، لا يستغني محمودها عن التأديب، ولا يكتفى بالرضي منها عن التهذيب»([11]).
والإسلام بعـد ذلك لا ينظر إلى العمل لذاته، وإنما للغاية التي يرمي إليها العمل، ولا يبحث في منشـأ العمـل فطرياً كـان أم مكتسباً «فكـل دافـع ذاتي في الإنسان سواء أكان فطرياً أم مكتسباً، يدفعـه حتى يؤدي الحقوق التي عليه كاملة، أو حتى ينعـم على غيره بعطاء من علمـه أو من قدرتـه أو من جاهه أو من ماله، متجاوزاً في ذلك عوامل نفسه الأنانيـة: هو من أصـول مكارم الأخلاق وكلياتها العامـة. ونقيـض هذا الأصل أحد أصول الرذائل الخلقية أو كلياتها العامة: فكـل دافع ذاتي في الإنسان فطري أو مكتسب يدفعه حتى يعتدي على ما ليس له بحق، بغية حيازته لنفسه، أو يدفعه حتى يبخل بعطاء ينفع آخذه ولا يضر باذله، أو يبخل بما يدفع الضرورة الملحة عن غيره مع عـدم اضطراره إليه، أو مع عدم حاجته إليه إلا حاجـة الاستجابـة للطمع أو الشـر، وشهـوة الاستئثار أو الاستجابة للرغبة بالاستزادة في الرفاهية المفرطة، هو من أصول الرذائل الخلقية وكلياتها العامة»([12]).
إن الأثر المترتب على الفعل هو الذي يعطي التقييم الأخلاقي له حسناً أو قبحاً، عنيفاً أو سهلاً «وأعمالنا نحن بني الإنسان ليست خيراً كلك لذاتها ولا شراً لذاتها، بل للغاية التي توجه إليها الأثر الذي يترتب عليها. أليس الله مع ذلك يحرم القتل فيقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾[الإسراء: 33] والقتل بالحق لا إثـم فيـه قـال تعـالـى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[البقرة: 179]...»([13]).
خلاصة القول: هي أن الإنسان يوجه الانتباه لرعاية المجتمع لدفـع الرذيلـةوالشر عنه، فيهيئ البيئة الصالحة ويقدم التربية الصالحة، ويأمر بتهذيب الأخلاق، والقيام على تحـري الخير والصـلاح متجاوزاً حدود الإلزام الطبيعي أو الفطري، فلا عذر للإنسان فيما يعمل إن أساء.
* * *