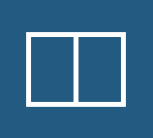مواقع إنما وأسرارها في أبواب الحديث عن الزهد من سنن ابن ماجه
مواقع إنما وأسرارها في أبواب الحديث عن الزهد من سنن ابن ماجه
كتب عن هذا الموضوع الكاتب الصيني ماشياومينغ في كتاب ( إنما وأسرارها البلاغية في سنن ابن ماجه ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة ( 1439هـ - 2018م)
فقال:
روى ابن ماجه بسنده عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ، رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:مَا يُبْكِيكَ؟ أَيْ خَالِ! أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ، أَمْ عَلَى الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا؟ قَالَ: عَلَى كُلٍّ لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: «إِنَّكَ لَعَلَّـكَ تُدْرِكُ أَمْـوَالاً تُقْسَـمُ بَيْنَ أَقْـوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِـكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله». فَأَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ([1]).
* مقصود الحديث:
مقصود الحديث هو حث الأمة على الزهد في الدنيا، والقناعة والاكتفاء بقدر الكفاية مما يصح أن يكون زادا للآخرة([2]).
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هذا المقصد جاء الحديث على شكل الحوار الجاري بين معاوية وأبي هاشم بن عُتْبة ـ رضي الله عنهما ـ . وذلك أن معاوية ـ رضي الله عنه ـ أتى أبا هاشم ـ رضي الله عنـه ـ يعوده، فبكى أبو هاشم ـ رضي الله عنه ـ . لذلـك سأله معاوية ـ رضي الله عنه ـ عن سبب بكائـه (مَا يُبْكِيكَ؟ أَيْ خَـالِ! أَوَجَـعٌ يُشْئِزُكَ، أَمْ عَلَى الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَـا؟)، فأجابـه أبو هاشم ـ رضي الله عنه ـ بقوله (عَلَى كُلٍّ لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: «إِنَّكَ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله». فَأَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ.).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
جاء أسلوب القصر بإنما في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله)، أورد أبـو هاشم ـ رضي الله عنه ـ قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إِنَّكَ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيـكَ مِنْ ذَلِـكَ خَـادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله) بيانا لسبب بكائـه. وقد عهـد له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله هذا عهدا، يعني أوصاه بوصيـة، غير أنه لم يعمـل بها كما فهم من قولـه (وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُـهُ)، وكذلـك صرح بذلـك في روايـة أخرى حيث قال (لَمْ آخُذْ بِهِ)([3]). فعدم عمله بها هو سبب بكائـه، فهذا البكاء بكاء الندم والأسف، بكاء التقوى والخوف من الله ـ تعالى ـ . هكذا كان الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ في غايـة الخوف وشدة الورع، يخافون من عدم القيام بما أوصاهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع كونهم متمسكين به، هذا أبو هاشم ـ رضي الله عنه ـ بكى على ذلـك مع أنـه لما مـات ما تجـاوز ما جمعه ثلاثين درهما([4]). فهو لم يبك على شدة وجع مرضه ولا على مفارقة الدنيا كما ظن معاوية (أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ([5])، أَمْ عَلَى الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا؟).
عهـد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي عهـد إلى أبي هاشم ـ رضي الله عنـه ـ، أو وصيته التي أوصاه بهـا مكونـة من جملتين: أكـد لـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الأولى منهما أنـه قد يدرك كثيراً من الأموال (إِنَّكَ لَعَلَّـكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ)، وأوصاه في الثانية منهما بالزهـد فيها (وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِـكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله). وقد أكد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصيته هذه، حيث أوردها بأسلوب القصر إرشادا له إلى كيفية التعامل مع ما يدركه من الأموال، وأنه ليس له إلا القناعة والاكتفاء بقدر الحاجة (خادم ومركب)، خادم في السفر لضرورة الحاجة إليه، ومركب يسار عليه في سبيل الله، في الجهـاد أو الحج أو طلب العلم. والمقصود منه القناعة والاكتفاء بقدر الكفاية مما يصح أن يكون زادا للآخرة([6]).
«وهذا إرشاد إلى الزهـد في الدنيا والاقتصار فيهـا على قـدر الحاجـة، فإن التوسع فيها وإن كان قد يعين على المقاصد الأخروية، لكن النعم الدنيوية قد امتزج دواؤها بدائهـا ومرجوهـا بمخوفهـا ونفعهـا بضرهـا، فمن وثق ببصيرته وكمال معرفته، فلـه استكثار بقصد صرف الفاضل إلى ما يوصل إلى منازل الأبرار، وإلا فالبُعد البعد، والفرار الفرار عن مظان الأخطار»([7]).
القصر هنـا في ظاهره وقع بين أجزاء الجملـة الفعليـة، حيث قصر الفعـل الواقع على مفعوله مع الجار والمجرور المتعلقين به (يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ) على فاعله (خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله)، فأثبت الكفاية لخادم ومركب، ونفاها عن غيرهما، بما يدخل في ذلك ما زاد عليهما. غير أن المعنى حينئذ لا يستقيم، لأنه يعني أن الذي يكفيـه من تلك الأموال هو الاثنان: خادم ومركب، ولا يكفيه غيرهما، حتى إذا ما زاد عليهما، والحقيقة أن ما زاد عليهما يكفيه من باب الأولى. ثم لا معنى لحمله على المبالغـة، لأنه لا داعي لها في سياق الحديث. فمن هنا يكون في الجملة حذف لا بد من تقديره.
والحديث يدور في سياق إرشاد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا هشام ـ رضي الله عنه ـ إلى كيفية التعامل مع مـا يجمـع من الأموال، فهو ـ صلى الله عليه وسلم ـ يبين له ما ينبغي له أن يفعل فيـه. كأنـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول له: الشأن في ذلـك مقصور على اكتفائـك بشيئين: خادم ومركب، لا أكثر ولا أقل. «وما عدا ذلك فهو معدود عند أهل الحق من السرف، وتركه عين الشرف، وصرف النفس عن شهواتها حتى الحلال هو حقيقة تزكيتها، وقتلها إضناؤها إنما هو إحياؤها، وإطلاقها ترتع في شهواتها هو إرداؤها، ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾[الشمس: 9 ـ 10] والنفس مطية يقويها إضناؤها، ويضعفها استمتاعها، فعلى المؤمن رفع يده عما زاد على الكفاف، وتخليته لذوي الحاجة ليتخذوه معاشاً»([8]).
ومن هنا يبدو أنه حذف من هذه الجملة ضمير الشأن، وبذلك يكون القصر وقع بين أجزاء الجملـة الاسمية، قصر المبتـدأ (ضمير الشأن) على خـبره الجملـة الفعلية بأكملها (يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله). وهو قصر موصوف على صفـة، قصر الموصوف (الشـأن) على الصفـة (كونـه الاكتفاء من جمـع تلك الأموال بخادم ومركب في سبيل الله)، وذلك على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي، لأنـه أثبت صفـة للشأن وهي ما ذكـر، ونفى عنه غيرهـا من الصفات على وجه العموم، ثم إن الواقع هو كذلك، ينبغي أن يكون الشأن من جمع المال على الوجه المذكور.
هكذا ورد أسلوب القصر بإنما هنا في مقام الإرشاد والتوجيه، أرشد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلاله أبا هشام ـ رضي الله عنه ـ، بل الأمة كلها إلى الزهد في الدنيا والاقتصار فيهـا على قدر الحاجـة مما يصح أن يكـون زادا للآخرة، مؤكـدا أن الشـأن الذي ينبغي أن يلتزم به كل مسلم في جمع المال هو الاكتفاء بقدر الحاجة، الاكتفاء بخادم ومركب في سبيل الله مما يوصله لمقصده الغالي، وهو النعيم الباقي، نعيم الجنة، فإنه في الدنيا كالراحل إلى عالم آخر، عالم الحياة الآخرة الباقية، ليتمتع بما فيها من السعادةالخالدة، فينبغي له الاقتصار على قدر ما يصلح زادا لهذه الرحلة. وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث آخر: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ»([9]).
واختيار (إنما) هو الأليـق بهـذا المقام، لأن فيها ما ليس في غيرها من طرق القصر من زيادة التأكيـد والمبالغـة في الإرشاد إلى الزهـد في الدنيـا، حيـث أومـأ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خـلال اختياره هذا الطريق للقصر إلى أن ما يرشد إليه من شأنه ينبغي أن يكون واضحـا ومعلومـاً للمخاطب، وأنـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذكـره مع ذلك على سبيل التذكير والتنبيـه. ولو استخدم غيرهـا من الطرق مثل (النفي والاستثناء) لذهبت هذه المبالغة، وأصبح كأن ما يرشد إليه من الأمور الغريبة المنكرة من قبل المخاطبين، فيحتاج إثباته إلى قوة التأكيد والتقرير. والصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ في غاية الطاعة لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، كانوا حريصين كل الحرص على إرشاده ـ صلى الله عليه وسلم ـ، مُصغين إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسماعهم، فيكفيهم مجرد التنبيه والتذكير.
* * *
روى ابن ماجه بسنده عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: اضْطَجَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى حَصِيرٍ، فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله! لَوْ كُنْتَ آذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًايَقِيكَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «مَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟! إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»([10]).
* مقصود الحديث:
الحديث يهدف إلى تحقير أمر الدنيا وتهوين شأنها بجانب شأن الآخرة، فإنالدنيا دار الفناء، وإن الآخرة دار البقاء، وإن نعيم الدنيا قليل زائل، يشوبه الكدر، إذا سرَّ المرءَ فيهـا أمرٌ، ساءتـه أمورٌ، أما نعيم الآخـرة فسرور كلـه، لا نكـد فيـه ولا أحزان([11]).
* عناصر بناء الحديث:
ورد الحديث في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بجملتين كريمتين: جملـة استفهامية (مَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟!)؛ وجملة قصرية (إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا) صور ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها نظريته إلى الدنيا. وبذلك نفى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بكل تأكيد رأْيَ عبدِ الله ـ رضي الله عنه ـ الذي قالـه للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما ذكر في مقدمة الحديث (عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: اضْطَجَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى حَصِيرٍ، فَأَثَّرَ فِي جِلْـدِهِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله! لَوْ كُنْتَ آذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ!).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
وردت الجملة القصريـة (إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَـلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا) التي وقعت في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تأكيدا لنفيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قول المخاطب عبد الله ـ رضي الله عنه ـ له ـ صلى الله عليه وسلم ـ، عبر عبد الله ـ رضي الله عنه ـ فيه عن أسفه وألمه على ما تحملـه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الأذى في اضطجاعه، فتمنى لو كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبره بذلك، ففرش شيئـا على مكان اضطجاعه ـ صلى الله عليه وسلم ـ! ورأى أنه لو فعل ذلك لكان أحسن! وذلـك عندما رأى عبد الله ـ رضي الله عنـه ـ تأثـير الحصير الـذي اضطجع عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في جلده غاية التأثير (اضْطَجَعَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ)، فأصدر ذلك التمني، وقال ذلك القول (بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله! لَوْ كُنْتَ آذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ!)([12]) لشدة حبه له ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعدم قدرته على التحمل لرؤية أي أذى يمس صاحبه الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ . و(لو) هنا يحتمل أن تكون للتمني وأن تكون للشرطية. والتقدير: لو أخبرتنا ذلك فبسطنا لك فراشا لينا، لكان أحسن من اضطجاعك على هذا الحصير الخشن([13]). غير أن التمني هنا لم يكن على حقيقتـه، لأنـه لم يكن مراد القائل. بل هو قد خرج من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، فالمراد من وراء هـذا التمني هـو إظهـار الأسف والحزن على ما يراه.
نفى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله ذلك، واستبعده صراحة، حيث قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (مَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟!).
قال القاري ـ رحمه الله تعالى ـ: «(ما) نافية، أي ليس لي ألفة ومحبة مع الدنيا، ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتى أرغب إليها وأنبسط عليها وأجمع ما فيها ولذتها؛ أو استفهامية، أي ألفـة ومحبـة لي مع الدنيـا؟ أو أي شيء لي مع الميل إلى الدنيا أو ميلها إلي، فإني طالب الآخرة وهي ضرتها المضادة لها»([14]). وإذا كانت استفهامية، فلا تكـون على حقيقتهـا، بل هي خرجت إلى معناهـا المجازي، وهـو الاستبعاد والإنكار.
وبعد هذا النفي أو الرفض الصريح، أكد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك من خلال هذه الجملة القصرية (إِنَّمَا أَنَـا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَـا)، فصور لنا نظرته الزاهدة إلى الدنيا فأبدع فيه. مثّل ـ صلى الله عليه وسلم ـ شأنه مع الدنيا بمسافر استظل تحت شجرة، فهو لا يبقى في الدنيا كما أن المسافر لا يبقى تحت الشجرة، ثم ليست الدنيا همـه كما أن الشجرة ليست همَّ المسافر، وله مقصد سامٍ وهو الآخرة كما أن للمسافر غايةً يتوجه إليها.
قال الطيبي ـ رحمـه الله تعالى ـ: «أي: ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مستظـل، وهـو من التشبيـه التمثيلي، ووجه التشبيه سرعة الرحيل وقلة المكث، ومن ثم خص الراكب»([15]).
ويعلـق الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ على هـذا التمثيل بقوله: «فتأمل حسن هذا المثال، ومطابقته للواقع سواء، فإنها في خضرتها كشجرة، وفي سرعـة انقضائها وقبضهـا شيئًا فشيئًا كالظل، والعبـد مسافر إلى ربـه، والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها دارًا، ولا يتخذها قرارًا، بل يستظل بها بقدر الحاجة، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق»([16]).
هكذا «وقد كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأسوة المثلى والقدوة العظمى في نظرته إلى الدنيا، فلم يركن إليها، ولا يتعلق بها، بل كان شأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها كشأن الراكب المسافر الذي استظل في طريقـه تحت ظـل شجـرة، ثم قام يواصل سيره، فالدنيا أشبه بتلك الاستراحة العارضة، وكما أن المسافر ليس له هم إلا الوصول إلى غايته،وهي منتهى سفـره، فكذلك العاقل الموفق في الدنيا لا يتعلق بدنيا عارضة زائلة منشغلا عن النعيم الخالد في الآخرة»([17]).
قد برع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تصوير نظرته إلى الدنيا من خلال هذا التمثيل الرائع. وحرصا منـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على توضيح هذه الحقيقة، والرفع عنهـا كل شبهة، والإزالة عنها كل لَبْس، وعلى إيصال الخير لأمته وإنجائها من الوقوع في الغبن والخسارة، لم يكتف ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتمثيله هذا فحسب، بل قصر شأنـه مع الدنيا على هذا المشبه به، فكأنه ليس هنا مشبـه به غيره يمكن تصوير شأنهما هذا التصوير الرائع. ثم إن في وجـه الشبـه بين الطرفين كمالَ الوضوح ودقة التناسب حيث لا يخفى على أحد، أشار ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى ذلك من خلال اختياره طريق (إنما) لهذا القصر.
وقع القصر هنا بين أجزاء الجملة الاسمية، حيث قصر المبتدأ الضمير العائد إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع ما يعطف عليه (أَنَا وَالدُّنْيَا) على خبره (كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)، وبعبارة أخرى وقع بين طرفي التشبيـه، قصر المشبه على المشبه به. فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولا شبه حاله مع الدنيا بمسافر استظل تحت شجرة قليلا، ثم تركها ماضيا إلى مقصده، بجامع سرعة الرحيل وقلة المكث وزوال الخضرة كما سبق بيانه. ثم قصر المشبه المذكور على المشبه به المذكور، ونفى عنه غيره من المشبه به مبالغـة في تأكيد قوة هذه المشابهة، فكأنه ليس لـه إلا هذا المشبه به، ولا يصلح غيره لتصوير هذه المشابهة تصويراً كاملاً. وهذا القصر قصر موصوف على صفة، لأن المشبـه بـه كالصفة للمشبـه، فأثبت للموصوف المشبـه المذكور (أَنَا وَالدُّنْيَا) الصفة مشابهتها (راكِباً اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)، ونفى عنه غيرها من الصفات على سبيل المبالغة، فواضح أنه من قبيل القصر الحقيقي المبني على المبالغة، وفيه مبالغة في إثبات هذا التشبيه وتأكيده، وتوضيح مدى حقارة متاع الدنيا الفانية بإزاء نعيم الآخرة الخالدة.
هكذا وظّف ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسلوب القصر بإنما هنـا في مقـام نفيه أسى المخاطب وحزنـه عليـه، مؤكـدا بذلك على زهده فيما تمناه المخاطب، مبيناً نظرته الثاقبة إلى حقيقة الدنيا. وبذلك علّم الأمة قولاً وفعـلاً كيفيـة النظر إلى الدنيا، وضرب لنا خير مثال على عدم الركون إلى متاع الدنيا، فإن الدنيا هي الممر المؤدي إلى الآخرة التي هي المستقر الدائم، وإنها إنما تكون مزرعة للآخرة وليست دار خلود وبقاء، وإنها دار الامتحان والابتلاء، والآخرة هي دار الجزاء.
وقد وفّق ـ صلى الله عليه وسلم ـ في اختياره طريق (إنما) لهذا القصر، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال ذلك نبّه المخاطب على كمال وضوح وجه الشبه في التمثيل الذي صور من خلاله شأنه مع الدنيا ليزيل مـا في قلب المخاطب من الأسى والحـزن كما سبق تحليلـه. ففي هذا التنبيه نوع من التعليل لعدم الحاجة إلى ذلك الأسى، لأنه من المعلوم أن الدنيا مجرد الممر المؤدي إلى المستقر الدائم، فينبغي ألا يكون التنعم بما فيها هدف المؤمن. هكذا علّم ـ صلى الله عليه وسلم ـ مخاطبه مع الأمة كلها بأسلوبه الرقيق في هدوء تام كيف يتعامل المؤمنون مع متاع الدنيا.
* * *
روى ابن ماجـه بسنده عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَـهُ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: «إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ»([18]).
* مقصود الحديث:
المقصود من الحديث الشريف هـو بيـان أن قيمـة الإنسان فيما قدمـه مـن الأعمال الصالحة وفيما يحوي في قلبه من نية، وبذلك تكون درجته عند الله ـ تعالى ـ، وأن الصور والأموال لا تنفعـه شيئاً عنـده ـ تعالى ـ، حثاً للأمـة على الإقبال على تقديم الأعمال الصالحة وإحسان النيات الصادقة، ونهيـا لهـم عن التفاخـر بكثرة الأموال وجمال الصور، وعن تحقير أخيهم المسلم لمظهـره أو مهنتـه أو ضعفـه أو فقره([19]).
* عناصر بناء الحديث:
جاء الحديث الشريف في جملتين كريمتين لتحقيق هـذا المقصد الغالي، نفى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الأولى منهـا أن الصور والأموال تنفـع الإنسان عنـد الله (إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ)، وقرر وأكد في الثانية على أن الذي ينفع الإنسان عند الله هو الأعمال والقلوب (وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ).
* أسلوب القصر في الحديث وعناصر بنائه:
ورد أسلوب القصر بإنما في الجملة الثانية المؤكدة على أن الذي ينفع الإنسان عند الله هو الأعمال والقلوب (وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ)، فقـد سبق بنفي صريح مؤكد، نفى فيه أن يكون للصور والأموال نفع للناس عند الله (إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ). وباعتبار ما في القصر من معنى النفي والإثبات، نفى في هذه الجملة القصرية ضمنيا أن يكون نظر الله ـ تعالى ـ إلى الصور والأموال حين قصر النظر على الأعمال والقلوب. فكأن هذه الجملة القصرية بما فيها من هذا النفي الضمني مؤكـدة لمفهوم الجملة الأولى، لكنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع ذلك قد عطف بين الجملتين بالواو إشارة إلى ما بين الصور والأموال وبين الأعمال والقلوب من فرق كبير وبون شاسع، إذ الأعمال والقلوب محل النظر والاعتبار عند الله ـ عز وجل ـ، وبذلك ينال الناس درجاتهم عند ربهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. أما الصور والأموال مهما يكن جمالهـا وكثرتها فإنها لا نصيب لها عند الله، ولا تنفع أصحابها شيئاً عند ربهم ـ عز وجل ـ، لأنها ليست محل النظر والاعتبار عند الله ـ عز وجل ـ،لأن صورهم «ليست من كسبهم حتى ينظـر الله إليهـا، وأموالهم إنما هـي عرض زائل»([20]). وكأن بعد النفي الصريح في الجملة الأولى أن يكون محل النظر الصور والأموال، وضح إلى حدما أن محل النظر هو شيء آخر غير الصور والأموال، وهي الأعمال والقلوب، إذ من المعلوم أن قيمـة الإنسان فيما قدمه من الأعمال النافعة، وأن اعتبار الأعمال بما ينطوي في قلوب أصحابها من النيات، فإنما الأعمال بالنيات. ولهذا جاء القصر بطريق (إنما) لتأكيد هذا الوضوح أو الشهرة.
وبهذا القصر أكـد ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنا حقيقة التقوى، وأنها «تحصل في القلب، وما يظهر من الجوارح قـد يكون دليلا على وجودها، وقد يكون رياء ونفاقا، فالعبرة عند الله بما في القلب»([21]). وفي حديث آخـر أشار ـ صلى الله عليه وسلم ـ إشارة صريحة إلى أن محل التقوى هو القلب، وتأكيداً على ذلك كرره ثلاث([22]).
القصر هنا وقع بين أجزاء الجملـة الفعليـة، حيث قصر الفعل الصادر من فاعله (يَنْظُرُ) على الجـار والمجرور (إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ). ويكون القصر قصر موصوف على صفة، بمعنى قصر الموصوف (نظره ـ سبحانه وتعالى ـ) على الصفة (كونه متعلقاً ومتوجهاً إلى الأعمال والقلوب)، ونفى عنه تعلقه وتوجهه إلى الصور والأموال، فيكون هـذا القصر على سبيل القصر الإضافي للإفراد، ليؤكـد النفـي الوارد في الجملة السابقة (إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ)، ويزيل ما قد يكون في بعض النفوس من الوهم أن ما لـه من الصور الجميلـة والأموال الكثيرة تنفع له عند الله ـ عز وجل ـ كما تنفع الأعمال والقلوب. فقرر وأكد له أن النظر متعلق بالأعمال والقلوب، ومقصور عليه، ولا تشاركه الصور والأموال.
ويحتمل أن يكون هذا القصر قصراً حقيقياً تحقيقياً، فيكون قصر النظر على تعلقه بالأعمال والقلوب، ونفى عنه تعلقـه بجميع ما عداهـا، بما تدخل في ذلك الصور والأموال. وهذا النفي الضمني العام نفى تعلق النظر بالصور والأموال، وبذلك أكد مفهوم الجملة السابقة أيضاً. وهذا القصر مبني على أن النظر هنا بمعنى نظر المحاسبة والمجازاة والإثابة، وإلا فإن نظره ـ تعالى ـ محيط بكل شيء.
قال القاضي عياض ـ رحمـه الله تعالى ـ: «نظـر الله هنـا هو رؤيـة الله لذلك ليجازي عليه ويثيبه، ونظر الله ورؤيتـه محيطة بكل شيء، وإنما المراد من ذلك هنا بالتخصيص ما يثيب عليه ويجازي من ذلك، فكل هذا إشارة إلى النيات والمقاصد، وأن المجازي عليه ما كان للقلب فيه عمل من قصد ونية وذكر»([23]).
وقال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: «إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقـع في القلب من عظمة الله ـ تعالى ـ وخشيتـه ومراقبتـه. ومعنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسبتـه، أي: إنما يكون ذلـك على ما في القلب دون الصور الظاهرة، ونظر الله رؤيته محيط بكل شيء»([24]).
وقـال السنـدي ـ رحمـه الله تعالـى ـ: «أي: فأصلحـوا أعمالكم وقلوبكم، ولا تجعلوا همتكم متعلقـة بالبدن والمال، ولعـل المرادَ بالنظـر وعدمه أنه لا يقبل المرءَ ولا يقربه بحسن الصورة وكثرة المال، ولا يرده بضد ذلك، وإنما يقبله بحسن العمـل وخلوص القلب، ويرده بضـد ذلـك، وإلا فكل شيء لا يغيب من نظره ـ تعالى ـ، والله أعلم»([25]).
هكـذا ورد أسلوب القصر بإنما هنـا في مقـام الحـث على العمـل والتقوى وإخلاص النية لله ـ عز وجل ـ، والنهي عن احتقار الآخرين. فالحديث بهذا القصر الموجز مع ما سبقه من جملة مؤكدة أكد على أن الصور والأموال لا تنفع أصحابها عند الله ـ عز وجل ـ، وأن الذي ينفعهم عنـده ـ تعالى ـ هو ما قدموه من الأعمال ومـا يطـوي في قلوبهم من حسن النيات. وبذلـك حثهم على الإقبال على تقديم الأعمال الصالحة بالنيات الحسنـة، حتى ينالـوا رضـا الله ـ عز وجل ـ، ويفـوزوا بدرجات رفيعـة، ونهاهم ضمنيا عن احتقار الآخرين لمظهـره أو فقـره. وقد قرر الإسلام أن من حق المسلـم على المسلـم عدمَ الاستهانة به، وعدم تحقيره، وعدم الاستخفاف بـه، ولـو كان فقيراً مغموراً، فرُبَّ أشعث أغبر هو عند الله خير ممن له مظهر العز والجاه والسلطة، فإن الله ـ تعالى ـ لا ينظر ولا يحاسب على المظاهر، ولا ينظر إلى كثـرة الأموال، وإنما يعتمد القلوب وما في القلوب، وما قدمه من الأعمال الصالحة بالنية الخالصة الحسنة([26]).
واستخدام (إنما) هو الأنسب لهـذا المقام، لأن القصر قـد سبق بجملة نفى فيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ صريحاً أن يكون نظر الله ـ تعالى ـ إلى الصور والأموال، وبهذا قد قرب مفهوم القصر ووضح إلى حد كبير، فناسب استخدام طريق (إنما) الذي يفيد هذا الوضوح كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أثناء التحليل السابق.
* * *
روى ابن ماجـه بسنـده عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ قَالَ الزُّبَيْرُ: وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ وَإِنَّمَا هُوَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، قَالَ (أي: النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ): «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ»([27]).
* مقصود الحديث:
مقصود الحديث هو بيـان أن الإنسان يسأل عن شكر النعم التي أنعم الله بها عليهم.
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هذا المقصد جاء الحديث على شكل الحوار الجاري بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصاحبه الزبير ـ رضي الله عنه ـ، وذلك أنه لما نزلت الآية ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ قال الزبير ـ رضي الله عنـه ـ للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ وَإِنَّمَا هُوَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ). وفي قوله هذا استبعد عن أنفسهم السؤال الوارد في الآية (وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟)، ثم أكد هذا الاستبعاد من خلال بيان حالهم (وَإِنَّمَا هُوَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ). فقـال لـه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ) مؤكدا أنهم سيسألون.
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما في قول الزبير ـ رضي الله عنه ـ (وَإِنَّمَا هُوَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ) مؤكدا به على استبعاده عن أنفسهم السؤال المتوعد به الوارد في الآية،حيث إنه قاله لما نزلت الآيـة ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾[التكاثر: 8]. والآية جاءت في سياق الوعيـد والتهديد من الله ـ عز وجـل ـ لمن ألهاهـم حرصهم على تكثير أموالهم عن طاعة ربهم وشكره على نعمه التي أنعم بها عليهم، أكد ـ سبحانه وتعالى ـ في هـذه الآيـة على أنـه ليسألنّ عباده عن شكـر ما أنعـم به عليهم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك([28]).
قيل: إن هذا السؤال يعـم جميع العباد مؤمنين كانوا أو كافرين، وقيل: إنه مخصوص بالكافرين([29]). فالمؤمنون يسألون سؤال إكرام وتشريف، لأنهم شكروا ما أنعـم الله بـه عليهم، وأطاعوا ربهم، فيكون السؤال في حقهـم تذكرة بنعم الله عليهم؛ والكافرون يسألون سؤال توبيخ وتقريع، لأنهـم تركوا شكر ما أنعم الله به عليهم([30]).
ثم المراد بالنعيم المسؤول عنـه، كما قـال أبو السعود ـ رحمه الله تعالى ـ إنـه «النعيم الذي ألهاكـم الالتـذاذ عن الدين وتكاليفـه، فإن الخطاب مخصوص بمن عكف همته على استيفاء اللذات ولم يعش إلا ليأكـل الطيب ويلبس اللين ويقطع أوقاته باللهو والطرب لا يعبأ بالعلـم والعمل ولا يحمل نفسه مشاقهما، فأمـا من تمتع بنعمة الله ـ تعالى ـ وتقوى بها على طاعته وكان ناهضا بالشكر فهو من ذلك بمعزل بعيد»([31]). وقال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ: «أي: ثـم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم، من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك»([32]). وقال أبو حيان ـ رحمه الله تعالى ـ: «الظاهر العموم في النعيم، وهو كل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب، فالمؤمن يسأل سؤال إكرام وتشريف، والكافر سؤال توبيخ وتقريع»([33]).
وقد ذكر بعض المفسرين أقوال أهـل التأويل في ذلك النعيم([34]) منها: شبع البطـون وبارد الشـراب ولـذة النوم وإظلال المساكن واعتدال الخلـق؛ أو الأمن والصحة والفراغ؛ أو الصحة وسائر ملاذ المأكول والمشروب؛ أو الانتفاع بإدراك السمع والبصر؛ أو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن؛ أو الماء البارد؛ أو العافية؛ أو الزائد مما لا بد منه من مطعم وملبس ومسكن أو جميع النعم.
استبعد الزبير ـ رضي الله عنه ـ هذا السؤال عن أنفسهم وأنكر وقوعه عليهم (وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟)، ولتأكيد استبعاده هذا أورد جملته الثانية بأسلوب القصر (وَإِنَّمَا هُوَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ) مبينا فيها حالهم البسيطة، وهو أن النعيم عندهم مقصور على الأسودين: التمر والماء. وكل يعرف ذلك، فكيف يسألهم الله ـ تعالى ـ عن النعيم. وذلك على أساس الظن منه أن الله ـ تعالى ـ يسألهم عن النعيم العظيم الكـبير، ولا يسـأل عن هذيـن لدناءتهما([35]). فكأنـه خصص النعيـم الـوارد فـي الآية بالنعيم العظيم الكبير، وأخرج منه ما لا بد منه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن.
نظرا لتأكيده على هذا الاستبعاد نبهه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأكد له في قوله (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ)، «هـذا يحتمل وجهين: أحدهمـا أن النعيـم الذي تسألون عنه سيكون، والثانـي أن السؤال سيكـون عن الأسودين، فإنهما نعمتـان عظيمتان من نعم الله ـ تعالى ـ .»([36])فالوجـه الأول على أساس أن النعيم في الآية خاص «بالفضل عن الأسودين مما يتجاوز ما تَقوم أنفسُهم به, وأنهم غير مسئولين عما لا تقوم أنفسهم إلا به»([37]). والوجـه الثاني على أساس أن النعيم في الآيـة عام يشمل جميع نعم الله ـ تعالى ـ، وقـد رجحـه كثير من العلماء([38]). فعلى الوجه الأول يكون قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ) تبشيرا للمخاطبين بأنه ستكون لهم عظيم النعم وخيرها؛ وعلى الوجه الثاني يكون هـذا القول قلبا لاعتقادهم، وتقريرا لهم أنهم يسألون عن كل ما أنعم عليهم، كبيرها وصغيرها.
وقـع أسلوب القصر هنا بين ركني الجملـة الاسمية، فقصر المبتدأ الضمير العائد إلى النعيم (هو) على خبره (الأسودان) المفسر بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (التَّمْرُ وَالمَاءُ). وهذا القصر قصر صفة على موصوف، إذ الضمير العائد إلى النعيم (هو) هنا بمثابة الصفة، فقصر الصفة (النعمة) على (الأسودين: التمر والماء)، ونفاها عن غيرهما على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي، إذ إن النفي فيه على وجه العموم. وكأن هذاالنفي مبني على ظنهم أن النعيم المقصود هو نعيم المطعم والمشرب، وأن ما يسأل منـه عن شكره يوم القيامـة هو الرزق الواسـع الكبير من المطعم والمشرب، وإلا فإن ملبسهم وصحتهم وغير ذلـك كذلك من النعيم الذي أنعمهم الله ـ تعالى ـ . أو نقول إن القصر هنـا مبني على المبالغـة والادعاء، كأنـه يقول: إن أكبر ما نحن فيه من النعم هو مقصور على هذين، فكيف نسأل عن النعيم يوم القيامة؟ وليس لنا ما نسأل فيه.
أطلـق الأسودان على التمـر والمـاء، وذلـك كما قال ابـن الأثير ـ رحمه الله تعالى ـ: «أما التمـر فأسود وهو الغالب على تمـر المدينة، فأُضيف الماء إليه ونعت بنعته اتباعا. والعـرب تفعـل ذلـك فـي الشيئين يصطحبان فيسميان معـا باسـم الأشهر منهما، كالقمرين والعُمَرين»([39]).
وهنا شارك هذا الأسلوب الذي يعتبر لونـا من ألوان التأكيد والتقرير فن آخر من فنون البلاغـة، فزاد في تأكيد المعنى وتقريره، حيث جاء المقصور بضمير لميكن ينص ما يعود إليه هذا الضمير، فيكون فيه شيء من الإبهام مما يثير النفوس إلى معرفة الحقيقة. ثم أوضح ذلك الإبهام بالمقصور عليه، غير أنه لم يكن يفسره في دفعة واحدة، بل تعمد إلى تفسيره من خلال دفعتين اثنتين: (الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَـاءُ) حيث أتـى بمثنى مفسـر باسمين. وهـذا ما يسمى عنـد البلاغيين باسم التوشيع، وهو نوع من أنواع الإيضاح بعد الإبهام الذي هو لون من ألوان الإطناب، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول من هذا البحث([40]). هكذا جمع بين الإطناب والإيجاز في جملتـه القصريـة، توضيحا لحالهم البسيطة، وتأكيدا لنفيه أن يكونوا من ضمن المسئولين المقصودين في الآية.
هكذا ورد أسلوب القصر بإنما هنـا في مقـام الاستبعاد، وتظاهـر بعناصره مع ما يمتزجه من ألوان البلاغة وفنونها على تحقيق المقصد الذي يرمي إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، حيث قصر فيه قائلوه ما هم فيه على التمر والماء، ونفوا عن أنفسهم غيرهما من النعـم التي يسألون عنها يوم القيامـة. وبذلـك استبعدوا أن يكونوا هم من المسؤولين.
وقد وفّق الزبير ـ رضي الله عنه ـ في إيثاره طريق (إنما) على غيره من طرق القصر، وذلك لأن فيـه إشارة إلى أن ما ذكر من أن ما عندهم مقصور على التمر والمـاء، ولا يتعداهمـا إلى غيرهمـا أمر معروف واضـح من أحوالهـم، ولا يخفـى على من يعيش بجانبهم، فضـلاً عن الذيـن يلازمونـه دائماً. فكيـف يقع السؤال الوارد في الآيـة عليهم، إذ لبساطة حالهم ليس لهـم النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة.
* * *
روى ابن ماجه بسنده عن أَبي عَبْدِ رَبٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ كَالوِعَـاءِ، إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ»([41]).
* مقصود الحديث:
مقصود الحديث هو إرشاد الأمـة إلى التوقّي على العمل بالخوف عن رده، وترك ما يؤدي إلى بطلانه([42])، وإلى المحافظة على الأعمال بإصلاح النيات كما ورد في الحديث المشهور: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...»([43]).
* عناصر بناء الحديث:
ورد الحديث في ثلاث جمـل لتحقيق هـذا المقصـد: شبـه النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الأولى منها الأعمال بالوعاء (إِنَّمَا الأَعْمَالُ كَالوِعَاءِ)، ثم بين وجه الشبه في الجملتيناللاحقتين (إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ).
* أسلوب القصـر فـي الحديـث ـ عناصـر بنائـه ـ وعلاقاتـه بغيره مـن عناصـر الحديث:
وقـع أسلوب القصـر بإنـما في الجملـة الأولى مـن الحديـث (إِنَّمَا الأَعْـمَالُ كَالوِعَاءِ)، شبه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الجملة الأعمال بالوعاء، موضحا شأنها للأمة بكـل وضوح، ومبينا لهم أن العبرة فيها بالجواهر والخواتيم لا بالظواهر. ثم بالغ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا التوضيح، حيث قصر المشبه على المشبه به، كأن هذا المشبه به هو الوحيد الصالح لتوضيح شأن الأعمال به، فعندما ذكرت الأعمال لا ينصرف الذهن إلا إلى هذا المشبه به، وهو الوعاء.
وزيادة للمبالغـة في تأكيد ذلك جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كون الأعمال مقصورة على صفة المشابهة للوعاء أمرا واضحا معلوما. أشار ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى هذا الوضوح من خلال إيراده القصر بطريق (إنما).
وحرصا من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على إيصال بيانـه للأمة بصورة أكثر وضوحاً، لم يكتف ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهذا القدر من المبالغة والتأكيد، بل لجأ إلى جملتين أخريين (إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ)، مبيناً فيهما وجه الشبه بين الأعمال والوعاء بكل وضوح. وقد وضحه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال إقامة المقارنة بين نتيجة طيب أسفل الوعاء ونتيجـة فساد أسفل الوعـاء، إذ إن أعلى الوعاء طاب بطيب أسفلـه، وفسد بفساد أسفلـه. كذلـك شأن الأعمال، فإنهـا تُقيَّم بقيمـة جوهرها وخاتمتهـا. وكأن في ذلك «إشارة إلى ما قيـل إن كل إنا