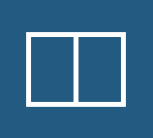مواقع إنما وأسرارها في أبواب الحديث عن اللقطة من سنن ابن ماجه
مواقع إنما وأسرارها في أبواب الحديث عن اللقطة من سنن ابن ماجه
كتب عن هذا الموضوع الكاتب الصيني ماشياومينغ في كتاب ( إنما وأسرارها البلاغية في سنن ابن ماجه ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة ( 1439هـ - 2018م)
فقال:
روى ابن ماجـه بسنـده عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِـدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ»([1]).
* مقصود الحديث:
المقصود من الحديث الشريف هـو بيان حكم التقاط الضالة أو اللقطة([2])، وما يفعل فيها إذا التقطت.
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هذا المقصود جاء الحديث على شكل السؤال والجواب، مكونا من ثلاثة عناصر رئيسية: العنصر الأول: بيان حكم التقاط ضالة الإبل (سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِالإِبِلِ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا لَـكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».)؛ والعنصر الثاني: بيان حكم التقاط ضالة الغنم (وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ».)؛والعنصر الثالث: بيان حكـم التقـاط اللقطة (وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ».).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما في العنصر الثاني من الحديث الشريف، الذي بين فيـه حكم التقاط ضالـة الغنم (فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)، ووقع موقع التعليل للأمـر بالتقـاط ضالة الغنم حيث إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن حكم التقاط ضالة الغنم، فأجـاب ـ صلى الله عليه وسلم ـ آمـرا بالتقاطهـا (خُذْهَـا) معلـلا لـه بهـذه الجملـة القصرية.
وإنما احتاجت الإجابة إلى هذا النوع من التعليل لأن هذا السؤال جاء بعد سـؤال آخـر سئـل فيـه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن حكـم التقـاط ضالة الإبل، وقد أجاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ذلك السؤال بأسلوب مؤكد، يؤكد نهيه عن التقاطها من خلال الاستفهام الإنكاري (مَا لَـكَ وَلَهَـا؟)، أي: لم تأخذهـا ولم تتناولهـا؟ ثم التعلـيل والاستدلال للنهي (مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ المَـاءَ وَتَأْكُـلُ الشَّجَـرَ حَتَّى يَلْقَاهَـا رَبُّهَا).
ثم جاء السؤال الثاني سئل ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه عن حكم التقاط ضالة الغنم، صرح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في إجابته الأمر بالتقاطها، ثم علل كذلك هذا الأمر لبيان وجه التفريق بين حكم ضالة الإبل وحكم ضالة الغنم، ولدفع وهم من يتوهم أن الحكم فيهما واحد.
وفي تعليله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا قصر مصير ضالة الغنم على واحد من الثلاثة: (فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)، «وهذا على سبيل السبر والتقسيم، وأشار إلى إبطال قسمين فتعين الثالث، فكأنه قال: ينحصر الأمر في ثلاثة أقسام: أن تأخذها لنفسك أو تتركها فيأخذها مثلـك أو يأكلهـا الذئب، ولا سبيـل إلى تركهـا للذئب، فإنـه إضاعة مال، ولا معنى لترك السابق واستحقاق المسبوق. وإذا بطل هذان القسمان تعين الثالث، وهو أن تكون لهذا الملتقط»([3]).
وعبر عن القصر بطريق (إنما) خاصة للإشارة إلى أن كون مصير ضالة الغنم منحصرًا في ذلـك أمر معلوم واضح، وذلك لأنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو ملتقط آخر، أو يأكلهـا السباع لضعفها وعدم استقلالها بأسباب تعيشها([4]).
وإذا كان الأمر هكذا، فلم لا يلتقطها من وجدها؟ لأن عدم التقاطها يؤدي غالبًا إلى أن تكون طعمة للذئب إن لم يتفق ملتقط آخر، لأنها لا تحمي نفسها. وفيه حث لمن وجد ضالة الغنم أو غيرها من الضوال الضعيفة على أخذها حفظًا لحق صاحبها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان أدعى له إلى أخذها([5]).
ومن هنا نرى أن في إجابة السؤال قدرا من الوضوح، ولهذا السبب غضب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما سئل في السؤال الأول عن حكم ضالة الإبل، واحمرت وجنتاه الكريمتان (سُئِـلَ عَنْ ضَالَّـةِ الإِبِلِ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَـاهُ)، وواجه السائل بسؤال إنكاري فيه نوع من التوبيخ، يوبخه على سؤاله مع أن من المعلوم أن ضالة الإبل غالبًا تقوي على الحفاظ على نفسها، ولا تتعرض للضياع أو الهلاك، لأن معها أخفافهـا التي تقوي بها على السير وقطع المفاوز، وتقوي على ورود المياه لتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيهـا الأيام([6])، (مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا).
نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التقاط ضالة الإبل التي تستغني عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من القوة على القطع والجلادة على العطش، والقدرة على تناول المأكول، ومصونـة بالامتناع عن أكثـر السباع([7]). والإبـل مثل من الأنعام التي تقوي على الحفاظ على نفسها وتأمـن من الضياع؛ وأمر ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتقاط الغنم الذي يتعرض للخطر بسبب ضعفـه، والغنـم مثل من الأنعام التي تتعرض للضياع أو الهلاك. وذلـك النهي أو هذا الأمر لم يكن إلا لأجل المحافظة على الملكية الفردية، وعدم الاستيلاء عليهـا، وحمايـة أموال الناس من الضياع أو الهلاك، هـذه هي حكمـة مشروعية التقاط الضالة أو اللقطة. وهكذا يرسم لنا هذا الحديث الشريف «طريق التكافل الاجتماعي، وأن المسلمين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا، وأن على المؤمن إذا وجد شيئًا ضائعًا من صاحبه أن يحميه من نفسه الأمارة بالسوء التي بين جنبيه، الطامعة فيه، وأن يلتقطه ليحفظه لصاحبه، ليس هذا فحسب، بل يجب عليه أن يعلن عنه في مكان التقاطه، وفي الأسواق وفي أماكن اجتماع الناس سنة كاملة على الأقل»([8]).
ولأجل هذا أجاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على السؤال الثالث عندما سئل عن حكم التقـاط اللقطـة مبينـا في إجابتـه ما يجب أو يستحب على الملتقط عمله (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ.). هنـا أمـر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الملتقط بشيئين: معرفة عفاص اللقطة ووكاءها ([9])؛ وتعريف اللقطة لمدة سنة. وما ذلك إلا لأجل حفظها، وعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط بماله ويشتبه([10]).
والقصر هنا وقـع بين أجـزاء الجملـة الاسميـة حيث قصر المبتدأ الضمير العائد على ضالة الغنم (هِيَ) على الجار والمجرور الواقعين موقع خبر المبتدأ (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ). وفي التعبير بالجملـة الاسميـة مـا لا يخفى من دلالـة على الثبوت والدوام، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يؤكد على أن مصير ضالـة الغنم منحصر في هذه الثلاثة، وهذا أمر ثابت لا يخالف فيه غالبا. وهذا القصر من قبيل قصر الموصوف على الصفـة، قصر الموصوف الضمير (هـي) على صفة كونها (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)، وذلك على سبيل القصر الحقيقي المبني على المبالغة، لأن كون ضالة الغنم للملتقط الذي وجده أولا، أو للملتقط الآخر، أو للذئب، مبني على حكم الأغلبية، إذ الأمر غالبا يكون كذلـك، ولم يكن ذلك على وجه التحقيق، لأنها قد لا تكون لهؤلاء الثلاثة، وقد ترجع إلى صاحبها دون تعرض للضياع أو الهلاك، غير أن هذا نادر الوقوع، فلم يعتد به، مبالغة في الحرص على حفظها من الضياع والهلاك.
الضمير المقصور يعـود على ضالـة الغنـم، غير أنه يشمل لكل ما يتعرض للضياع أو الهلاك من ضوال الأنعام الضعيفـة. والمراد بأخيك ملتقط آخر مثل الملتقط الأول؛ أو صاحبها؛ أو ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس مـا يأكـل الشاة ويفترسهـا من السباع، وذكـره على سبيـل المثال، لا القيد. وكلمة (أو) فيه للتقسيم والتنويع([11]).
هكـذا جـاء أسلوب القصر بإنما هنـا في مقـام الإجابـة على السؤال، فأكد ـ صلى الله عليه وسلم ـ به إجابته معللا لها ومستدلا عليهـا، ومنبهـا به «على جواز التقاط ضالة الغنـم وتملكهـا، وعلى ما هو العلـة وهو كونهـا معرضة للضياع ليدل اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعية بغير راع والتحفظ عن صغار السباع»([12]). وفي الحديث الشريف عناصره وتراكيبـه وألفاظـه تتجلى روح الإنسانيـة الغاليـة وحكمة الشريعة الإسلامية الجليلـة. ومن خلال التفريق بين حكم التقاط ضالةالإبل وضالة الغنم مع بيان سبب التفريق، ثم التنبيه على ما يعمله ملتقط، عرض لنـا مدى حـرص الإسلام على حفظ الملكية الفرديـة وعلى التعاون بين المسلمين للمحافظة على أموال الناس من الضياع أو الهلاك. وفي النهاية قرر للأمة أصلا من أصول الشريعة الإسلامية العظيمـة، وهو أن مشروعية الالتقاط إنما لأجل حفظ الأموال لصاحبها من الضيـاع أو الهلاك، فيلتقط مـا يتعرض للضياع أو الهلاك، ويترك ما لا يتعرض لذلك. ما أحكم تشريع الحكيم الخبير!
وبالتحليل الذي مضى تبين لنا أن استخدام (إنما) هو الأليق بهذا المقام، لأن مضمون القصر هنـا واضح لا يحتاج إثباتـه إلى مثل ما في (النفي والاستثناء) من قوة التأكيد، وقد أثبته هنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهذا الأسوب الرقيق الهادئ تعليلا لأمره بالتقاط ضالة الغنم كما وقفنا عند ذلك في أثناء التحليل.
* * *
روى ابن ماجه بسنده عَنِ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ خَـرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى البَقِيعِ ـ وَهُوَ المَقْبَرَةُ ـ لِحَاجَتِـهِ، وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُـمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَـرُ الإِبِلُ، ثُمَّ دَخَـلَ خَرِبَةً، فَبَيْنَمَا هُـوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، إِذْ رَأَى جُرَذًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ دَخَلَ، فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَـرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ. قَالَ المِقْـدَادُ: فَسَلَلْتُ الخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا، فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَـارًا، فَخَرَجْتُ بِهَـا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ الله لَكَ فِيهَـا»، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟» قُلْتُ: لَا، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ. قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ([13]).
* مقصود الحديث:
المقصود من الحديث الشريف هـو بيان أن ما أخرجت الطيور أو حشرات الأرض من مال فحكمـه حكم اللقطـة، وأن ما أخـذه الإنسان نفسه من الحجر فحكمه حكم الركاز([14])، وبيان مـا يتحلى بـه المقـداد ـ رضي الله عنه ـ من مكارم الأخلاق([15]).
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هذا المقصود جاء الحديث بمجموعة من الجمل، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة عناصر رئيسية: العنصر الأول: مقدمة ذُكِر فيها حـدثٌ حَدَثَ للمقداد ابن عمرو ـ رضي الله عنه ـ بينما هو جالس عند البقيع لقضاء حاجته، وهو إخراج جُرَذٍ ثمانية عشر دينارا أمامه (أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى البَقِيعِ ـ وَهُوَ المَقْبَرَةُ ـ لِحَاجَتِهِ، وَكَـانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِـهِ إِلَّا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، إِذْ رَأَى جُرَذًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ دَخَلَ، فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ. قَالَ المِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ الخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا، فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا.)؛ والعنصر الثاني: ذكر الحوار الجاري بينه وبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما أتى إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لإخراج زكاة هذه النقود (فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ الله لَـكَ فِيهَـا»، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْـرِ؟» قُلْتُ: لَا، وَالَّذِي أَكْرَمَـكَ بِالحَقِّ.)؛ والعنصر الثالث: إشارة إلى أن آخر هذه النقود لم يفن حتى مات المقداد ـ رضي الله عنه ـ (فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَـا حَتَّى مَاتَ)، وذلـك ببركة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث دعا له فيها (بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا)، وهذه معجزة من معجزات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما (فَإِنَّمَا يَبْعَـرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِـلُ) معترضـا في العنصـر الأول مـن الحديث الشريف، ووقع موقـع التوضيح والتأكيد، حيث سبق بذكر قلـة ذهابهم في قضاء الحاجة، ولم يكن إلا مرة في اليومين أو الثلاثة (وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ)، فوضح في هـذا القصر هذه الحالة وأكدها. لذا جاءت الجملة القصرية مبتدئة بفاء السببية.
جاء راوي الحديث بهذه الجملة الاعتراضية (وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِـلُ.) لبيان ما كـان عليـه الناس في ذلك الزمن من شدة الفقر، فذكر فيها مظهرا من مظاهر هذا الفقر،وهو قلة ذهابهم في قضاء الحاجة، وكان مرة في اليومين أو الثلاثة، فهم يقضون الحاجة كما تعبر الإبل، وذلك لقلة غذائهم ويبوسته([16]).
وهنا أكد الراوي قوله بأسلوبي القصر: أسلوب في تأكيد قلة ذهاب الناس في قضاء حاجتهم (لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) مستخدما فيه طريق النفي والاستثناء؛ وآخر في توضيح هذه الحالة وتأكيدها (فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ) مستعملا فيه طريق (إنما).
عبر الراوي عن القصر الأول بطريق النفي والاستثناء لتأكيد مفهوم القصر وتقريره، وهذا المفهوم هـو قلـة ذهابهم في قضاء الحاجة، فقد قصر ذلك على مرة في اليومين والثلاثة. وهذا أمر مخالف العادة نادر الوقوع، لأن قضاء الحاجة غالبا لا يبلغ إلى هذه الدرجة من القلة. فإثباته يحتاج إلى مزيد من التأكيد والتقرير، لذلك استخدم فيه طريق النفي والاستثناء الذي يستعمل غالبًا في الأمور الخفية النادرة،والذي يفيد مزيدا من التأكيد والتقرير.
أما في التعبير عن القصر الثاني فقد جاء بطريق (إنما) الذي يستعمل غالبا في الأمور الواضحـة الكثيرة الوقوع، وذلك لأن مفهومه بعدما سبقه القصر الأول يكون كأنـه واضح يظهـر في الذهن اليقظ. فبسبب قلـة ذهابهم في قضاء الحاجة يكون تشبيه قضائهم للحاجة ببعر الإبل أمرًا واضحًا، لذلك جاءت هذه الجملة القصرية مقترنة بفاء السببية. شبه قضاءهم للحاجة ببعر الإبل بجامع قلته ويبوسته، ثم قصر المشبه على المشبه به لزيادة التأكيد.
وجاء بهذه التأكيدات لبيان ما هم عليه من شدة الفقر. وللسائل أن يسأل: ما علاقة هـذا البيان مع مقصود الحديث؟ كأنـه في الظاهـر لا شيء يربط بينهم، غير أننا إذا أمعنّا النظر في سياق الحديث نجد أن هذا البيان لم يأت فضـلًا، بل له دور في تحقيق مقصود الحديث الشريف. وذلـك أن هـذه الجملة الاعتراضية من خلال بيانهـا لأحـوال الناس حينئـذ وتأكيد شدتهـا، أكدت لنا مدى ورع المقداد ـ رضي الله عنه ـ وزهده وأمانته، حيث إنه ذهب بما وجد من النقود إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لإخراج ما عليـه من حق فيهـا، إذ إنه كـان يعتقـد أن هذه النقود تكون من قبيل الركاز، فيجب عليه إخراج الخمس كما شرعه الله ـ تعالى ـ ورسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، مع أن حاله كما أكد راوي الحديث في شدة الحاجة إلى هذه النقود.
ثم من جانب آخر علل ما فعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها، حيث إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يأخذ منها شيئا، وقـرر أنها لم تكن من الركاز، بل تكون من اللقطة، يجري عليها حكم اللقطة، غير أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يأمره بالمعرفة أو التعريف كما هو معلوم في حكم اللقطة، بل دعا له بالمباركة مكافاة له على حسن صنيعـه. وبسبب هذا الدعاء الكريم من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، استفاد المقداد ـ رضي الله عنه ـ بهذه النقود فيما بقي من حياته (فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ). هكذا استجاب الله ـ تعالى ـ دعاء رسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وصدّقه بهذه المعجزة تأييدا له على أداء رسالته العظيمة. وما فعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هنا أيضا من رحمته الواسعة، وهو يعلم جيدا أن المقداد ـ رضي الله عنه ـ في شدة الحاجة إلى هذه النقود، وأن في تعريفها صعوبة ومشقة قريبة من التعذر لعدم تعيين مكان ضياعها([17]). وقيل: يلزم عليه حكم اللقطة مثل التعريف، وأما دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمقداد ـ رضي الله عنه ـ بالمباركة فلا يدل على أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل النقود له في الحال،بل بين فيه أنها له إن لم يجد صاحبها بعد تعريفها لمدة سنـة([18]). وهو ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجه المقداد ـ رضي الله عنه ـ سؤالًا (لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟) مشيرًا به إلى أنه لو أتبعها من الجحر لكانت تعتبر ركازا، ويجري عليها حكمه([19]).
والقصر الذي نحن بصدده هنا وقع بين أجزاء الجملة الفعلية، حيث قصر الفعل الصادر من فاعله (يَبْعَرُ) على الجار والمجرور المتعلقين بمحذوف نعت أو حال لمصدر محذوف (كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ)، والتقدير: يعبر بعرًا كبعر الإبل. وفي التعبير بالجملة الفعلية مع كون الفعل مضارعًا دلالة على الحدوث والتجدد، فهذا البعر يحدث ويتجدد، غير أنه قليل نادر، يقع مرة في اليومين والثلاثة.
وهذا القصر من قبيل قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف (بعره) على الصفة المشابهة لبعر الإبل (كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ)، وذلك على سبيل القصر الحقيقي المبني على المبالغة، لأن كون بعره مشابها لبعر الإبل أمر مبني على المبالغة والتأكيد، لأنه قد يكون له مشبه به غيره، لكن المتكلم لم يعتد به، كأنه لم يكن موجودا مبالغة في تأكيد وضوح هذا الشبه وظهوره، كأنـه لشدة جلائـه قد أخفى غيره، فنزل منزلة المعدوم.
هكذا جـاء أسلوب القصر بإنما هنـا في مقـام بيان حال من أحوال الناس، فوضح هذه الحال وأكدها بعناصره والصورة التي يحتويها مع ما سبقه من أسلوب القصر بطريق آخـر، وبالتالي أسهـم في تحقيـق مقصـد الحديث، فأكد رحمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الواسعـة، لأنـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يرسـل إلا رحمـة للعالمين، وأكـد ما عليه المقداد ـ رضي الله عنـه ـ من مكـارم الأخلاق، فإن أصحابه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كالنجوم، رضي الله عنهم!
ومن خلال التحليل السابق تبين لنا أن استخدام (إنما) هو الأليق بهذا المقام، لأن فيها مبالغة في تصوير وضوح حالهم الفقيرة في تلك الأيام الشاقة، بالإضافة إلى ذلـك فإن الجملة السابقة عليها (وكان الناس لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) قد مهد لهذا المفهوم وقربه، فناسب في إثباته استخدام طريق (إنما).
* * *
روى ابن ماجـه بسنـده عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُـلٌ اشْتَرَى عَقَارًا، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ بِمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: فَأَنْكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلْيَتَصَدَّقَا»([20]).
* مقصود الحديث:
المقصود من الحديث الشريف هو عرض صورة من الورع عن أخذ ما هو بحق، حثًا للأمة على التحلي بالإيثار والورع والأمانة والزهد وغير ذلك من مكارم الأخلاق، وفي الوقت نفسه يهدف لبيان استحباب الإصلاح بين الخصمين([21]).
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هذا المقصود جاء الحديث على شكل قصة حدثت بين ثلاثة رجال حكاهـا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حثا للأمـة على الاستفادة منهـا، فالتحلي بما ينبثق فيها من مكارم الأخلاق. بدأت القصـة بوجدان رجـل جَرَّةً من ذهب في العقار([22]) الذي اشتراه من رجـل آخـر (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُـلٌ اشْتَرَى عَقَـارًا، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ)، فتورّع كـل من المشتري والبائع عن أخذها حيث قال المشتري: (اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ)، فَقَالَ البائع: (إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ بِمَا فِيهَا)، فتحاكما إلى رجـل ثالث، وأعجب الرجل الحاكم ما هما عليه من الورع والزهـد والأمانـة، فأصلح أو حكم بينهما بطريقة يكافأ بها الرجلان على ورعهما بطريق غـير مباشر (فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الآخَـرُ: لِي جَارِيَـةٌ. قَالَ: فَأَنْكِحَـا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلْيَتَصَدَّقَا).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما في قول المشتري (إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ بِمَا فِيهَا)، ووقع موقع الاستدلال والتعليل لكون ما وجد في العقار حقًا للمشتري، حيث قصر فيه المبيع على الأرض الشامل لما فيها.
وإنما احتاج الكلام إلى مجيئـه بهذا الأسلوب المؤكـد، لأنه جاء للتأكيد على أن الجرة التي وجدهـا في العقار كانت حقًا للمشتري، حيث إن المخاطب المشتري قـد أنكـر أنهـا حق لنفسه معلـلا أو مستدلا لإنكاره بوقوع الشراء على الأرض وعدم وقوعه على الجرة التـي فيهـا ذهب (اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ).
ومع أن المخاطب المشتري أنكر كون شرائـه واقعًا على الأرض بما فيها أشد إنكار كما يبدو من كلامه الذي يحمل نوعًا من التعليل أو الاستدلال، غير أن البائع هنا لم يؤت كلامه بطريق النفي والاستثناء الذي فيه مزيد من التأكيد والتقوية، والذي كثر استعماله في مقامات إنكار المخاطب، بل لجأ إلى طريق (إنما) الذي يستعمل غالبًا في الأمور الجلية الواضحة التي لم ينكرها المخاطب. فهنا جاء أسلوب القصر بإنما في قول البائع على خلاف مقتضى الظاهر، وذلك لزيادة تأكيده ومبالغته، حيث ادعى فيـه أن بيعـه واقع على الأرض بما فيها، وهو أمر معلوم واضح، ولم يبال بإنكار المخاطب، كأنـه يلمح فيـه إلى أنه لا ينبغي على المخاطب إنكار ذلك لوضوحه وجلائه.
هكذا نرى الورع منهما عن أخذ الجرة، وكل آثر صاحبه على نفسه، وأخيرًا عرضا القضية على رجل ثالث ليصلح بينهما ويقضي من يستحق الجرة.
والقصر هنـا وقع بين أجزاء الجملة الفعلية، حيث قصر الفعل الصادر من فاعله مع مفعوله الثاني (بِعْتُكَ) على مفعوله الأول (الأَرْض بِمَا فِيهَا). وفي التعبير بالجملة الفعلية مع كون الفعل ماضيا دلالة على حدوث ذلك الفعل وتحققه، فكأنه يتأكد بها على أن البيع قد حدث وتحقق ووقع على الأرض، وليس الأرض فحسب، بل وقع على الأرض بما فيها.
وهـذا القصر من قبيل قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف (البيع الذي تم بين المتكلم والمخاطب) على الصفـة (تعلقه وارتباطه بالأرض بما فيها)، وذلـك على سبيل القصر الإضافي للقلب، يعكس بـه اعتقاد المخاطب المشتري، حيث إنه يعتقد أنه اشترى الأرض، ولم يشتر ما فيها كما صرح هو نفسه في قوله (اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ). فبهذا الأسلوب أسلوب القصر، أثبت البائع للبيع وقوعه على الأرض بما فيها، ونفى عنه كونه مقصورا على الأرض فقط. وبهذا قلب اعتقاد المخاطب، وأقر له أنه لم يشتر الأرض فحسب، بل اشترى الأرض بما فيها.
هكذا جـاء أسلـوب القصـر بإنما هنـا في مقـام الخصومـة، فأكـد المتكلـمما تمسك به، وعلل واستدل من خلاله لصحة رأيه، لإقناع المخاطب بما يعرض له. غير أن هـذه الخصومـة خصومة محمودة تتجلى فيها روح السمو والعلو والترفع والرقى والأمانـة الغاليـة والقناعـة الغنيـة، فإن القناعة كنز لا يفنى، تعود بالخير والبركة على صاحبها. فمن رضي بما أعطاه الله كـان من أغنـى الناس لأنه «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ»([23])، وينبثق فيهـا مـا يتحلى بـه الخصمان من مكـارم الأخلاق. وقد تظاهـر أسلوب القصر بإنما بعناصره هو مع عناصر القصة بأكملها على تحقيق المقصد الذي يرمي إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال حكايته هذه القصة الهادفة([24]).
واستخدام (إنما) هنا على خلاف مقتضى الظاهـر، وفي ذلـك ما لم يكـن في غيرها من الطرق مثل (النفي والاثبات) من المبالغة، حيث أكد فيه القائل صحة موقفه وادعى وضوح ذلك لدرجة كأنه لهذا الوضوح لا ينبغي أن ينكره المخاطب، فيخالفه في موقفه. ولو استخدم غير (إنما) من طرق القصر هنا، لذهبت هذه المبالغة الجميلـة التي تعكس مدى ورع المتخاصمين الكريمين كما رأيناه في أثناء التحليل السابق.
p p p
([2]) المراد باللقطة والضالة: ما وجده الإنسان ضائعًا أو ساقطًـا من صاحبه، غير أن الضالة من الحيوان؛ واللقطة من غير الحيوان. ولا يقـع إسم الضالة إلا على الحيوان، يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهمـا من الحيوان وهي الضوال، وأمـا الأمتعـة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ج12 ص21؛ فتح الباري لابن حجر: ج5 ص99؛ عمدة القاري: ج2 ص164؛ إرشاد الساري: ج4 ص242؛ منة المنعم: ج3 ص162؛ فتح المنعم: ج7 ص59.
([5]) ينظر: فتح الباري لابن حجـر: ج5 ص99؛ عمـدة القـاري: ج2 ص165/ ج12ص379؛ إرشاد الساري: ج9 ص69؛ منة المنعم: ج3 ص162؛ فتح المنعم: ج7 ص60.
([6]) ينظر: المعلم بفوائد مسلم: ج2 ص411؛ إكمال المعلم: ج6 ص9؛ شرح الكرماني على البخاري: ج6 ص548؛ شرح النووي على صحيح مسلم: ج12 ص21 ـ 22؛ عمدة القاري: ج12 ص379؛ إرشاد الساري: ج1 ص190/ ج4 ص208/ 243؛ شرح السندي على سنن ابن ماجه: ج3 ص194.
([7]) ينظر: فتح الباري لابن حجر: ج5 ص99 ـ 100؛ إرشاد الساري: ج4 ص244؛ منة المنعم: ج3 ص162 ـ 163؛ فتح المنعم: ج7 ص60.
([9]) العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جِلد أو خِرقة أو غير ذلك، من العَفْص: وهو الثَنْي والعَطْف. وبه سمي الجلد الذي يُجعل على رأس القارورة: عفاصا، وكذلك غلافها. والوكـاء: هو الخيط الذي تُشدّ به الصُرّة والكِيس وغيرهمـا. النهايـة في غريب الحديث والأثر: مادة (عفص) ومادة (وكا).
([10]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ج12 ص21؛ عمدة القاري: ج2 ص165؛ إرشاد الساري: ج1 ص190؛ شرح السندي على سنـن ابن ماجـه: ج3 ص195؛ =
= منة المنعم: ج3 ص162.
([14]) الركاز أو الكنز هو المال المدفون في الأرض بفعل صاحبه، أو بأثر حادث إلهي، كزلزال أو رياح عاتيـة، أدى إلى طمـر بلـد مع مـا فيهـا من ثروات. وتجب فيه الزكاة الخمس، للحديث: «فِى الرِّكَازِ الخُمُسُ.» (سنن ابن ماجه: كتـاب اللقطة باب من أصاب ركازا، حديث رقم: 2509/ 2510.) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: ج5 ص597.
([22]) العقار: الأصول من الأموال من الضَيعة والنخل والأرض ونحو ذلك. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: مادة (عقر)؛ إكمال المعلم: ج5 ص582.
([23]) صحيح مسلم: كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثـرة العرض، حديث رقم: 2420؛ سنن ابن ماجه: كتاب الزهد باب القناعة، حديث رقم: 4137.
([24]) من العلماء من يستدل بهـذا الحديث على جواز التحكيم، ومنهم من يرى أن ما جاء في الحديث نوع من الإصلاح، لا الحكـم. وفي تفاصيل ذلـك يراجع: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ج5 ص179؛ شرحا صحيح مسلم إكمال إكمال المعلم ومكمل إكمال الإكمال: ج5 ص28؛ فتح الباري لابن حجر: ج6 ص600؛ عمـدة القـاري: ج16 ص79؛ فتح المنعم: ج7 ص52.