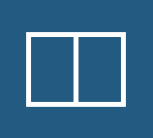مواقع إنما وأسرارها في أبواب الحديث عن المناسك من سنن ابن ماجه
مواقع إنما وأسرارها في أبواب الحديث عن المناسك من سنن ابن ماجه
كتب عن هذا الموضوع الكاتب الصيني ماشياومينغ في كتاب ( إنما وأسرارها البلاغية في سنن ابن ماجه ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة ( 1439هـ - 2018م)
فقال:
روى ابن ماجه بسنده عن حُمَيْدِ بنِ أبي سَوِيَّةَ، قال: سَمِعْتُ ابنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بنَ أبي رَبَاحٍ، عنِ الُركْنِ اليَمَانِيِّ، وهو يَطُوفُ بالبيتِ، فقال عَطَاءٌ: حَدَّثَنَا أبو هريرةَ أنّ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «وُكِلَ به سَبْعُونَ مَلَكًا، فمَنْ قال اللهمَّ! إنّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيَةَ في الدنيا والآخرةِ، ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾[البقرة: 201]، قالُوا: آمِينَ». فلمَّا بَلَغَ الرُكْنَ الأَسْوَدَ قال: يا أبَا محمدٍ! ما بَلَغَكَ في هذا الرُكْنِ الأَسْوَدِ؟ فقال عَطَاءٌ: حَدَّثَني أبو هريرةَ أنّه سَمِعَ رسـولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يقـول: «مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرحمنِ». قـال له ابنُ هِشَامٍ: يـا أبا محمـدٍ! فَالطَوَّافُ؟ قال عَطَاءٌ: حَدَّثَني أبو هريـرةَ أنّـه سَمِـعَ النَبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَلا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ،وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الحَالِ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ المَاءِ بِرِجْلَيْهِ»([1]).
* مقصود الحديث:
المقصود من الحديث الشريف هو بيان فضـل الركـن اليماني وفضل الركن الأسود وفضل الطواف.
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هـذا المقصد، ورد الحديث بمجموعـة كبيرة من الجمـل، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة عناصر رئيسية حسب المقصد الذي يهدف إليه الحديث: العنصر الأول: بيان فضل الركن اليماني (سَمِعْتُ ابنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بنَ أبي رَبَاحٍ، عنِ الُركْنِ اليَمَانِيِّ، وهو يَطُوفُ بالبيتِ، فقال عَطَاءٌ: حَدَّثَنَا أبو هريرةَ أنّ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «وُكِلَ به سَبْعُونَ مَلَكًا، فمَنْ قال اللهمَّ! إنّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيَةَ في الدنيا والآخـرةِ، ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، قالُوا: آمِينَ».)؛ والعنصر الثانـي: بيـان فضل الركن الأسود (فلمَّا بَلَغَ الرُكْنَ الأَسْوَدَ قـال: يا أبَا محمـدٍ! ما بَلَغَكَ في هـذا الرُكْنِ الأَسْوَدِ؟ فقـال عَطَاءٌ: حَدَّثَني أبو هريرةَ أنّه سَمِعَ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يقـول: «مَنْ فَاوَضَـهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرحمنِ».)؛ والعنصر الثالث: بيان فضل الطواف (قال له ابنُ هِشَامٍ: يا أبا محمدٍ! فَالطَوَّافُ؟ قال عَطَاءٌ: حَدَّثَني أبو هريرةَ أنّه سَمِعَ النَبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَلا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، مُحِيَتْ عَنْـهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَـهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الحَالِ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ المَاءِ بِرِجْلَيْهِ».).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما في العنصر الثاني الذي يبين فيه فضل الركن الأسود وفضل مفاوضته([2])، ووقع موقع جزاء الشـرط، تأكيدا لهـذا الفضل، حيث قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرحمنِ). أورده عطاء ـ رضي الله عنه ـ إجابة على سؤال ابن هشام ـ رضي الله عنه ـ الذي يسأل فيه عما ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في فضل الركن الأسود (ما بَلَغَكَ في هذا الرُكْنِ الأَسْوَدِ؟).
أورد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كلامه بأسلوب الشرط لتأكيد ثبوت فضل الركن الأسود ومفاوضته، وما يترتب عليهـا من شرف عظيـم وثواب جزيل، فإن ذلك يلزمها لزوم الجزاء للشرط. ثم أكد هذا الجزاء مرة أخرى من خلال إيراده بأسلوب القصر، حيث قصر هذه المفاوضة على كونها واقعة على يد الرحمن، مؤكدا وضوح ذلك من خلال إيراد القصر بطريق (إنما) مبالغة في تأكيد ذلك الفضل أو الشرف.
وهنا نرى أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكتف لتأكيد هذا الفضل العظيم بهذين الأسلوبين أسلوب الشـرط وأسلوب القصر فحسب، بـل أشركهما في صـورة مـن الصـور التخيلية ليصور للأمـة من خلالهـا هـذا الفضل بكـل وضوح، حيث إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ تخيل للأمـة أن من فاوض الركن الأسود، يفاوض الله ـ سبحانه وتعالى ـ، فأثبت له اليد على وجه التخييلية([3])، لا الحقيقة، فإنه ـ سبحانه وتعالى ـ منزَّه عنها، إذ إنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[الشورى: 11]. وذلك لاستعارتها للركن الأسود تشريفًا لـه وتثبيتـًا لفضله، حيث شبـه الركن الأسود باليد المتخيلـة في عظمة الشرف والفضل، ثم استعـير اللفـظ الدال على المشبـه بـه للمشبـه على سبيل الاستعارة التصريحية. وهذه الاستعارة جاءت لتصوير شرف الركن الأسود، وتثبيت فضل مفاوضته واستلامه وتقبيله، فإنه من حجارة الجنة، ويأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق([4]).
وقـد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن هذا الركـن الأسود هو يمين الله ـ تعالى ـ التي يصافـح بهـا عباده([5]). «والمعنى أن من صافحـه في الأرض كان له عند الله عهد، فكان كعهـد تعقـده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به، وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة، وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء، فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به، والله أعلم»([6]).
هكذا يخاطب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأمة بما يعهدونه ويألفونه من عرف وعادات، حيث إن من عاداتهم أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه تعظيما له أو تبركا به، فلما كان الحاج أو المعتمر أول ما يَقدَم يسن له استلام الركن الأسود وتقبيله، نزل منزلة يد الملك، فإن الله ـ عز وجل ـ ملك الملوك، فمن صافحه كان له عند الله عهد كما أن الملك يعطي العهد بالمصافحة. ولله المثل الأعلى([7]).
سنّ رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ استلام الركن الأسود وتقبيله إكراما له وإعظاما لحقه وتبركا به، وقـد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان على بعض، وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور على بعض([8]).
والقصر هنا وقـع بين أجزاء الجملة الفعليـة، ووقـع موقـع جزاء الشرط، فهذه الجملة الفعليـة القصرية تدل على أن هذا الفضل أو الشرف العظيم متحقق لمن فاوض الركـن الأسود، وهو متوقف على توافـر الفعـل الأول وهو الشرط، فمتى تحقق الشرط تحقـق الجزاء. وبعبارة أخرى فإنـه إذا تحققت مفاوضة الركن الأسود تحقـق هـذا الفضل العظيم، وإلا فلا. ففي هذا القصر بالإضافة إلى بيان الفضل العظيم للركن الأسود، فإن فيه أيضًا حثا للأمة على هذه المفاوضة وترغيبا فيها.
وهذا القصر قصر موصوف على صفـة، قصر الموصوف (المفاوضة)، أي: الفعل الصادر من فاعله (يفاوض) على صفة وقوعه على مفعوله الخاص وهو (يد الرحمن). وهو من قبيل القصر الإضافي للقلب المبني على المبالغة والتأكيد، حيث إن الذين يفاوضون الركن الأسود يعتقدون ـ لا محالة ـ أنهم يفاوضون هذا الركن المحسوس المشاهد فقط، فقلب ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا الاعتقاد مثبتا أن الذي يفاوضونه يد الرحمن المتخيلـة، ونفى أن يكون هـو الركن المشاهـد، وذلك على سبيل المبالغـة والتأكيد، لتخييل الأمـة مدى عظمة فضل الركن الأسود وشرف مفاوضته. فقد نزل الغـرض منزلـة الوسيلـة، فجعـل مفاوضتهم مفاوضـة للرحمن، لا للركـن الأسود([9])، لأن هذه المفاوضة لم تكن إلا اتباعًا لسنـة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وإكرامًا لهذا الركن وإعظاما لحقه الذي فضله الله ـ تعالى ـ به على غيره من الحجارة.
وفي هذا ما فيه من حث على مفاوضة الركن الأسود والترغيب فيه، تعظيمًا لحقـه وتبركا بشرفـه وطلبًا للثواب، فإذا كانوا يصافحون أيدي الملوك ويقبلونها تعظيما لشأنهـم ومكانتهم، فإن هـذا الركـن أحـق بأن يصافـح ويقبـل، وأجـدر بالتعظيم؛ وإذا كانوا يصافحون أيدي الشرفاء ويقبلونها تبركا بشرفهم، فإن الشرف في هـذا الركن أعظم، وبركته أكبر؛ وإذا كانوا يصافحون أيدي الملوك ويقبلونها لأجـل أن الملـوك يعطونهم العهد، فتخيل: ماذا يترتب على مصافحة هذا الركن وتقبيله، وهو حجر حقيقة ويد ملك الملوك شرفا. إن عند الله عهدا عظيما لمن صافحه وقبله، فإن هـذا الحجـر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق. واختار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بين الأسماء الحسنى لهذا الملك العظيم اسم (الرحمن)، تبشيرا لمن يفاوض الركن الأسود، فإن لهم شرفا كبيرا وثوابا عظيما ورحمة واسعة من الله ـ تعالى ـ، لأنه الرحمن الرحيم. أما مـن قبّل الملوك، فقد يحصلون منهم على شيء، وقـد لا يجدون شيئًا، فإن في لفظ الملك رائحة القهر والهيبة.
هكـذا جـاء أسلوب القصر بإنما هنا في مقام بيان الفضل وتأكيده، فتظاهربعناصره مع أسلوب الشرط الذي ورد فيه القصر على تحقيق مقصد الحديث، فبيّن للأمة بكـل وضوح الفضلَ العظيم للركن الأسود ومفاوضته واستلامه وتقبيله، وأكده بأسلوب بليغ موجـز، حثـا لهم على المبادرة إلى هذا العمل لنيل شرف هذا الفضل العظيم وثوابه.
وقـد وفـق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في اختياره (إنما) لأداء هذا القصر، فإن استخدام (إنما) هو الأليق بهذا المقام، لأن فيه ادعاء أن مفاوضة الركن الأسود هي بمنزلة مفاوضة يد الرحمن فضلا وشرفا، وأن ذلك حقيقة ثابتة لا يجهل. وفي ذلك ما فيه من زيادة الحث على مفاوضة الركن الأسود والترغيب فيها، حرصا على حصول ذلك الفضل الكبير والشرف العظيم. ولـو استخدم غيرها من طرق القصر مثل (النفي والاستثناء) لقلّت هذه القوة في الحث والترغيب.
* * *
روى ابـن ماجـه بسنده عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ الله يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وَلَـوْ كَـانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا الله،فَلَعَمْرِي! مَا أَتَمَّ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ([10]).
* مقصود الحديث:
الحديث الشريف يهدف لبيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج([11]).
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هـذا المقصد، جـاء الحديث على شكـل المناقشة الجارية بين عروة والسيدة عائشة ـ رضي الله عنهما ـ، حيث رأى عروة ـ رضي الله عنه ـ أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفـا والمـروة (مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ)، فعارضتـه السيدة عائشـة ـ رضي الله عنها ـ وناقشته في ذلـك. ويمكن تقسيم مناقشة السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ إلى ثلاثـة عناصر رئيسية: العنصر الأول: مناقشتها له من حيث نظم الآية (قَالَتْ: إِنَّ الله يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا».)؛ والعنصر الثاني: مناقشتها له من خـلال الوقوف على سبب نزول الآية (إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّـوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِـكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا الله.)؛ والعنصر الثالث: تأكيـد بعد المناقشة على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج (فَلَعَمْرِي! مَا أَتَمَّ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما في العنصر الثاني من مناقشة السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ لرأي عروة ـ رضي الله عنه ـ، والذي ذكرت فيه سبب نزول الآية (إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الأَنْصَارِ، كَانُـوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَـعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا الله.)، تأكيدا على أنه ليست في الآية دلالة على نفي الحرج عمن ترك الطواف بين الصفا والمروة.
وإنما احتيج إلى مثل هذا التأكيد لأن المخاطب قد صرح برأيه أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفا والمروة، حيث قال: (مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ). وفهمـه هـذا من ظاهـر قوله ـ تعالى ـ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[البقرة: 158]، ووجهة نظره هي: أن رفع الحرج عن الفعـل إنما يشعر بإباحتـه، لا بوجوبه، لأن رفـع الجنـاح معناه رفع الإثم، ورفـع الإثم علامة المباح، ويزيد المستحب إثبات الأجر، ويزيد الوجوب عقاب التارك، فلو كان مستحبـًا أو واجبا لما اكتفى برفع الحرج الذي يستعمل أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب([12]).
فعارضته السيدة عائشـة ـ رضي الله عنها ـ مؤكدة مناقشتها بوسائل عدة: ناقشته أولا من حيث نظم الآية التي فهم منها عـدم الجناح على تارك السعي بين الصفا والمروة ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[البقرة: 158]، وردّت عليـه بأنه لا دلالة في الآية على نفي الوجوب، لأن الآية الكريمة إنما اقتضى ظاهرها رفع الحرج عمن طاف بين الصفاوالمروة، فليس هو بنصّ في سقوط الوجوب، فإن نفي الجناح عن الفعل لا يلزمه نفي الجناح عن الترك. ولو كان نصًا في ذلك لكـان يقـول: (فَلَا جُنَـاحَ عَلَيْـهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) بزيـادة (لا). ورفـع الحـرج أعـم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة، والأعم لا إشعار لـه بواحـد من أخصائه على التعيين، ولا يدل رفعـه على عدم الوجوب بالتعيين. فليست في الآية دلالة على وجوب السعي ولا على عدمه، غير أنه قد ثبت وجوبه من فعله وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ([13]).
وإلى هنا قد يطرح البعض سؤالا، وعلى الأخص قـد يسأل المخاطب المعارَض عليه، لأن الموقف موقف المعارضة والمناقشة. وهذا السؤال المحتمل هو: وإذا كان الأمر كذلك، فلِم جاءت الآية على هذا النظم؟ وما فائدتها؟
أجابت السيدة عائشة ـ رضي الله عنهـا ـ على هذا من خلال ذكرها لسبب نزول الآية، إذ من خلال الوقوف على سبب النزول تبينت القضية ووضح المعنى. فقال: (إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ([14])، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا الله.)، فهذه الجملة كالإجابة على السؤال المحتمل، والتأكيد لمعنى الجملةالسابقة عليها، لذا جرّدت عن العطف بالواو.
أوردت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ سبب النزول بأسلوب القصر نفيا لما فهمه عروة ـ رضي الله عنه ـ من ظاهر الآية، ثم اختارت لهذا القصر طريق (إنما) خاصة إشارة إلى وضوح ذلك المعنى، فكأنها تقول: إن الذي فهمته هو قد يكون من مقتضى ظاهـر الآيـة إن لم يعتبر سبب نزولهـا، غير أنك إذا وقفت على سبب نزولها لم تكن تفهمها على ذلك الوجه، فإنه حينئذ تبين لك أنها إنما أتت رافعة لحرج من تحرج من الطواف بينهما([15]). وذلك أن ناسا من الأنصار كانـوا في الجاهلية إذا أهلوا أهلوا لمناة، فيتحرجون في الإسلام من السعي بين الصفا والمروة، لما يرون في ذلـك شبها لما كانوا عليه في الجاهلية، وهم لا يريدون أن يعملوا شيئا مما كان من أمر الجاهلية، لقوة إيمانهم وصفاء يقينهم وتحرزهم من كل قول أو عمل يشم منه رائحة التعارض مع عقيدتهم الإسلامية، فنزلت الآية لإزالة هذا التحرج([16]).
ذكرت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ هذا السبب، وقصرت نزول الآية عليها، ونفت أن يكون نزولها على الإطلاق غير مقيد بهذا السبب حتى يتوهم أن في نفي الجناح (لا جناح) دلالة على جواز ترك الطواف.
القصر هنا وقع بين أجزاء الجملة الفعلية، حيث قصر الفعل مع نائب فاعله (أنزل هذا) على الجار والمجرور (في ناس)، غير أن المقصور عليه هو الجار والمجرور (في ناس) مع جميع مـا يتعلـق بالمجرور (ناس)، فيدخل فيه الجار والمجرور (من الأنصار)، وتدخل فيه كذلك الجمل التالية (كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا الله.) بأكملها، لأن هذه الجمل معطوف بعضها على بعض، وتكون بمثابة جملة واحدة تبين حال (ناس من الأنصار)، فلا تفصل بينها وبين صاحبها.
والجملة الفعلية مع كون فعلها ماضيا دالة على تحقق هذا السبب، فإن الآية قـد نزلت في هذا السبب أو المناسبة الخاصة. وحذف فاعل الفعل للعلم به، لأن منزل الآيـة لم يكن إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ . وعـرف المفعول بـه النائب مناب الفاعل باسم الإشارة ليميزه أكمـل تمييز، ويوجز الآيـة بأكملها في لفظة واحدة (هـذا). وتذكيره باعتبار اللفظ (القول)، فـإن الآيـة قـول الله ـ تعالى ـ . وتنكير المجرور (ناس) مع بيانه بالجمل اللاحقة بها لتوضيح وجه المناسبة بين الآية وسبب نزولهـا، فذكـر فيهـا أن سبب النزول هو إزالـة تحـرج الأنصار، وبين سبب هذا التحرج.
وهذا القصر قصر موصوف على صفـة، حيث قصر الموصوف (نزول هذه الآية) على صفة كونه مخصوصا للسبب أو المناسبة المذكورة (فِي نَاسٍ مِنْ الأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا الله.). وبهذا أثبتت لهذا الموصوف، أي: لنزول الآيـة، صفـة الخاصية، ونفت عنـه صفـة العمومية. بمعنى أن الآية كانـت نزلـت على هـذا السبب الخـاص المذكـور، ولم تكـن نازلـة على العمـوم والإطلاق، فيكون فهمهـا لا بد من البنـاء على أساس الوقوف على هذا السبب. وبهذا وضح أن القصر من قبيل القصر الإضافي للقلب، حيث إن المخاطب بفهمه الآية على الوجه المذكور، كأنه لم يكن واقفا على سبب نزولها أو قد نسيه، وظن أن الآية نزلت على وجه العموم. فذكرته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ، ولمحت لـه غفلتـه لسبب نزول هذه الآية، وأكدت له هذا السبب، لأنه لا يستقيم فهمها مـن غـير قرانهـا بسبب نزولهـا، ولأن مـن خـلال الوقـوف على سبـب النـزول يرفـع الاستشكال، وينحـل التسـاؤل، ويتضح المعنى، ويتعـين القصـد. فكـأن السيدة عائشـة ـ رضي الله عنها ـ تقول: أنسيت يا عـروة أن الآية ما كانت نزلت على وجه العموم، حتى فهمت منها ما فهمت، ودار في ذهنك ما دار، وإنما نزلت في هذه المناسبة الخاصة أو السبب الخاص، فإذا وقفت على ذلـك أزلـت الوهـم وأصبت الفهم.
وبعـد ذلـك أكدت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ بصراحة على وجوب السعي بين الصفـا والمروة قائلـة: (فَلَعَمْرِي! مَا أَتَمَّ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَـجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.) كـأن وجوبـه قـد ثبت مـن خـلال مناقشتهـا السابقـة، وكـأن هـذا هـو نتيجـة طبيعيـة لهـذه المناقشة، لـذا ساقـت هـذه الجملـة بفـاء التفريع.
هكـذا جـاء أسلوب القصر هنا في مقام المعارضـة والمناقشة، فأكد به على صحة وجهة نظر الجانب الأول، وفي الوقت نفسه رد به على رأي الجانب الآخر. وفي نهاية المناقشة بين للأمة بكل وضوح وبكل تأكيد أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. ومن خلال هذه المناقشة علّمت للأمة مدى أهمية الوقوف على سبب نزول الآيات في فهمها على وجهها الصحيح.
وقد وُفّقت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ في اختيارها (إنما) طريقًا للتعبير عن هذا القصر، فإن هذا الطريق هو الأليق بهذا المقام، لأن القصر هنا جاء لتأييد عدم كون تلك الآية على وجه الإطلاق، وهذا التأييد يتقوّى من خلال مفهوم هذا الطريـق الخاص، وذلك أن للآيـة المذكورة سببها الخاص الذي نزلت فيه، وهذا السبب ثابت معلوم لا شك فيه، وتبعًا لذلك فإن الآية لا يصح فهمها بظاهرها. فالسيدة عائشة ـ رضي الله عنهـا ـ ذكّرت المخاطب هذا السبب المعلوم بأسلوب رقيق في هدوء تام، تنبيهًا له على فهمه الخاطئ، وحثًّا له على العدول عن ذلك إلى الفهم الصحيح للآية.
هكذا يتجلى في هـذه المناقشة المفيدة فقـه السيدة عائشـة ـ رضي الله عنها ـ وعلمها، ودقة فهمها، وبلاغتها. وهذه المناقشة ـ كما قال العلماء ـ من بديع فقهها ودقيق علمها وثاقب فهمها وكبير معرفتها بأحكام الألفاظ ودقائقها([17]).
* * *
روى ابن ماجـه بسنده عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ نُزُولَ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ([18]).
* مقصود الحديث:
المقصـود مـن الحديث هـو بيـان أن نزول الأبطـح ليس بسنـة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ([19]).
* عناصر بناء الحديث:
أوردت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ كلامها في جملتين موجزتين لتحقيق هذا المقصد، مقررة في الأولى منهما أن نزول الأبطح ليس بسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إِنَّ نُزُولَ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ)، ومؤكدة في الثانية لهذا التقرير من خلال ذكر سبب نزول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأبطح (إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما في الجملة الثانية (إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِـهِ)، ووقع موقع التعليل والتأكيد لما قررته في الجملة الأولى من أن نزول الأبطح([20]) ليس بسنـة. وقـد قررت السيدة عائشـة ـ رضي الله عنهـا ـ هذا الحكم في الجملة الأولى، وجاء كلامها بأسلوب مؤكد، حيث أكدته بحرف (إنّ) وبزيادة حـرف البـاء في خبر ليس، مع إيراد الجملة اسمية دلالة على ثبوت ذلك الحكم ودوامه. كل هذه التأكيدات جاءت لترد على من يرون أن هذا النزول سنة،وتقرر لهم أن ذلـك ليس بسنـة. غـير أن هـؤلاء قد يحتجون عليها بما حدث من نزول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأبطح، ويسألون: إن لم يكن النزول سنة، فكيف يفسر نزول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه؟ وما سبب نزوله؟
السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ تتوقع هذا، فهي من هي في شدة الذكاء والفطنة؟ لـذا سارعت إلى الإجابـة على هذا السؤال المحتمل قبل طرحه، تأكيدا لحكمها وإقناعا للمخاطبين به. فهذه الجملة كالإجابة على السؤال المثار من خلال الجملة الأولى، لذلك جرّدت عن العطف بالواو بينهما.
وفي هذه الإجابـة أو هذا التعليل قصرت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـنزول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأبطح على سبب أو قصد معين، وهو كون هذا النزول أسهل وأقرب لخروجه إلى المدينة، وليجتمع إليه من معه مدة مقامه فيه بقية يومهليرحلوا برحيله([21])، وبهذا نفت ضمنيا أن يكون النزول لقصد النسك والشرع حتى يكون سنة تتبع([22]). ثم أكدت هذا المفهوم من خلال إيراد القصر بطريـق (إنما)، حيث إن فيه ادعاء لوضوح هذا المفهوم وجلائه، فكأنه معلوم لكل.
القصر هنـا وقع بين أجزاء الجملـة الفعلية، حيث قصر الفعل الصادر من فاعلـه والواقع على مفعوله (نَزَلَهُ رَسُول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ) على المفعول لأجله (لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِـهِ). اختارت الجملـة الفعليـة مع كـون الفعل ماضيا للدلالة على حدوث هذا الفعل وانتهائه. فنزوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حدث وتحقق، غير أنه مقيد بقصدهالمعين أو سببـه الخاص، وكان ذلك القصد أو السبب لم يكن للنسك أو التشريع، فلا يلزم فعله على الأمة بالاتباع. فهذا النزول قد مضى وانتهى، ولا يلزم على الأمة اتباعه، فينزلوا كما نزل ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وكلمـة (أسمح) بمعنى: أسهـل، يقال: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء؛ وسمح لي فلان، أي أعطاني، ووافقني على المطلوب؛ وسَمَح وتسمح: فعل شيئا فسهل فيه؛ وسمح له بحاجته وأَسْمَح أَي سَهَّل له. منه الحديث: «اسْمَحْ يُسْمَحْ لَـكَ»([23])، أي: سهل يسهل عليك([24]). وبين هذه المعاني توافق ظاهـر، إذ الجود والكرم هو الإعطاء للغير، والموافقة على طلبه، وذلك تسهيل لأمره وسد لجاجته.
هذا القصـر قصـر موصوف على صفـة، قصـر الموصوف (نزولـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأبطح) على صفة كونه متعلقا ومرتبطا بقصد (كونه أسمح لخروجه). وهو منقبيل القصر الإضافي للقلب، حيث إن الذين يرون أن نزول الأبطح سنة يعتقدون ـ بالتأكيد ـ أن نزول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأبطح كان لقصد النسك والتشريع، حتى يتبعهالأمة في ذلك، فينزلوه كما نزل ـ صلى الله عليه وسلم ـ، لأن هذا هو أساس اعتقادهم بكونه سنة، ووجهة نظرهم. فردت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ على هذا الاعتقاد، مثبتة أن ذلـك النزول كـان لقصد التسهيل للخروج، ونافيـة أن يكون لقصد النسك، وتبعا لذلك أكدت على أن نزوله ليس بسنة، وعللت لذلك.
هكذا جاء أسلوب القصر بإنما هنا في مقام تصحيح الموقف وبيان الحكم، فبه علـلت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ لموقفهـا، وأكـدت على صحتـه. وفي الوقت نفسه، ردت به على الموقف المخالف وصححه. وبذلك حقق ما تهدف إليه في كلامها، فبينت أن نزول الأبطح ليس بسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
كما ذكرنا أن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت أن النزول ليس بسنـة، معللة لذلـك بأن نزوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن لقصد النسك، ولم يتطلبه هدف ديني، بل هو منزل اتفاقي لا مقصود. غير أن من العلماء من يرون أن نزوله كان لقصد ديني، وهو الشكر لله بما عوضه من الظهور في هذا المكان على عداه الذين تقاسموا فيـه على قطيعته ومضرته، تقاسموا على إخراجه ومن معه من هذا الشِعب خَيفِ بني كنانة، وغيظ أيضا لعدوه بذلك، مستفيدين ذلك من رواية أبي هريرة ـ رضي الله عنـه ـ: أَنَّ رَسُولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَـدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَـةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ»([25]). فبذلك قالوا باستحباب نزوله اقتداء برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتبركا بمنازله([26]). وكـل فريق له وجهة نظره، «ولكلا القولين وجه من الصحة، فلاشك أن التحصيب ليس بسنة من سنن الحج، ولكن لما نزله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان النزول به مستحبًا اتباعًا لـه، ولا سيما وقـد فعلـه الخلفاء»([27]). ﴿ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[البقرة: 185]، «فمن تيسّر لـه القدرة فله أجره ـ إن شاء الله ـ بنيته، ومن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم»([28]).
وقد وُفّقت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ في اختيارها (إنما) طريقًا للتعبير عن هذا القصر، فإن هذا الطريق هو الأليق بهذا المقام، لأن القصر هنا جاء تعليلًا للحكم، وما تفيده (إنما) من ادعاء وضوح مفهوم القصر يرشّحها على غيرها من طرق القصر في هذا المقام، كما سبق في كثير من المواضع المتشابهة.
* * *
روى ابـن ماجـه بسنده عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَـعَ رَسُولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْـرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْـرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْـهِ وَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَـهُ لِرَسُولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُـنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَـرَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ([29]).
* مقصود الحديث:
المقصود من الحديث هو بيان حكم من أحكام الصيد، وهو أنه يجوز صيد البر للحلال غـير المحرم، وأنه يجوز للمحرم أن يأكـل منـه، إلا أن يعلم أنه صِيد من أجله، فلا يجوز([30]).
* عناصر بناء الحديث:
لتحقيق هذا المقصد ذكر لنا أبو قتادة ـ رضي الله عنه ـ حدثًا حدثَ له عند خروجه مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعض أصحابـه في زمن الحديبية. ويمكن تقسيم هذا الحـدث إلى ثلاثـة عناصر رئيسية: العنصر الأول: ذكره للصيد كيف وقع (خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْـهِ وَاصْطَدْتُـهُ.)؛ والعنصر الثاني: عرضه الصيد للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ.)؛ والعنصر الثالث: صدور حكم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصيد من خلال موقفه (فَأَمَرَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.).
* أسلوب القصر في الحديث ـ عناصر بنائه ـ وعلاقاته بغيره من عناصر الحديث:
ورد أسلوب القصر بإنما في العنصر الثاني من هذا الحدث، أورده أبو قتادة ـ رضي الله عنه ـ في كلامه عنـد عرضه الصيد للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهو عندئذ أبرز في كلامـه نقطتين، وأكدهما للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهمـا: عدم إحرامه، وقصده من الصيد: (وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُـنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُـهُ لَـكَ). وهاتان النقطتان أحلّت إحداهما شيئًا، وحرّمت أخراهما شيئا، فعدم الإحرام أحـل للمحرمين أن يأكلوا مـن صيـده، وقصده من الصيـد حـرّم على من يُصـاد من أجله الأكلَ منه، وهو هنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، لأن أبـا قتـادة ـ رضي الله عنـه ـ صـاد الحمار خصوصا لأجلـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
أسلوب القصر بإنما وقع في هذه النقطة الثانية التي أكد أبو قتادة ـ رضي الله عنه ـ فيها قصده من الصيد، وأنه صاده خصوصًا لأجل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فهذا القصر أكـد على أن القصد من الصيد كـان لأجـل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحده، ونفى ضمنيًا أن يدخل في قصـده أي واحـد من أصحابـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ . والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهم قصده هذا من عبارته، فأصدر الحكم بأن هذا الصيد يَحل أكلُه لأصحابه، ولا يحل له ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وذلك لأن الصائد حلال لم يُحْرِم، ثم إنـه لم يَصد لأجـل الأصحاب، فيحل لهم، وإنه صاد لأجل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فلا يحل له.
هكذا جاء أسلوب القصر بإنما هنـا في مقـام عرض شيء وذكـره، فأكد به صاحب العرض جوانب الدقة في الشيء المعروض. وبذلك حقق ما يحمله الخبر من هـدف، فبين الحكم المتعلق بهذا الشيء المعروض، وهو الصيد، بين أنه جائز للحلال غير المحرم، ويجوز للمحرم الأكل منه إلا إذا علم أن الصيد كان لأجله، فلا يجوز له الأكل منه.
القصر هنا وقع بين أجزاء الجملـة الفعليـة، حيث قصر الفعل الصادر من فاعله والواقع على مفعوله (اصْطَدْتُهُ) على الجار والمجرور (لَكَ). واختار الجملة الفعلية لأن الصيد قد حدث وتحقق. وهذه الجملة القصرية بأكملها وقعت خبرا للحرف (أن) الذي هو معطوف على الحرف (أن) الأول، ويكون في محل النصب مفعول (ذكرت). وكرر (ذكرت) لإبراز مـا يذكـر وتأكيده، لأنه هو مدار الحكم الصادر من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (فَأَمَـرَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ) وهو أساسه، وقد أكده مرة أخرى عند ذكر عدم أكل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منه (وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ).
هـذا القصر قصر موصوف على صفـة، قصر الموصوف اصطـياده الحـمار الوحشي (اصْطَدْتُهُ) على صفة كونه خصوصا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لك).
ثم إن هذا القصر من القصر الإضافي، لكنه من أي قسم من أقسام القصر الإضافي؟ الظاهر أن له نصيبا من كل قسم. وذلك أنه من المعلوم أن هذا التقسيم مبني على حال المخاطب، فمن هـذا المنطلق إن اعتبرنا أن المخاطب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان لا يعلـم لمن اصطاد أبو قتادة ـ رضي الله عنه ـ؟ فكأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلم أنه لأجل فلان، إذ لا بد لاصطياده من قصد، غير أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يتعين له هذا، لأنه من البشر، ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾[الكهف: 110، فصلت: 6]، لا يعلم ما في نفس غيره على الوجه اليقين. فجـاء القصر تعيينا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الاصطياد كـان لأجلـه هو ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وبهذا الاعتبار يكون القصر قصر التعيين. وإن اعتبرنا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعتقد أن أبا قتادة ـ رضي الله عنـه ـ اصطاد لنفسـه، فجاء القصر ليعكس هذا الاعتقاد، ويثبت أن الاصطياد كان لأجل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولم يكن لأجله نفسه. وبهذا الاعتبار يكون القصر قصر القلب. وإن اعتبرنا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعتقد أن أبا قتادة ـ رضي الله عنـه ـ اصطـاد لجميـع الحاضرين، النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابـه، وكذلـك أبـو قتـادة ـ رضي الله عنـه ـ نفسه، فجاء القصر ليفرِد الاصطياد للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحده، ونفى عنه أن يكون لغيره. وبهذا يكون القصر قصر الإفراد.
ومهما يكن فإن أبا قتادة ـ رضي الله عنه ـ قد وفّق في اختياره (إنما) للتعبير عن هـذا القصر، فإنه ـ رضي الله عنـه ـ قد أودع في هذه الألفاظ القليلة كثيرا من المعاني. فهو يشير بطريـق (إنما) إلى أن كون صيده لأجل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر واضح معلوم، ولم يَعتدّ بما عليـه المخاطب من الشك أو عدم العلم بقصده هذا، مبالغة في ادعاء وضوح ذلك القصد وجلائه. وهكذا حب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وكذلـك حب المسلمين لنبيّهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يحبونـه على والديهـم وعلى أولادهم، بل على أنفسهم. فعندما يفعلون أيّ شيء، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قلوبهم، يجلبون له خيرا، ويدفعون عنـه شـرًا، ولن يبخلوا عنه بشيء. فها هو أبو قتادة ـ رضي الله عنه ـ صاد لأجل حبيبه المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ويكمن في لفظة (إنما) حبه الجمّ للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فكأنه يقول: أ لأجلي أنا أو لأجـل أي واحـد أصيد؟! والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معي، وهو مـن هـو؟ أحب النـاس إليّ علـى الإطـلاق، فمعلـوم أني مـا فعلـت شيئـا فيـه مصلحة إلا لأجله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، هكذا يكون شأن المؤمنين مع حبيبهم المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ . ثم إن مـا في هـذا الطريـق من صفـات الخفـة والرقـة يناسب تمامـًا هـذا الحوارَ الجاري مع أشرف الخلق ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فهي تعكس مدى تأدب الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتواضعِهم له، حتى إنهم يتحرون ذلك في استخدامعباراتهـم وتوظيف ألفاظهم عند الحوار معه ـ صلى الله عليه وسلم ـ . ورضي الله عنهم وجزاهم خير الجزاء!
* * *
([2]) فاوضه: أي قابله بوجهه، أو لابسه وخالطه، من مفاوضة الشريكـين، إذا اشتركـا في المال أجمعَ. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثـر: مادة (فوض)؛ شرح السندي على سننن ابن ماجه: ج3 ص439؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ج9 ص130.