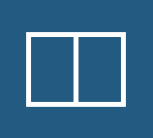استيلاء ظاهر العمر الزيداني على قلاع جدين وصفد والبعنة والقرى التابعة لها
استيلاء ظاهر العمر على الناصرة ونزاعه مع شيوخ جبل نابلس
كتب الأستاذ الدكتور خالد محمد صافي حول هذا الموضوع في كتابه " ظاهر العمر الزيداني حاكم الجليل في القرن الثاني عشر ( 1689-1775 م) والذي صدر عن دار المقتبس في بيروت سنة 1439هـ-2018 م
فقال :
كان ظاهر يتردد على الناصرة لأن إحدى زوجاته (نفيسة) تقيم فيها، فرأى من أهل الناصرة كل اعتبار وإكرام. وعندما استولى على صفد تبع ذلك بالاستيلاء على الناصرة وأبعد نفوذ النابلسية عنها وعن أراضي مرج ابن عامر([1]). فحقد عليه شيوخ نابلس وأضمروا له الشر إذ كانت الناصرة تعتبر سوقاً للنابلسية باعتبارها مورد بضاعة دمشق وعكا. فكانوا يشترون منها جميع احتياجاتهم إضافة إلى تحصيل عوائد من حكامها. وقرر شيوخ نابلس برئاسة إبراهيم الجرار والشيخ ابن ماضي محاربة ظاهر العمر وتحالفوا مع عرب الصقر (بزعامة أميرهم رشيد جبر) الذين حقدوا على ظاهر العمر بسبب رفع أيديهم عن السلب والنهب في الطرقات. واستطاع ظاهر هزيمة المتحالفين في مكان بمرج ابن عامر يقال له الروحة([2]). ودخل بلاد نابلس حتى بلغ قلعة صانور بعد أن قتل زعيمهم إبراهيم الجرار. ولما رأى ظاهر مناعتها، وأن حصارها وأخذها يقتضى زمناً طويلاً تركها واكتفى بأن وضع يده على جميع بلادهم الساحلية، ورجع عنهم إلى الناصرة فائزاً منصوراً. وكتب مشايخ سنجق نابلس من آل جرار وآل طوقان إلى سليمان باشا والي دمشق بما عمله ظاهر العمر معهم باعتبار أن سنجق نابلس يتبع إدارياً لولاية دمشق. فطلب منهم أن يعقدوا صلحاً، ويهادنوا ظاهراً إلى أن يعرض أمره على الدولة. فكاتب محمد الجرار ظاهراً في أمر الصلح، فصالحهم ظاهر على أن لا يتعدى أحد منهم على أحد من الناصرة، وأن يتنازلوا عن المناطق التي استولى عليها بالحرب، وسيترك لهم البلاد التي في جوار جبلهم مقابل دفعهم له ما صرفه في حربه معهم. واتفقوا أن يكون هذا خمسمائة كيس (الكيس يساوي خمسمائة قرش)، فدفعوها له، وترك لهم بلادهم([3]).
وانـفرد ميخائيـل الصباغ بذكـر تفاصيل هـذا النـزاع الـذي حـدث سنة (1735م) بين ظاهر العمر وحكام نابلس، بينما اكتفى كل من حنا سمارة والمعلوف بتناول المعركة التي وقعت بين ظاهر العمر وحكام نابلس وعرب الصقر. فذكرا أن ظاهراً قتل من جيش الأعداد ثلاثين ألفاً حتى أنتنت رائحة مرج بن عامر من كثرة القتلى. وأنه في إحدى مناطق المرج قطعة أرض قتل فيها ثمانية آلاف من النابلسية، وأن تلك الأرض بقيت عشرين سنة لا تصلح للفلاحة من كثرة عظام القتلى حتى دعيت بأم العظام. وأشار حنا سمارة أن نساء الناصرة شاركن في المعركة بحمل الماء إلى المقاتلين من جيش ظاهر، وتشجيع أفراد الجيش بالأغاني الحماسية([4]). ويبدو من سياق الرواية المبالغة الكبيرة التي تحويها بخصوص عدد القتلى، التي تعتبر أرقاماً خيالية لا تقترب من الحقيقـة وإن كانت توحـي إلى حد ما بمقدار الهزيمة التي لحقت بزعماء نابلس، وإيحاءً بكثرة القتلى في جانبهم. وحاول سمارة إبراز دور أهل الناصرة في المعركة.
أما عبود الصباغ فقد أشار إلى هذا القتال أشارة مقتضبة بقوله: «وكذلك حارب جبل نابلس وقتل منهم مقتلة عظيمة في مرج ابن عامر»([5]).
وهكذا نرى أن استيلاء ظاهر العمر على الناصرة ذات الأهمية الاقتصادية لحكام نابلس وأهلها، وبسط يده تدريجياً على أراضي المرج الخصبة، شكل السبب المباشر للنزاع الذي نشب بينه وبين آل جرار وآل ماضي. وبالتالي فإن تصادم المصالح يمثل السبب الحقيقي للحرب بينهم. وشكلت معركة الروحة أو المنسي نقطة تحول في العلاقات بين ظاهر العمر والدولة العثمانية، إذ كان ظاهر حتى هذا التاريخ في نظر الدولة شيخاً إقطاعياً صغيراً من شيوخ الالتزام في الجليل، أما الآن وبعد تغلبه على مشايخ نابلس الموالين للعثمانيين والتابعين لولاية دمشق فقد أصبح فـي نظـر الدولـة رجلاً يحسب لـه حساب، فأوعزت إلى وزيرها في دمشق سليمان باشا بمهاجمته وقتاله([6])، فقاد سليمان باشا العظم ثلاث حملات عسكرية ضد ظاهر العمر في الفترة بين (1737 ـ 1743م) استطاع ظاهر صدها من معقله في طبريا التي قام بتحصينها لهذه الغاية([7]).
ج ـ ضم الدامون وشفا عمرو إلى الحكم المباشر لظاهر:
كان يحكم الدامـون علـي الزيداني (عم ظاهـر أو عـم أبيـه) منذ صعود الزيادنة إلى السلطة في نهاية القرن السابع عشر، وكان يلتزمها أولاً تحت اسم عمر الزيداني (والد ظاهر) وعندما توفي الأخير سنة 1705م استمر علي بالتزامها تحت اسم ظاهر العمر حتى العقد الثالث من القرن الثامن عشر كما يشير إلى ذلك النقش الذي كان على مسجد الدامون([8]). والمرجح أن علياً الزيداني قد توفي قبل نهاية العقد الثالث حيث تولى بعده ابنه محمد العلي الذي استمر يحكم تحت إسم ظاهر العمر كما كان الحال في عهد أبيه. وقام محمد العلي الذي كان صهر ظاهر العمر أيضاً (حيث كان زوج الأخت الوحيدة لظاهر العمر وتدعى شمـة) بحركـة توسعيـة في بدايـة الثلاثينات شأنـه في ذلك شأن ظاهـر العمر، فاستولى على شفا عمرو وجعلها مركزاً لـه([9]). وعمل ظاهـر علـى التخلص منه وأعاد عبود الصباغ سبب ذلك بالقول: «وصار اسمه (أي ظاهر) كبيراً عند كامل الخلق. فانحسد منه ابن عمه محمد العلي وأراد أن يقتله أو يصغر اسمه. فكاتب سليمن (سليمان) باشا وزير الشام... بأن يكون مسعفاً له» وكان ظاهر ينزل إلى عكا قبل الاستيلاء عليها للتجارة مع التجار الفرنسيين. وكان ينزلها كذلك ابن عمه محمد العلي. وفي إحدى مرات نزول ظاهر إلى عكا شاهد ابن عمه محمد في عدد محدود من الحرس فأمسكه ظاهر في خان الفرنساوية، وخرج به من عكا واتجه إلى طبرية، ولم يقدر أحد أن يعارضه. وبعد وصوله طبرية حبسة مدة ثم قتله([10]).
ومما يؤكد رواية عبود بعدم تعرض أحد لظاهر أثناء إلقاء القبض على ابن عمه محمد العلي ما قاله «بوري Porry» قنصل فرنسا في صيدا حيث ذكر في وقت مبكر من سنة 1745م أن ظاهراً يتكلم ويتصرف وكأنه الحاكم الفعلي لمدينة عكا وكل الجليل. وأن ظاهراً أرسل جنوده إلى الخان الفرنسي لألقاء القبض على تاجر كان مديناً له ببعض النقود. وتصف تقارير القنصل في هذه الفترة أن آغا عكا الحاكم الشرعي لها لم يبدِ تدخلاً في الموضوع مع أنه بلا شك لم يكن موافقاً على تصرفات ظاهر الجريئة([11]). ويبدو أن صد ظاهر لحملات سليمان باشا العظم، والسياسة السلمية التي أتبعها خلفه أسعد باشا العظم أدت إلى هذا السلوك الجريء له. والمرجح أن حادث القتل هذا قد تم قبيل استيلاء ظاهر على عكا نظراً لقول عبود الصباغ: «ولما نظر ضاهر ذاته أنه ارتاح من سليمان باشا ومن ابن عمه محمد أراد أن يأخذ عكا»([12])، وبالتالي فإن الحادث قد وقع في منتصف الأربعين. ثـم ضـم ظاهر إثـر ذلك مناطـق الدامـون وشفـا عمـرو إلى حكمه المباشر. وقد شكل هذا الحادث توطيداً للسلطة المطلقة لظاهر العمر داخل الأسرة الزيدانية، وبداية حركة من الاغتيالات والنزاع على الحكم شهدتها العائلة الزيدانية منذ بداية الأربعينات من القرن الثامن عشر حتى نهاية حكم ظاهر العمر سنة 1775م.
د ـ استيلاء ظاهر العمر على عكا:
اتجهت أنظار ظاهر بعد نجاحه بصد حملات سليمان باشا العظم إلى عكا. وخاصة أن ضمه لمناطق الدامون وشفا عمرو تحت حكمه الفعلي أدى إلى جعله مجاوراً للمدينة التي اكتشف أهمية موقعها ونشاطها التجاري كونه كان يتردد دائما عليها لتجارة مع الفرنسيين. وأدرك ظاهر من خلال أقامته الطويلة في طبرية سوء موقعها وأنها لا تصلح أن تكون مقراً دائماً له لعدة أسباب منها:
1 ـ وقوع طبرية على طريق دمشق القاهرة، ولذلك يمكن لوالي دمشق الوصول إليها بسهولة كلما أراد ذلك.
2 ـ كونها محاطة بالجبال العالية وهدفاً سهلاً لمدافع العدو. وانتبه ظاهر لمساوئها الاستراتيجية إبان حملات سليمان باشا العظم.
3 ـ إنها مدينة داخلية مغلقة لا تصلح أن تكون ثغراً يدر عليه الأرباح مثل عكا ذات الميناء المفتوح([13]). إضافة إلى أن عكا تتمتع بموقع أفضل كونها محمية من الجهة الجنوبية والغربية عن طريق البحر، وانقاض حصونها القديمة توفر له مواد بناء كثيـرة لتشييد سور جديد فـي شمال المدينـة وجنوبها. وبالتالي فإن عكا لأسباب دفاعية واقتصادية هي المدينة المناسبة لتصبح عاصمة له([14]).
ويعلل «فولني» استيلاء ظاهر عليها بأنه أدرك أهمية الاتصالات مع البحر، إذ سيصبح ميناء عكا سوقاً عاماً يزدحم بتجار الإفرنج، وسيروج فيه بضائعه ومنتجاته. وعكا تقع بجواره وملائمة لأغراضه، فهو منذ سنوات عديدة يجري فيها أعمالاً تجارية مع وكلاء تجاريين فرنسيين([15]).
ويصف «فولني» عكا قبل استيلاء ظاهر عليها بأنها كومة من الأنقاض وقرية مفتوحة (غير مسورة) بائسة بدون وسائل دفاعية. وأنها تحكم من قبل آغا عينه باشا صيدا ومعه عدد قليل من الجنود لا يملكون الجرأة للتجول في المناطق المجاورة خوفاً من البدو الذين هم الحكام الفعليون وسادة كل البلاد وكل بواباتها([16]). وقال عبود الصباغ: «وكان التزام عكا في ذلك الوقت في يد رجل من صيدا يدعى علي آغا الحمود، يقيم في صيدا ويلتزم من كل وزير يحضر عكا، وبيروت، وصور، وصيدا. ويرسل إلى الأماكن المذكورة متسلمين من طرفه»([17]).
وسعى ظاهر إلى إيجاد الأعذار للاستيلاء على عكا خشية أن يؤدي ذلك إلى إشعال الحرب بينه وبين ولاة الدولة العثمانية في بلاد الشام. وقد وجد الفرصة والحجة مواتية من خلال تصرف آغا المدينة، إذ علم ظاهر بوصول تجهيزات عسكرية يراد استخدامها ضده فرأى وجوب الاستيلاء عليها([18]). بينما ذكر ميخائيل الصباغ أن ظاهراً تذرع بأن مراده حمايتها من القراصنه المالطيين لأنهم كانوا يجوبون تلك النواحي([19]). وأياً كانت الذرائع فإنها تخفي الغرض الأساسي لظاهر وهو عزمه على الاستيلاء عليها لأسباب دفاعية واقتصادية بدل عاصمته الأولى طبريا التي لم تعد مناسبة له.
هدد ظاهر آغا عكا وحذر أهلها من مساندة حاكمها، فهرب الآغا وأهلها ولم يبق فيها سوى التجار الفرنسيين ومن بقى في خانهم من الأهالي تحت حمايتهم([20]). فأرسل ظاهر ثلاثة آلاف من رجاله وتم الاستيلاء عليها([21]). ووفق تقارير القنصل الفرنسي فـي صيدا فـإن ظاهراً استولـى على عكا سنـة 1745م، ولكنه سعى للحصول على شرعية حكمه لها، وتم ذلك في النصف الثاني من سنة 1746م بمنحة التزامها من قبل والي صيدا([22]).
وعلق «فولني» على كيفية حصول ظاهر على التزام عكا من والي صيدا بالقول: «إن ظاهراً أرسل رسالة إلى باشا صيدا بخبرة أن ما حدث هو شأن شخص بينه وبين الآغا، وأنه لم ينقض خضوعه وطاعته التامة للسلطان والباشا. كما أنه سيدفع الضريبة عن المنطقة التي سيطر عليها كما كان يفعل الآغا السابق، كما سيقوم بكبح عربان البدو، وسيفعل كل ما بوسعه للنهوض بهذه البلدة الخربة. وهذا الطلب المرفق بعدة آلاف من النقد الذهبي قد أحدث تأثيره في ديوان صيدا والمجلس السلطاني. فأُخذت الأسباب التي أبداها ظاهر بالحسبان وكل طلباته تم الموافقة عليها. وهذا يتفق مع السياسة العثمانية المألوفة بالصبر ومسايرة الظروف حتى تحين الفرصة»([23]). وحرص ظاهر العمر في هذه الفترة على إرضاء باشا صيدا عن طريق دفع مال الميرى كاملاً دون أي تأخير([24]).
وقام ظاهر بتحصين عكا وبناء سور حولها سنة 1750م([25])، وقد أكدت أبيات شعرية لشاعر مجهول نقشت على السور فوق البوابة البرية هذا التاريخ([26]). كما أن الخوري نقولاس الصائغ نظم أبياتاً من الشعر بمناسبة بناء ظاهر العمر لسور عكا([27]).
وأشار «فولني» إلى تحصين ظاهر العمر لعكا بأنها حين استيلاء ظاهر عليها كانت معدومة الدفاعات، وسهل الهجوم عليها سواء من البحر أم البر. وتحت ذريعة بناء منزل له فأنه شيد في الزاوية الشمالية تجاه البحر قصراً وزوده بالمدافع، ثم بنى أبراجاً عديدة من أجل الدفاع عن الحصن، وأحاط المدينة بسور وترك فيه بابين. وبالرغم من أن «فولني» قلل من قيمة التحصينات التي أقامها ظاهر بالمقارنة مع التحصينات في أوروبا التي قال إنها غير معروفة في الشرق، إلا أنه عاد إلى تدارك الأمر بقوله: أنه في ضوء وسائل الهجوم الضعيفة في الشرق مقارنة مع الغرب، وحيث إن وسائل الدفاع والهجوم الحديثة غير معروفة لدى كلا الطرفين المدافع والمهاجم فإن التوازن يبقى قائماً([28]).
ومما يدل على أهمية عكا بالنسبة لظاهر أنها برزت في ألقابه التي أتخذها مثل «ضابط عكا وبلادها» أو «ضابط عكا وبلاد الجليل». واستخدم ظاهر هذه الألقـاب فـي مراسلاتـه مـع السلطات الفرنسيـة في باريس([29]). ويبـدو أن كلمة ضابط هنا تعني ملتزم الضرائب وليست ذات بعد عسكري([30]).
ففي رسالة إلى وزير الدولـة الفرنسيـة لشئـون البحريـة في 15 ذي الحجة 1166ﻫ/ 14تشرين الأول 1753م وقع أسمه بـ «ظاهر عمر ضابط عكا وبلا د. الجليل»([31]). وظهر توقيع ظاهر بالعربية «ضاهر عمر ضابط عكا وبلادها حالاً» في رسالة أرسلها باللغة العربية إلى رئيس الدولة المالطية في 10 جمادي الأخرة 1165ﻫ/ 25 نيسان 1752م([32]). وأصبحت عكا تحت حكم ظاهر أهم مدن جنوب غرب بلاد الشام من الناحيتين السياسية والاقتصادية، حيث انتقل مركز الجذب من الداخل إلى الساحل([33]).
ﻫ ـ استيلاء ظاهر على حيفا والمناطق المجاورة لها:
كانت حيفـا تتبـع إدارياً لسنجق اللجـون وعجلـون أحد سناجـق ولاية دمشق طيلة القرن السابع عشر وحتى الربع الأول من القرن الثامن عشر. وكانت خلال هذه الفترة ذات نشاطٍ تجاريٍ محدودٍ وعرضة لهجمات القراصنة المالطيين، ومأوى لهـم حتـى أصبـح يُطلـق عليهـا «مالطا الصغـرى». وهذا دفـع الـدولة العثمانية إلى محاولة تحصينها بإقامة برجين بين سنوات 1723 ـ 1725م وعززتهما برجال المدفعية، حيث أصبح من الممكن تقليل اقتراب سفن القراصنة. وقامت في سنة 1723م بفصل حيفا وقرية الطنطورة عن ولاية دمشق وألحقتهما بولاية صيدا. إذ رأت الدولة أن زيادة الأمن في حيفا سيؤدي إلى زيادة نشاطها وتجارتها ومن ثم زيادة دخلها، كما شجعت الدولة بعض سكان السنجق على السكن فيها للحد من هجمات القراصنة وتنشيط الزراعة والتجارة فيها. ومع ذلك بقيت حيفا ذات نشاطٍ محدودٍ بسبب تفوق عكا المجاورة لها([34])
ويبدو من رواية ميخائيل الصباغ أنه بالرغم من ضم ناحية حيفا لولاية صيدا إلا أنها كانت تخضع لنفوذ حكام جبل نابلس أو تحت نفوذهم([35]). ورأى توفيق معمر أن استيلاء ظاهر العمر على حيفا جاء لثلاثة أسباب هي:
1 ـ اقرار الأمن في الخليج الذي كان وقتئذ مأوى القراصنة الأوروبيين.
2 ـ إحكام السيطرة على جبل الكرمل ومناطقه المجاورة التي لم تكن موالية لظاهر العمر مثل وادي الملـح ووادي عـارة وكذلك قـريتي الطيـرة والطنطورة جنوب حيفا.
3 ـ السيطرة على الطريق الساحلية التي تربط حيفا بعكا وتأمين سلامة الطرق بين شمال البلاد وجنوبها([36]).
وجاء استيلاء ظاهر على حيفا لأسباب تجارية أيضاً على اعتبار أن ميناءها مرفأ مكمل لمرفأ عكا حيث أن الرسو فيه أكثر أماناً. وبذلك فإن الاستيلاء عليها مسألة استراتيجية واقتصادية([37]). وعلى الرغم من عدم معرفة التاريخ المحدد لاستيلاء ظاهر العمر على حيفا إلا أنه من الصعب الافتراض أنه قام بذلك قبل الانتهاء من تحصين عكا. وبالتالي يمكن الترجيح أن ضم حيفا قد حدث بين سنتي 1752 ـ 1753م([38]).
وقال عبود الصباغ حول استيلاء ظاهر على حيفا: «وبعده (أي بعد الاستيلاء على عكا وتحصنها) ضاهر أخذ حيفه (حيفا)»([39]).
وأدى اتهام الباب العالي لظاهر بمساعدة قراصنة مالطا إلى ادعاء ظاهر أن طريق حيفا غير محمية، وأن الأعداء قد يتخذون مأوى هناك على الرغم منه، وأنه يحتاج من الباب العالي أن يبني تحصينات هناك، وأن يزودها بالمدافع وذلك على نفقة السلطان. وتمت الموافقة على طلبه ولكن ظاهراً أعلن بعد فترة قصيرة من إنجاز الحصن أن ذلك غير مجد، فهدم الحصن وقامً بنقل مدافع النحاس منه إلى عكا([40]). ويظهر أن الحصن الذي رآه المبشر الألماني «شولص Schultz» عندما مر بحيفا في الأول من أيار سنة 1754م هو الحصن نفسه الذي بناه ظاهر([41]). ورأى ظاهر سنة 1761م أن حيفا لم تعد مكاناً آمناً وذلك إثر هجوم بحري قام به عثمان باشا عليها، فهدم ظاهر حيفا القديمة، وشيد على مسافة كيلومترين أو ثلاثة حيفا الجديدة التي أصبحت في مكان أكثر مناعة من المكان السابق. وجاء الأمر مفاجئاً دون أن يعلم به السكان مسبقاً وخاصة أعداؤه في الخارج([42]).
وقارن الرحالة الايطالي «ماريتيMariti» سنة 1767م بين حيفا الجديدة وحيفا القديمة البائسة الحقيرة التي يتذكرها من زيارته السابقة لها سنة 1760م، فحيفا الجديدة بنيت من بقايا انقاض حيفا القديمة، ويُدافع عنها من جهة البحر بأسوار، وقام ظاهر بتحصينها وتقويتها بقلعة([43]).
وضم ظاهر بعد استيلائه على حيفا المناطق المجاورة لها وخاصة قريتي الطيرة والطنطورة اللتين تتبعان لنفوذ حكام نابلس([44]) وقد حدث خلاف لاحقاً بين ظاهر العمر وعثمان باشا الكرجي والي دمشق حول حيفا وأحيل الخلاف إلى محكمة خاصة عقدت في عكا([45]). وبسيطرة ظاهر العمر على عكا وحيفا وجوارهما انتهت المرحلة الأولى من حركته التوسعية.
وسعى ظاهر إثر ذلك إلى تنظيم أمور البلاد. فقال ميخائيل الصباغ: «فانتظمت حينئذ لظاهر الأمور، وصفت له البلاد، ورتب أحواله في عكا ونظمها»([46]) وأتم ظاهر بذلك بسط سيطرته السياسية والعسكرية على كل الجليل من بحيرة طبرية شرقاً حتى البحر المتوسط غرباً([47]). وعبر المرادي عن ذلك بوصفه ظاهر «حاكم مدينة عكا، شيخ شيوخ البلاد الصفدية»([48]) وشهد الجليل للمرة الأولى منذ وفاة الأمير فخر الدين المعني وحدة المنطقة بكاملها تحت سلطة حاكم واحد باسم والي صيدا وتحت شرعية المؤسسة الحاكمة. وكان لذلك تأثير بعيد المدى على المستقبل السياسي للمنطقة.
تاسعاً ـ علاقة ظاهر العمر بعرب الصقر:
شهدت الفترة الأولى من حكم ظاهر العمر تحالفاً بين الشيخ ظاهر وعرب الصقر، وقد أورد ميخائيل تفاصيل هذا التحالف من حيث الأسباب والكيفية إذ بدأ التحالف بتقارب عرب الصقر مع الشيخ ظاهر إثر قيام والي صيدا بإصدار أمر إلى ابن ماضي شيخ مشايخ نابلس يأمر بالإيقاع بعرب الصقر، بعد أن ازدادت شكاوى السكان إلى والي صيدا من كثرة تعديهم على الطرق. وكان هذا غاية مراد الشيخ ابن ماضي فاستغفل عرب الصقر وأوقع بهم مراراً، فاتجهوا إلى التحالف مع ظاهر العمر وجعله رئيساً عليهم من أجل غزو بلاد نابلس([49]). ويبدو من سياق رواية ميخائيل الصباغ أن ذلك تم في أواخر العشرين أو بداية الثلاثين من القرن الثامن عشر. ورحب ظاهر العمر بهذا التحالف من أجل مواجهة أعدائه والقضاء عليهم([50]). إضافة إلى اضطراره إلى التعامل مع عرب الصقر أقوى القبائل العربية في بلاد صفد في ذلك الوقت ولا سيما في الفترة الأولى من تأسيس قوته، تلك الفترة التي شهدت سيطرة البدو على الطرق الرئيسية([51]). وقد استعان بهم ظاهر العمر في الاستيلاء على قلعة جدين والمناطق المجاورة لها، واضطر أمام تعهداته إلى والي صيدا وكذلك للسكان القاطنين في المناطق التي سيطر عليها بفرض الأمن في مناطق حكمه إلى الاصطدام مع حلفائه عرب الصقر([52]). فقد اختلفت المصالح وتناقضت الأهداف بين الطرفين، فظاهر العمر سعى إلى إقامة حكم قوي وإدارة مركزية تقوم على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار من أجل انتعاش اقتصادي يطمح إليه. أما مصالح عرب الصقر فتقوم على اضطراب الأمن وعدم مركزية السلطة ذلك يتيح الفرصة لقطع الطرق وفرض الإتاوات على المسافرين والقرى وغزوها للسلب والنهب. وإثر ذلك تفككت عرى هذا التحالف الذي صار قائماً على مصالح متناقضة، فأنقلب عرب الصقر على حليفهم ظاهر. وقال ميخائيل الصباغ حول ذلك: «وكان عرب الصقر قد حقدوا على ظاهر لأنهم هم الذين قاموا أولاً بناصره (بنصره) وبهم ارتفع شأنه، ولما تولى البلاد واستتب له الأمر رفع يدهم ومنعهم من السلب والنهب في الطرقات، ومن عوائدهم التي كانوا يأخذونها من كل البلدان التي دخلت بعد ذلك في حكمه»([53]). واستجاب عرب الصقر لدعوة أعدائهم السابقين حكام جبل نابلس بقيادة آل جرار وآل ماضي بالتحالف ضد ظاهر، لكنهم تلقوا هزيمة نكراء في معركة الروحة سنة 1735م ثم تحالف عرب الصقر مع سليمان باشا العظم والي دمشق في حملاته ضد ظاهر العمر في الفترة بين 1737 ـ 1743م([54]). وسلموا سليمان باشا أخاً لظاهر قاموا بأسره (اختلفت المصادر حول اسمه)([55]). وقام سليمان باشا بقتله في دمشق سنة 1737م([56]).
وتناول عبود الصباغ العلاقة بين ظاهر وعرب الصقر نتيجة هذا الحادث بقوله: «واشتدت العداوة فيما بين ظاهر وعرب الصقر الذين سلموا أخاه صالح لوزير الشام إلا أنه بعد مدة من الزمان ركب ظاهر على عرب الصقر وقتل منهم خمسة وثمانين أمير وابن أمير ولا زال كل سنة من الحرب إما مع العرب المذكورين إما مع الفلاحين»([57]). كذلك أشار حنا سمارة إلى حروب ظاهر المتعاقبة مع عرب الصقر([58]).
وتخلل حروب ظاهر مع عرب الصقر فترات من الصلح، فقد أشار ميخائيل الصباغ إلى قيام صلح بين الطرفين عاد عرب الصقر بموجبه إلى منازلهم السابقة بين جبل نابلس والناصرة بعد أن غادروها إثر هزيمتهم مع حكام نابلس في معركة الروحة. ورد ظاهر إليهم أراضيهم التي كان قد استولى عليها وأقطعهم بجوارها نصفها أيضا بشرط ألا يعـودوا إلى أفعالهم السابقـة. حيث كان ظاهر معنياً باستمرار التحالف معهم ضد أي غـدر أو مكـر مـن رجال الدولـة([59]). إذ حرص قدر استطاعته على إبقاء علاقاته وطيدة مع عرب الصقر وغيرهم من البدو كتحالف يضمن له جبهة قوية تسانده ضد ولاة الدولة العثمانية عند الحاجة. ونوه «فولني» إلى فترة الصلح هذه بالإشارة إلى استقبال ظاهر العمر في عكا بعد الاستيلاء عليها شيوخ عرب الصقر وزودهم بالأسلحة والملابس([60]).
إلا أن تناقض مصالح الطرفين ساهم في إعادة التوتر بينهما، فقد استمر عرب الصقر في التعديات على الطرق والنهب، ودعموا الخلافات داخل الأسرة الزيدانية، فساندوا سعداً أخا ظاهر العمر في محاولة تمرده ضد أخيه، ثم ساندوا عثمان بن ظاهر العمر ضد أبيه. كما قامـوا بقتل حفيد ظاهر العمر من ابنه عثمان. وهذا دفع ظاهر إلى القيام بحملات تأديبية مستمرة ضدهم في أواخر الخمسين وبداية الستين حيث حالفه فيها النصر واستطاع قتل شيخهم رشيد الجبر([61]). وظل الصراع مستمراً بين الطرفين إلا أن ظاهراً سمح لهم برعى ماشيتهم في منطقة طبرية([62]). ولم يمنع هذا من استمرار عدائهم له إذ ساندوا في سنة 1771م والي دمشق عثمان باشا الكرجي ضد ظاهر وأحلافه المصريين أثناء الحملة المصرية الأولى على بلاد الشام بقيادة اسماعيل بك([63]). ثم استقر عرب الصقر أخيراً في منطقة قيسارية([64]).
وعلى هذا النحو فإن علاقة ظاهر العمر بعرب الصقر تأرجحت بين التحالف في بداية صعوده السياسي وبين العداء الدموي في منتصف الثلاثين حتى نهاية حكمه، وتخلل ذلك فترات قصيرة من المصالحة والهدوء بين الطرفين. وقد منع تناقض المصالح إقامة تحالف دائم بينهما ربما كان الطرفان في حاجة ماسة إليه.
عاشراً ـ علاقة ظاهر العمر بالقوى البدوية الأخرى:
إن سيطرة ظاهر العمر على الجليل تعني في الواقع سيطرة تدريجية على منطقة توجد فيها قبائل ذات نفوذ كبير، وتعتبر الحاكم الفعلي للمناطق، فقد كان حكام المدن مثل عكا مثلاً لا يتعدى حكمهم أسوار المدينة([65]). بينما كانت السيطرة على الطرقات والمناطق الداخلية في يد الزعماء البدو الذين قاموا بعمليات السلب والنهب وقطع الطرق، وفرض العوائد على القرى. وبالتالي توقف صعود ظاهر العمر في البداية على التعاون الوثيق مع أكبر القبائل البدوية قوة في الجليل «بنو صقر» الذين تحالف معهم كما سبق الحديث، ولكن عندما أصبح واضحاً لهم إن ظاهراً يريد تأسيس حكم قوي مركزي في البلاد ابتعدوا عنه، ودعموا معارضيه وحاربوه([66]).
وسعى ظاهر العمر إلى التقرب من القبائل والقوى المحلية الأخرى، فصاهر عبد الخالق صالح صاحب قلعة البعنة، واستطاع عبر هذه المصاهرة أن يسيطر على القلعة. وارتبط بعلاقات مصاهرة مع قبيلة السردية باعتبارهم أخوالاً له، إذ كانت أمه منهم. كما أقام في شبابه علاقات مع فرسان العرب الذين كان يخرج معهم للصيد ويتعلم منهم الفروسية.
وعندما كبر أولاده زوجهم من القبائل البدوية، واعتبر أن هذا التحالف يشد أزره، ويحقق مهابة ولاة الشام منه، ويكون الملجأ الآمن له إذا حورب وانكسر، إضافة أنه يستطيع عبر هذا التحالف جلب الخيول الممتازة التي كان مغرماً بها([67]).
واستقبل ظاهر إثر استيلائه على عكا شيوخ قبائل عنزة والسردية. وزودهم بالأسلحة والملابس، فقد سلحهم ببنادق من نوع «مسكيت Muskets» حديثة ومسدسات بدلاً من الأقواس وبنادق الفتيل([68]). وهذا يشير إلى تحالفات سياسية وعسكرية بين ظاهر وبين هذه القبائل. كما ارتبط بعلاقات تحالف مع عرب بني صخر وأمدهم بالسلاح([69]). وذكر الرحالة «ماريتي Mariti» أن ظاهراً أعطى مصادقته على قيام بني صخر بمهاجمة قافلة الحج في سنة 1757م بعد أن استاء من والي دمشق (حسين باشا مكي) الذي رفض وساطة ظاهر بينه وبينهم، تلك الوساطة التي طلبها عرب بني صخر. وسمح لهم ظاهر ببيع غنائمهم في أراضيه متحدياً بذلك أوامر السلطان العثماني. وعندما تمت مراجعته من قبل البلاط العثماني في ذلك قال: «إن البدو اصدقائي وهم مؤهلون للحصول على مساعدتي وحمايتي كلما أقتربوا مني للحصول على الملجأ و المأوى. وعلاوة على ذلك فإنني أعرف أنهم سيكونون قادرين على الدفاع عني إذا أقتضت الضرورة ذلك: فكلمة واحدة مني سوف توحدهم جميعاً تحت رايتي»([70]) وبالرغم من أن قول ظاهر العمر فيه مبالغة لا سيما في الجزء الأخير منه بأنه يمكنه الاعتماد على تحالف جميع قبائل البدو تحت رايته. إلا أن ذلك لا يمنع قدرته على الاعتماد على دعم بعض القبائـل علـى الأقـل، إذا اقتضت الضـرورة. وبالتالـي فليس هناك ما يمنع مساعدته لهم عندما يجدون أنفسهم في ظروف صعبة([71]). وقال كرد علي حول ذلك: «ودخلت عرب البادية تحت حكمه»([72]). وفي ذلك إشارة إلى تحالفات ظاهر مع القبائل البدوية.
وأدى تعهد ظاهر إلى والي صيدا طبقاً لشروط نظام الالتزام بحماية المناطق التي يلتزمها من العربان([73]) إضافة إلى تعهده بحماية الأهالي الذين دخلوا في حكمه([74])، وفـوق ذلك سعيـه إلى إقامـة حكومـة مركزيـة قويـة، وتوفـير المناخ المناسب لازدهار الزراعة والتجارة التي اعتمدت عليها قوته الاقتصادية، وإلى بذل قصارى جهده لمنع أي تعديات من البدو على الطرقات والفلاحين، وعمل على إبعاد القبائل البدوية عن الطرقات الرئيسة والسهل المجاور لعكا([75]). وقال الرحالـة الايطالـي ماريتـي Mariti: «إن الحكومـة الآمنـة التي أقامهـا ظاهر، وإبعاده البدو عن المناطق التابعة له جعلت كل الطرق إلى الجليل آمنة للمسافرين. وبناءً على قناعتي أنني لن أواجه مخاطر فاعتقدت برغبة قوية بزيارة كل الأماكن البارزة في مناطق حكمه... وقد أُخبرت أن مرشداً واحداً كافياً لي خلال رحلتي»([76]). ويعتبر قول ماريتي الذي زار وتجول في معظم المناطق والطرق الرئيسة في عهد ظاهر في الفترة بين 1760 ـ 1767م أكبر دليل على مدى انتشار الأمن في الطرق الرئيسة بعد أن كان السفر قبل حكم ظاهر العمر غير ممكن بدون حماية خمسين فارساً مسلحاً خوفاً من اللصوص وقطاع الطرق. واتبع ظاهر سياسة الشد والقوة تجاه القبائل التي استمرت في عمليات السلب والنهب والقتل مثل قبيلة بني صقر وغيرها في الوقت الذي اتبع سياسة أكثر ليناً تجاه القبائل التي لم تتدخل بحركة السير على الطرق الرئيسة([77]). فذكر «ماريتي Mariti» قيام ظاهر العمر بقتل أفراد قبيلة من الأكراد تقيم بين عكا والكرمل بسبب تعديها على سفينتي حجاج أوروبين دفعتهم العواصف إلى الشاطئ. إذ قام أفراد القبيلة بنهب وسلب وقتل الحجاج الناجين، ولم يُبْقوا من مائتي حاج نجوا من الغرق سوى اثنى عشر حاجاً بينهم افراد طاقم السفينتين الذين استطاعوا الهرب إلى عكا([78]).
وكانت بعض قبائل البدو تستغل فترات الاضطراب التي تحدث في البلاد للعودة إلى السلب والنهب، ففي سنة 1763م مثلاً عندما كان ظاهر العمر منشغلاً بحركة تمرد من قبل أبنائه، استغل بعض البدو ذلك فهاجموا دير الكرمل ونهبوه، وهرب الرهبان إلى عكا. ولم يعد الرهبان إلى ديرهم إلا بعد انعقاد الصلح بين ظاهر وأبنائه واستتباب الأمن مرة ثانية([79]).
وحافظ ظاهر على علاقات وطيدة مع القبائل البدوية بالرغم من التوتر الذي كان يسود أحياناً بين الطرفين. وهذا لا يعود فقط إلى أصوله القبلية أو العلاقات الأسرية، بل أيضاً لمصالح عملية ونفعية صرفه، فقد ساعدته القبائل البدوية في صعوده وحكمه وساندوه في حملاته العسكرية. فقد دعم عرب الصبيح (يرجح أنهم من أحفاد الصبيحيون الذين يعودون بنسبهم إلى بني زريق من ثعلبة الطيئ القحطانية ويقيمون على أطراف جبل طابور الشمالي)([80]) ابنه أحمد أثناء حملاته على حوران. كما سانده البدو في محاصرة القدس سنة 1773م ومنعوا وصول الإمدادت إليها([81]).
ونجد المنفعـة المتبادلـة أيضاً في سماح ظاهـر لبنـي صخـر وحلفائهم ببيع غنائمهم من قافلة الحاج التي سلبوها في أراضيه، وقد استفاد بنو صخر وأحلافهم مـن تخلصهـم مـن هـذه الغنيمـة بأسعار مناسبـة فـي الوقت الذي لا يستطيعون فيه بيعها في مناطق الحكام والولاة الآخرين، بينما استفاد ظاهر العمر من ذلك تجارياً إضافة إلى قيام بني صخر بإهداء كل الخيول التي نهبوها من القافلة إليه تقديراً واعترافاً بصداقته([82]). ويبدو أن هناك مجموعة قوية ومتشابكة من المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين ظاهر وبين البدو، ولكن في الوقت نفسه كان هناك أيضاً قدر كبير من الخلاف بين الجانبين. ولكن أبدى ظاهر على أي حال استعداداً للسماح للبدو بنصيب في الحكومة الفعلية للبلاد. ولكن في الوقت نفسه كان مصمماً على تجريدهم من الحق الذي افترضوه لأنفسهم بجباية الخفارة من المسافرين والعوائد من القرى في المناطق التي يترددون عليها. ولكن هناك بعض الشك في أن ظاهراً استمر طوال فترة حكمه في اعتبار البدو ليس أعداءً بل أقارب وأصهاراً له. وبدا أنهم اعتبروه كذلك أيضاً([83]).
وجمع ظاهر في سياسته تجاه القبائل البدوية طيلة فترة حكمه اساليب الملاطفة والتهديد والقتال([84])، ونظر إليهم بصفتهم حلفاء عند الحاجة، وملجأ في وقت الشدة، ولذلك نجده يلجأ إلى عرب عنزة عندما هاجم محمد بيك أبو الذهب بلاده في آذار 1775م في الوقت الذي تخلى عنه حلفاؤه من الشهابين والمتاولة([85]).
p p p
الفصل الثالث
علاقة ظاهر العمر
بالقوى السياسية المجاورة في بلاد الشام
بدأ ظاهر العمر سلطته ملتزماً على مناطق طبرية وعرابة البطوف والدامون في الثلث الأول مـن القرن الثامن عشر. وكانت سلطتـه في هذه المرحلـة محدودة على الصعد كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وقد ارتبط خلالها بوالي صيدا باعتباره أحد ملتزمي الولاية. ويستمد سلطته وشرعيته من الوالي الذي يعتبر أحد مراكز القوة في جنوب بلاد الشام.
وأدت حركة التوسع التي قام بها ظاهر العمر في فترة الثلاثين والأربعين إلى بروزه كقوة سياسية رئيسية في بلاد الشام. وأصبحت عاصمته عكا من أهم المراكز السياسية، وزاحم القوى السياسية الأخرى النفوذ والسيطرة في بلاد الشام. وتفوق عسكرياً على مسؤوله المباشر، فأحدث ذلك تحولاً في طبيعة العلاقة بين الطرفين، إذ أصبح ظاهر العمر صاحب النفوذ القوي في الولاية.
وجاءت تعديات ظاهر العمر على سنجق اللجون وعجلون الذي يشكل أحد سناجق ولاية دمشق كبرى ولايات بلاد الشام وأكثرها نفوذاً وأهمية بداية الاحتكاك بين قوته الطموحة والمتنامية وبين ولاة الولاية. وتنازعت القوتان على بسط النفوذ والسيطرة على جنوب غرب بلاد الشام. وساهم عجز والي صيدا عن مواجهة ظاهر العمر في انتقال زمام المبادرة تجاه ذلك إلى والي دمشق. وصار ولاة دمشق يمثلون سياسة الباب العالي في مواجهة تعاظم قوة ظاهر العمر التي شكلت مصدر قلق للباب العالي وللقوى السياسية الأخرى في المنطقة. وشهدت العلاقة بين ظاهر العمر وولاة دمشق مراحل عديدة من الصراع تخللها فترات من التعايش السلمي وعدم الاحتكاك تبعاً لقوة الولاة وسياستهم ومدى تطبيقهم لسياسة الباب العالي.
وكانت حدود ظاهر العمر الشمالية تتاخم حدود جبل عامل الذي يحكمه المتاولة، وقد شكلوا قوة سياسية ذات نفوذ في جنوب غرب بلاد الشام. وتبدلت العلاقة بين ظاهر العمر والمتاولة وفق الظروف السياسية التي شهدتها المنطقة. وانتقل الطرفان من حالـة الصراع إلى مرحلـة مـن التحالف الوثيـق استمر حتى قبيل نهاية ظاهر العمر حيث ساهمت عوامل سياسية أخرى في تفكك عرى هذا التحالف.
واستطاع الشهابيون الذين خلفوا المعنيين في حكم جبل الشوف في نهاية القرن السابع عشر تكوين قوة سياسية وعسكرية لها وجودها القوي في بلاد الشام. واتخذوا من ديرالقمر عاصمة لهم. وقاسم الشهابيون ظاهر العمر النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي في جنوب غرب بلاد الشام. ومرت العلاقات بين الطرفين بمراحل عديدة طبقاً لأهداف ومصالح كلٍ منهما.
كان من الطبيعي أن تتفاعل القوة السياسية والعسكرية التي أقامها ظاهر العمر مع القوى السياسية المجاورة. فكل قوة من هذه القوى كان لها مصالحها وأهدافها الخاصة. وتنافست فيما بينها على النفوذ والسيطرة في جنوب بلاد الشام. وأقامت هذه القوى تحالفات وتكتلات من أجل إحداث التفوق العسكري على الطـرف المقابـل. وشهـدت فـترة السبعيـن مـن القـرن الثامن عشر احتدام الصراع بين هذه القو