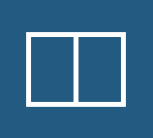التقسيم الإداري لبلاد الشام في العهد العثماني
التقسيم الإداري لبلاد الشام في العهد العثماني
كتب الأستاذ الدكتور خالد محمد صافي حول هذا الموضوع في كتابه " ظاهر العمر الزيداني حاكم الجليل في القرن الثاني عشر ( 1689-1775 م) والذي صدر عن دار المقتبس في بيروت سنة 1439هـ-2018 م
فقال :
أ ـ التقسيم الإداري حتى سنة 1660م:
استقر تقسيم العثمانيين لبلاد الشام بُعيد فتحهم لها إلى ثلاث ولايات هي ولاية الشام (دمشق)، وولايتا حلب وطرابلس. وكان هذا التقسيم بخطوطه العامة استمراراً للتقسيم الإداري في السلطنـة المملوكيـة. ووفق إحصاء الكاتب السلطاني عيـن علـي أفنـدي سنة 1609م فإن ولايـة دمشق كانت تضم عشرة سناجق، والسنجق وحدة إدارية ضمن الولاية، وتشتق التسمية من العَلَم (في التركية سنجق وبالعربية لواء) الذي يُحمل أمام حاكمه. ومن هنا عرف السنجق بلقب سنجق بك بالتركية وأميـر لـواء بالعربيـة، وعرفـت المنطقـة التي يحكمها بالسنجق أو اللواء. وسناجق ولاية دمشق هي: القدس الشريف، ودمشق، وغزة، وصفد، ونابـلس، وعجلـون، واللجـون، وتدمـر، وصيـدا وبيـروت، والكرك والشوبك. وتحتـوي ولايـة طرابلس على خمسة سناجق. أما ولايـة حلب فتضم سبعة([1]). ويقسم السنجـق إلـى وحدات إداريـة أصغـر تدعـى نواحـي، وتضم النواحي القرى والمدن التي تشكل الأجزاء الرئيسة لها([2]).
وكانت الحدود بين الوحدات الإدارية المختلفة تتبع معالم طبوغرافية بارزة (مياه ـ طريق، جبال... الخ) وهي نادراً ما تحدد قسرياً. وينطبق ذلك على الحدود بين الولايات والسناجق والنواحي، وسبب ذلك غياب وجود خرائط دقيقـة، فليس مـن وسيلـة لرسم الحـدود سوى المعالـم الطبوغرافيـة البارزة. ولا تحدث أي تغييرات أرضية في الولاية دون الموافقة المسبقة من إستانبول([3]).
وغالباً ما عين العثمانيون على كل ولاية وزيراً أو باشا بثلاثة أطواخ. (والطوخ هو ذيل حصان معلق في سارية وفي أعلاه كرة ذهبية. وكانت الأطواخ تؤخذ في الأصل من ذيول الياكات (جمع ياك وهو ثور التبت) وليس من ذيول الخيـل. وكان لبكـوات السناجـق الحـق فـي رفـع طـوخ واحد، فـي حيـن أن البكلربكوية (بيكربكي تعني بك البكوات أي أمير الأمراء وهو لقب إداري عثماني). كان لـه الحق فـي طـوخين، والـوزراء ثلاثـة أطـواخ، بينما يحق للصدر الأعظم رفع خمسة، وتتقدم موكب السلطان في زمن الحرب سبعة أو تسعة أطواخ([4]). وكانت التوجيهات بالمناصب الكبيرة تعييناً أو تجديداً في أوائل شهر شوال من كل عام([5]).
وكان الوالي ممثل السلطان في الولاية، ويجمع في يده السلطة الحربية العليا والسلطة المدنية ولكن بالرغم من سلطاته الواسعة الا أن السلطان كان يعين موظفين لا يخضعون له، بل يراقبون أعماله مثل الدفتردار (كلمة تركية مكونة من كلمتين «دفتر» وتعني السجل و «دار» أي حامل، فأصبح معناها الموظف المالي الكبير، ويعتبر ثاني شخصية بعد الوالي في الولاية)([6])، وقاضي القضاة وآغوات الإنكشاريـة. وهذه الإدارات كانـت تـحد من إشراف الـوالي وسلطتـه. ويتمتع الدفتردار وقاضي القضاة بحق، ارسال احتجاجات وعرائض ضد الوالي إلى إستانبول التي نادراً ما كانت عديمة المفعول([7]).
وتميزت الإدارة العثمانية بكثرة تغيير الولاة، ففي خلال المائة والثمانيين سنة الواقعة بين سنتي 1517 ـ 1697م تولى ولاية دمشق مائة وثمانية وثلاثون والياً، استطاع ثلاثة وثلاثون فقط الاحتفاظ بمنصبهم لمدة عامين. ويعود سبب التغيير إلى أن المنصب كان يباع ويشترى هذا إضافة إلى خشية الدولة من توطيد الولاة لنفوذهم في الولايات([8]).
ب ـ إنشاء ولاية صيدا:
أقدمت الدولة العثمانية بعد انتصارها على فخر الدين المعنى الثاني وفراره إلى «توسكانا Tuscany» سنة 1613م إلى فصل سنجقي صفد، وصيدا وبيروت، (اللذين كانا يحكمان من قبل فخر الدين وعائلته ويتبعان إدارياً ولاية دمشق) وجعلهما ولاية جديدة باسم «صيدا ييكلر بكي». وقد تم انشاء ولاية صيدا بموجب فرمان صدر من السلطان العثماني إلى والي دمشق أحمد باشا في 28 محرم 1023 ﻫ / 10 آذار 1614م([9]). وأشار الخالدي الصفدي إلى أن الدولة العثمانية أرسلت بعد رحيـل الأميـر فخـر الدين «بستانجي حسن باشا» ليتولى على صفد وبيروت وصيدا وأغزير وجميع ما كان بيد الأمير من بلاد على طريق البكلربكية. واتخذ حسن باشا صفد مقراً له، ثم انتقل الى صيدا وأخيراً نُقل إلى ولاية «قرمان». وأحال الصدر الأعظم محمد باشا وبتدخل والي دمشق جركس محمد باشا سنة 1615م سنجق صيدا وتوابعها الى الأمير علي المعنى، وثبت الأمير يونس المعنى على سنجق صفد([10]). ويرجح ذلك أن ولاية صيدا قد ألغيت بعد سنة من إنشائها، وأن سنجقيَّيها قد أعيدا إلى ولاية دمشق، حيث إن انقياد أمراء آل معن للسلطنة العثمانية بعد هرب فخر الدين المعني أدى الى جعل استمرار الولاية غير ضروري. ويبدو أن ولاة دمشق رأوا في إنشاء ولاية صيدا ما يحد من نفوذهم ومداخيلهم، ولذلك ضغطوا من أجل إعادتها الى حكمهم([11]).
أعاد الصدر الأعظم محمد باشا كوبريلي «Koprulu» إنشاء ولاية صيدا سنة 1660م، وجعل عليها حاكماً علي آغا الدفتردار. وجاء تشكيل ولاية صيدا نتيجة عدة وقائع منها حرص الدولة على مراقبة أمراء جبل لبنان عن كثب بعد ثورة فخر الدين المعنى الثاني، ومحاولة الحد من سلطة ولاة دمشق خوفاً من اتساع نفوذهم([12]). وقال الدويهي: «... وحتى يحطم ذراع أولاد العرب عمل صيدا باشوية وكتبها على باشا الدفتردار»([13]).
وامتدت ولاية صيدا من نهر الكلب شمالاً حتى جبل الكرمل جنوباً، وضمت جانباً كبيراً من مدن بلاد الشام البحرية مثل بيروت، وصيدا، وصور، وعكا إلى جانب المقاطعات الخاضعة لأمير جبل لبنان، ومقاطعات جبل عامل، والجليل. وشكلت مدينة صيدا مركز الولاية([14]).
وذكر الرحالة التركي «إيفيليا شلبي» في زيارته الثانية لبلاد الشام سنة 1670م أن ولاية صيدا تتكون من ألوية (سناجق) بيروت، وصفد، وعكا، وطبرية، وصيدا، وجبل معن([15]). ولكن «كوهين» أشار إلى أن تقسيم ولاية صيدا إلى سناجق لم يكن واضحاً خلال القرن الثامن عشر، وأنه خلال دراسته لآلاف الوثائق العثمانية في القرن الثامن عشر بدا أن ولاية صيدا كانت مقسمة إلى وحدات إدارية أصغر من السناجق وهي النواحي. وبرز استخدام ناحية اقليم التفاح سنة 1705م، وناحية عكا سنة 1711م، وناحية الجيرة وترشيحا سنة 1758م، وناحية شفا عمرو سنة 1764م. وأن ولاية صيدا قد ضمت خلال القرن الثامن عشر النواحي التالية: إقليم التفاح، وإقليم الشومر، وإقليم الشقيف، وبلاد بشارة، ومرجعيون، وسهل عكا، وشفا عمرو والناصرة، وصفد والرامة، والجيرة، وحيفا وياجور، وسهل عتليت([16]) وعلاوة على ذلك كان هناك المقاطعات الحضرية: بيروت، وصيدا، وصور، وعكا. وبالرغم من عدم وجود اختلاف أساسي بين النوعين من المقاطعات إلا أن المقاطعات الحضرية كانت أصغر كثيراً، وقد جاء وضعها الخاص من حقيقة أنها جميعاً موانيء تجارية. ومن الجدير بالذكر أن ناحية حيفا قد ضمت الى ولاية صيدا سنة 1723م([17]).
وكان ولاة دمشق يعينون عادة من بين حملة رتبة وزير بثلاثة أطواخ فيما جرت العادة أن يعهد بولاية صيدا الى باشا بطوخين وأحياناً بثلاثة أطواخ([18]). وكانت ولاية صيدا في وقت الأزمات السياسية والعسكرية تخضع فعلياً وليس نظرياً لولاة دمشق. ولكن ولاية صيدا اكتسبت أهمية غير متوقعة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر بسبب التطورات السياسية التي حدثت فيها إضافة إلى نشاطها التجاري مع الأوروبيين([19]). وأشار قسطنطين الباشا الى أن عسكر ولاية صيدا الذي يأتمر بأمر الباشا يتكون من خمسمائة من الخيالة أو الفرسان، وخمسمائة من المشاة. وكان بإمكان الوالي زيادة العدد إلا أنه تخفيفاً لثقل معاشهم كان يكتفي بنصف هذا العدد. ولم تكن ولاية صيدا تحتوي على عساكر محلية مثل ولاية دمشق، ولعل ذلك يعود إلى قلة شأن الولاية ولعدم ثقة الباشا بالأهالي، ومن ثم شمل عسكر الولاية أخلاطاً من الأرناؤوط، والأكراد، والتركمان، ومن أهل بغداد وهم الخيالة، وكان المشاة غالباً من المغاربة([20]).
([1]) خليل ساحلي أوغلو ـ قوانين آل عثمان لعين علي أفندي، دراسات، مجلد 14، عدد4، عمان، 1987، ص120، 170. رافق ـ فلسطين في العهد العثماني، ص 699.
([4]) الغزى ـ نهر الذهب، ج1، ص315. جب، وبوون ـ المجتمع الاسلامي، ج1، ص197. Huart, Cl. ـ Tugh. E. I. , P. 820.
([5]) أحمد عزت عبدالكريم ـ التقسيم الإداري لسورية في العهد العثماني، حوليات كلية الآداب، مجلد 1، القاهرة، 1951، ص141.
([12]) جب، وبوون ـ المجتمع الاسلامي، ج2، ص35. رافق ـ بلاد الشام، ص194. الشيخ ـ في تاريخ العرب الحديث، ص123.