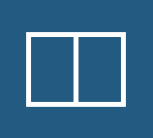القوى السياسية في جنوب وجنوب غرب بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر
القوى السياسية في جنوب وجنوب غرب بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر
كتب الأستاذ الدكتور خالد محمد صافي حول هذا الموضوع في كتابه " ظاهر العمر الزيداني حاكم الجليل في القرن الثاني عشر ( 1689-1775 م) والذي صدر عن دار المقتبس في بيروت سنة 1439هـ-2018 م
فقال:
شهد جنوب وجنوب غرب بلاد الشام في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر بروز قوى سياسية لعبت دوراً مهماً في الحياة السياسية في القرن الثامن عشر، وقد ساد التنافس بين هذه القوى على النفوذ والسلطة، وأهمها:
أ ـ الشهابيون:
يعود نسب الشهابيين إلى مالك الملقب بشهاب من سلالة مرة بن كعب الذي يعود نسبه إلى معد بن عدنان. ومالك (الملقب بالحرث أيضاً) أقره الخليفة عمر بن الخطاب أميراً في حوران، وقد انتقل بأقاربه وعشيرته إليها([1]). وحكم الشهابيون إقليم وادي التيم المكون من راشيا وحاصبيا أثناء الحكم المعني في جبل لبنان وجبل الدروز. وقد ضعفت الأسرة المعنية إثر وفاة الأمير فخر الدين المعني الثاني، ثم تلاشت سنة 1697م بوفاة الأمير أحمد المعني الذي لم يترك عقباً وانقطعت به السلالة المعنية. فاجتمع أعيان جبل الدروز أو الشوف الذي كان يضم في هذه الفترة معاملة صيدا التي تمتد من نهر الأولي قرب صيدا جنوباً حتى وادي أو جسر المعاملتين قرب جونية شمالاً، وتشاوروا في الأمر، واختاروا الأمير بشير ابن الأمير حسين أمير راشيا لأنه كان ابن شقيقة الأمير أحمد المعني زعيماً لهم. ثم اتجهوا إلى راشيا مقر حكمه في وادي التيم ودعوه للحكم. وقد جاء معهم الأمير بشير إلى دير القمر قاعدة جبل الشوف، ووضع مكانه حاكماً على راشيا ابن أخته الأمير منصور. ووافق والي صيدا مصطفى باشا على ذلك وأرسل يطلب رد الباب العالي. ولكن الدولة العثمانية ردت على ذلك بأن يكون حيدر بن موسى الشهابي الحاكم على المقاطعات التي كانت بيد آل معن باعتباره الأحق بالوراثة لكونه ابن ابنة الأمير أحمد المعني، وأن يكون الأمير بشير حاكماً بالوكالة عن الأمير حيدر البالغ من العمر 12 عاماً حتى يبلغ الرشد. وتم ذلك في إستانبول بإيعاز من الأمير حسين بن فخر الدين الذي نُقل إلى إستانبول بعد مقتل أبيه فخر الدين([2]).
ويسترعي الانتباه في اختيار الأمير بشير الشهابي أن مشايخ جبل الشوف هم الذي اجتمعوا وأقروا ذلك، في حين أن أول أمير معني على جبل لبنان قد عُين من قبل السلطان سليم الأول. ويظهر من هذا أن مشايخ جبل الشوف كانوا أصحاب سلطة، كما يلاحظ أن القاسم المشترك الذي جمع بين المشايخ الذين اختاروا هو أنهم قيسية على الرغم من أنهم ضموا ممثلين من مختلف المذاهب. ويؤكد ذلك قوة التعاطف القيسي الذي طغى على الاختلافات المذهبية، فاختير الشهابيون السنة خلفاء للمعنيين الدروز. وطبيعي أنه ساعد على ذلك صلة القربى بين الأسرتين المعنية والشهابية([3]).
حارب الأمير بشير سنة 1698م مشرف بن علي الصغير أحد شيوخ المتاولة بناءً على طلب قبلان باشا([4]) والي صيدا الذي منحه مقابل ذلك بلاد صفد مع مقاطعات المتاولة الثلاث في جبل عامل، وهي: مقاطعات ديار بشارة، وإقليمي الشومر والتفاح ومقاطعة شقيف([5]). وأشار ذلك إلى محاولة الشهابيين توسيع نفوذهـم، ووضعهـم أنفسهم منـذ البدايـة في خدمـة باشا صيـدا ممثـل السلطة العثمانية([6]).
وتوفي الأمير بشير سنة 1705م بدس السم له من قبل الأمير حيدر كما أفادت بعض المصادر، بعدما بلغ الأمير حيدر سن الرشد وطلب الحكم. واجتمع شيوخ جبل الشوف ووضعوا مقاليد الأمارة في يد الأمير حيدر، والتمسوا منه النهوض إلى مقر الحكم في دير القمر حسب الأمر السلطاني الصادر([7]). ويبدو أن والي صيدا بشير باشا أراد الحد من نفوذ الشهابيين بعد مقتل الأمير بشير فرفع يدهم عن مقاطعات صفد وجبل عامل، ولم يبق تحت حكم الأمير حيدر سوى جبل الشوف وتوابعه([8]).
وعمل الأمير بشير أثناء فترة حكمه على رفع شأن القيسية والقضاء على اليمنية، واستفحل الصراع بين الطرفين (هذه العصبية التي تعود جذورها إلى العصر الجاهلي) إثر وفاة الأمير بشير وتعيين الأمير حيدر. وقد بدا أن والي صيدا والدولة العثمانية أرادا انتزاع السلطة من الشهابيين في جبل الشوف لصالح آل علم الدين اليمنية، فعين والي صيدا بشير باشا محمود أبو هرموش على إمارة الشوف بدل الأمير حيدر بعد أن منحته الدولة رتبة باشا بطوخين. وتقدم محمود أبو هرموش على رأس جيش باتجاه دير القمر، وعندما علم الأمير حيدر بذلك غادرها. واستدعى أبـو هرموش أسرة علـم الديـن (الذين فـروا إلى دمشق سنة 1666م إثر هزيمتهم من قبل أحمد المعني). وانتصـر محمود أبـو هرموش على جيش الأمير حيدر في منطقة غزيز، فهرب الأمير حيدر واختبأ في مغارة فاطمة في جبل الهرمل، واستمر في ذلك حوالي سنة. ثم نزل الأمير حيدر من مخبأه ورصّ صفوف أتباعه وتوجه لقتال أبي هرموش الذي استنجد بواليي صيدا ودمشق اللذين قدما بقواتهما دون الاشتراك في القتال انتظاراً لما يتمخض عنه. وألحق الأمير حيدر هزيمة ساحقة بالحزب اليمني برآسة أبو هرموش وآل علم الدين في موقعه عين داره في سنة 1711م، وقُتل من الأمراء آل علم الدين ثلاثة وأُسر أربعة وقُبض على أبي هرموش. وعندما علم كل من بشير باشا والى صيدا ونصوح باشا والي دمشق بهزيمة اليمنية عادا أدراجهما. وتم قَتل أمراء آل علم الدين الأسرى فانقطعت بهم سلالة الأسرة. واسترد الأمير حيدر الحكم في إمارة الشوف. وقد ساهمت معركة عين داره في تثبيت الحكم الشهابي في جبل الشوف([9])، وساد الحزب القيسي في جبل الشوف. وأدى زوال الحزب اليمني إلى زوال الخطر الذي كان يواجه القيسية، فانقسموا على أنفسهم إلى حزبين في منتصف القرن الثامن عشر، وظهر حزب اليزبكي نسبة إلى يزبك جد الشيخ عبدالسلام عماد زعيمه، والحزب الجنبلاطي نسبة إلى الشيخ علي جنبلاط([10]). كما ساد الصراع على الحكم بين الأمراء الشهابيين أنفسهم مما أضعف قوتهم. وأتاح هذا التمزق السياسي داخل الأسرة الشهابية الفرصة لظاهر العمر لأن ينمي قوتـه بمعزل عـن أي ضغط مـن جبل الشوف([11]). واستطاع الأمير يوسف سنة 1771م مد سلطته على جبل لبنان الذي كان يضم معاملة طرابلس التي تمتد بين وادي المعاملتين جنوباً حتى المرتفعات الواقعة شرقي طرابلس، وقاعدتها بلدة جبيل. التي تتبع ولاية طرابلس([12]).
ب ـ المتاولة:
هم طائفة من الشيعة تشغل القطعة المعروفة بجبل عامل أو جبل بني عاملة من سواحل بلاد الشام الغربية. وينسب بنو عاملة إلى عاملة بن سبأ، وهو الحرث بـن عدي الذي يرجع نسبـه إلى كهلان بـن سبأ. وقيل إن الحـرث سمي باسم أمه عاملة بنت مالك بن ربيعة القضاعية([13]). ولفظة المتاولة «هي جمع متوالي، مشتق»على غير قياس«من تولـى أي اتخذ ولياً ومتبـوعاً من ولائهم لأهل البيت النبوي الطاهر الذي هو الركن الركين في مذهب الشيعة. أو مشتق» على القياس «من توالى أي تتابعهم واسترسالهم خلفاً عن سلف في موالاة آل البيت» وقد أُطلق عليهم هذا اللفظ في نهاية القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)([14]).
وعرفت بلادهم أيضاً ببلاد بشارة نسبة إلى أحد حكامها في فترة صلاح الدين الأيوبي([15]). وتنقسم بلاد بشارة إلى قسمين: بشارة الشمالية ويحدها شمالاً نهر الأولي ومـن الجـنوب نهـر الليطاني، وبـلاد بشارة الجنوبيـة التي تبدأ من نهر الليطاني شمالاً الى نهر القرن جنوباً. وتنقسم بلاد بشارة عموماً إلى ثماني مقاطعات: ثلاث منها في بلاد بشارة الشمالية، وهي: الشقيف والشومـر والتفاح المعروفة الآن بناحية جباع، وحكامها من آل صعب وآل منكر. والأربع الأخرى في بشارة الجنوبية وهي: تبنين وهونين وقانا ومعركة. وكان حكامها من آل الصغير وقبلهم بنو شكر، ويتألف الآن منها قضائي صور ومرجعيون. والمقاطعة الثامنة هي مقاطعة جزين، وكان حكامها هم المقدمين المعروفين بمقدمي جزين([16]). وكانت أسر آل الصغير وآل منكر وآل صعب أشهر الأسر الإقطاعية العاملية التي حكمت بلاد بشارة في عهد العثمانيين([17]). ودخل المتاولة تحت حكم المعنيين خلال القرن السابع عشر، وحدثت بين الطرفين معارك عديدة في الفترة بين 1666 ـ 1697م، إذ سعى المتاولة إلى إدارة أنفسهم تحت حكم شيوخهم([18]).
وقال رافق: «وكان المتاولة من الحزب اليمني وقد اصطدموا كثيراً في هذه الفترة (نهاية القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر) بالأمراء الشهابيين القيسيين. ولايعني اشتهار المتاولة الآن (نهاية القرن السابع عشر) أنهم لم يمارسوا نفوذاً قبل ذلك، ولكننا نسمع عن أخبارهم بصورة أكثر ابتداءً من هذه الفترة وذلك لأسباب مختلفة، فبعد أن سيطر القيسية في جبل لبنان اشتد عداء اليمنية لهم. ونتج عن ذلك معاداة المتاولة اليمنية لهم. وكانت بلاد المتاولة تابعة لولاية صيدا. وكثيراً ماعهد هؤلاء الولاة إلى الأمراء الشهابيين في جبل لبنان بمعاقبة الثوار من المتاولة وجمع أموال الميري منهم»([19]).
وأظهر مشرف بن علي الصغير التمرد على والي صيدا قبلان باشا 1110ﻫ/ 1698م، وألقى القبض على بعض غلمان الوالي وقتلهم. فطلب الوالي مساعدة الأمير بشير الشهابي الذي تولى الحكم منذ فترة قريبة، وانتصر الأمير بشير على مشرف الصغير اليمني في موقعه المزيرعة، وقبض الأمير على مشرف وأخيه الشيخمحمود ومدبرهما الشيخ حسين المرجـي، وأرسلهما إلى قبلان باشا. فقتل الوزير المشار إليه الشيخ حسين واعتقل مشرف وأخاه ووضعهما في السجن، وأطلق للأمير التصرف في ديارهم جميعاً([20]). وأشار الشهابي والشدياق إلى أن قبلان باشا قد أطلق سراح مشرفاً الصغير بعد فترة، فيما تذكر الروايات العاملية إلى أن مشرفاً قد بقي مسجوناً في قلعة صيدا حتى توفي سنة 1114ﻫ / 1702م([21]). وأعاد الأمير بشير آل منكر وآل صعب إلى مقاطعاتهم بعد أن أطاعوا أمره، ثم قام والي صيدا الجديد بشير باشا بفصل مقاطعات المتاولة عن حكم الشهابيين وأعاد مشرفاً إلى حكم بلاد بشارة([22]). وتطرق الزين إلى أن استنجاد والي صيدا بالأمير بشير لا يعبر عن عجزه عن الاقتصاص من مشرف الصغير، ولكنه كان جرياً وراء سياسة الأتراك المتبعة بتأليب القوى المحلية ضد بعضها من أجل بذر الفرقة والأحقاد بينها وتوفير نفقات الحروب([23]).
واستفاد الأمراء الشهابيون من إطلاق والي صيدا يدهم في بلاد المتاولة حيث إن شيوخهم ضعفاء نسبياً مما أمن للأمراء الشهابيين نصراً سهلاً. ولذلك نجد أن الأمراء الشهابيين يكثرون من غزو بلاد المتاولة خلال القرن الثامن عشر حتى لأتفه الأسباب، وسواء بتكليف من والي صيدا أم بدونه. فقد سعى الأمراء إلى زيادة نفوذهم. ومحاولة تكتيل القيسية تحت إمرتهم تجاه المتاولة العدو التقليدي المشترك. وفوق ذلك طمع الشهابيون في بلاد المتاولة نظراً للازدهار الاقتصادي الذي شهدته مناطقهم خلال تلك الفترة، بسبب نجاح زراعة التبغ فيها وازدياد الطلب عليه من قبل التجار الفرنسيين. وأدت حملات الشهابيون ضد المتاولة إلى تكتل المتاولة أيضاً للدفاع عن بلادهم([24]).
وعمل المتاولة خلال القرن الثامن عشر على زيادة قوتهم ونفوذهم تحت قيادة شيخهم ناصيف نصار، وبرزوا كقوة مناوئة للشهابيين ولولاة صيدا ممثلي السلطة العثمانية. وشكلت بلادهم حاجزاً طبيعياً وبشرياً بين بلاد الجليل وجبل الشوف مما ساهم في إعطاء ظاهر العمر الفرصة لتطوير قدراته السياسية والعسكرية خلال النصـف الأول مـن القـرن الثامـن عشر. ولعـب المتاولـة دوراً بـارزاً في الأحداث السياسية التي شهدتها منطقة جنوب غرب بلاد الشام في القرن الثامن عشر، وساهمت عداوتهم التقليدية للشهابيين ومناوأتهم لولاة صيدا في رسم علاقاتهم السياسية مع القوى السياسية المجاورة ولاسيما ظاهر العمر.
ج ـ آل العظم:
شكل آل العظم شبـه سلالـة حاكمة في بلاد الشام في القرن الثامن عشر حيث كانوا ولاة للدولة العثمانية على ولايات بلاد الشام([25]). وقاموا بدورٍ مهم في الحياة السياسية لبلاد الشام في القرن الثامن عشر.
واختلفت المصادر حول أصل آل العظم، فذكر بعضها أنهم من قبائل قونية التركية، فيما ذكر بعضها الآخر أن أصلهم عرب من معرة النعمان إحدى سناجق ولاية حلب، وأن لقب العظم هو لضخامة جسم جدهم أبي كتف الملقب بالتركية «كيميك لى» أي ذي العظم. وعلى الرغم من أن أصلهم غير مؤكد الهوية إلا أن المؤكد أنهم أقاموا في معرة النعمان في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وأن جدهم إبراهيم العظم كان جندياً فيها([26])، أي أنها أسرة محلية المنشأ.
مُنح آل العظم في الربع الأول من القرن الثامن عشر إثر ازدياد نفوذهم معرة النعمان وحماة وحمص على شكل مالكانة([27]). وأصبح إسماعيل العظم (الذي تعود ولادته إلى نحو 1070ﻫ/ 1659م) حاكماً لمنطقة المعرة وحماة، ثم عُين على ولاية طرابلس في أوائل العشرينات بعد أن مُنح رتبة باشا بطوخين([28]). وتمتع آل العظم بغنى وافر من مالكاناتهم في المعرة وحماة وحمص، واستفادوا من الازدهار الاقتصادي في ولاية طرابلس التي نشطت فيها تجارة التبغ والحرير. واشترى آل العظم بمالهم المتزايد الدعم لهم في إستانبول، وكان لهم وكيل فيها يرعى مصالحهم يُدعى خليل أفندي الذي استمد نفوذه من كاخيا الصدر الأعظم([29]).
تولى إسماعيل العظم ولاية دمشق سنة 1725م، وهو أول من تولى ولاية دمشق من آل العظم([30]). وأشار «جب» إلى أن قيام سلطة آل العظم راجع إلى الخدمات التي أداها مؤسسها للدولة في لحظة عصيبة، إذ وصلت الفتن في عهد عثمان باشا أبو طوق والي دمشق (1721 ـ 1724م) بين القبوقول (انكشارية الـدولـة) وبيـن اليرليـة (الانكشاريـة المحليـة) درجـة لـم تصلها مـن قبل مما أزعج الباب العالي الذي يولي الوضع في دمشق أهمية كبيرة بسبب دورها في قافلة الحاج الشامي([31]).
ويعتبـر الإخباري الدمشقي المعاصر لهذه الأسـرة (ميخائيل بريك) بداية حكم آل العظم نقطة تحول في تاريخ المنطقة، وجعل توليهم الحكم أحد الأسباب التي جعلتـه يضع سنـة 1720م بداية لتأريخه([32]). ويُعتبر وصول أفراد من أسرة محليـة إلـى منصب الولايـة متغيراً مهماً في القرن الثامـن عشر، حيث خَرجت أسرة آل العظم عشرة وزراء في قرن واحد. ولكن من الجدير بالذكر أن أسرة العظم لم تتصرف باعتبارها قوة محلية بقدر ماسعى أفرادها إلى الظهور بمظهر رجال الدولة المطيعين للسلطان([33]).
وبلغ آل العظم درجة كبيرة من النفوذ والسلطة بين 1725 ـ 1730م. حيث عُين سليمان باشا العظم على ولاية طرابلس بعد نقل أخيه إسماعيل باشا العظم إلى ولاية دمشق. وفي سنة 1727م عين إبراهيم باشا العظم ابن إسماعيل باشا على ولاية طرابلس فيما نقل سليمان باشا إلى ولاية أورفة، ولكنه عزل منها سنة 1728م وعُين على ولاية صيدا. وبذلك حكم آل العظم ولايات دمشق وطرابلس وصيدا في آن واحد، وبذلك امتد حكمهم على المنطقة الواقعة بين حلب شمالاً والعريش جنوباً([34]). وقال الشهابي حول ذلك: «وقويت شوكة بيت العظم في عربستان وعظمت دولتهم»([35]).
وتعرضت مكانة آل العظم السياسية لهزة قوية إثر ثورة الإنكشارية على السلطان أحمد الثالث في 15 ربيع الأول 1143ﻫ/ 28 أيلول 1730م، إذ فقد وكيلهم خليل أفندي نفوذه في استانبول بعد مقتل كيخيا الصدر الأعظم. ونتج عن الثورة تبدل واسع في كبار موظفي الدولة، وصدرت الأوامر بعزلهم وسجنهم ومصادرة جميع أموالهم([36]). ولكن لم تنقض سنة واحدة على ذلك حتى أطلق سراح إسماعيل باشا وأبنائه في جمادى الأولى 1144ﻫ/ تشرين الثاني 1731م، وعين اسماعيل باشا والياً على جزيرة كريت حيث توفي هناك بعد نحو سنة([37]). بينما عُين سليمان باشا بعد إطلاق سراحه من قلعة صيدا في 15 ربيع الثاني 1144ﻫ/ 17 تشرين الأول 1731م والياً على طرابلس.
ويستدل من عفو الدولة عن آل العظم وتعيينهم مجدداً أنهم قد استعادوا نفوذهم، إذ حدثت تطورات لصالحهم في استانبول قُضي فيها في آذار 1731م على زعماء الثورة، واستعاد خليل أفندي وكيل آل العظم بعض نفوذه، وعاد إلى حماية مصالحهم([38]).
بلغ نفوذ آل العظم ذروته في الفترة بين 1741 ـ 1757م، إذ حكموا ولاية دمشق طيلة هذه الفترة. وقد تعاقب خلالها على الولاية سليمان باشا العظم (1741 ـ 1743م) وابن أخيه أسعد باشا (1743 ـ 1757م)([39]). فيما تولى أفراد آخرون منهم ولايات طرابلس وصيدا لفترات متقطعة. وتولى آل العظم مرة ثانية ولايات دمشق وصيدا وطرابلس في آن واحد سنة 1755م، اذ كان سعد الدين والياً على طرابلس 1753 ـ 1756م، فيما مُنح مصطفى باشا طوخين سنة 1166ﻫ/ 1752 ـ 1753م، وعُين والياً على صيدا سنة 1755م. ويُفسر تعيين آل العظم ولاة على صيدا وطرابلس وأحياناً حلب إضافة إلى ولاية دمشق بقوة النفوذ الذي وصلوا إليه، وبمحاولة الدولة إيجاد الانسجام بين الولاة لينصروا بعضهم بعضاً ضد ظاهر العمر والبدو الأقوياء، وليكون أمراء جردة الحاج وهم عادة من ولاة طرابلس أو صيدا خير المؤازرين لأمراء الحاج([40]). ويعتبر طول المدة التي قضاها أسعد باشا العظم في ولاية دمشق والتي بلغت أربع عشرة سنة ليس لها مثيل في العهد العثماني([41]).
تعرض نفوذ آل العظم لضربة كبيرة سنة 1757م بعزل أسعد باشا العظم عن ولاية دمشق ثم قتله في الأناضول بأمر الدولة لأسباب عديدة لا مجال لذكرها هنا. وتمت مصادرة أمواله الكثيرة. وعُزل أخوه مصطفى باشا وجرد من أطواخه. أما سعد الدين فلم يصب بأذى ولكنه فقد الكثير من نفوذه وتوفي في حزيران 1762م. وهكذا انتهى جيل آخر من آل العظم، وكان جميع أفراده من أبناء إسماعيل باشا. ولم يصل محمد باشا العظم الذي يمثل الجيل الثالث من حكام هذه الأسرة إلى ولاية دمشق حتى سنة 1771م رغم حكمه ولاية صيدا لفترات متقطعة خلال الستينات، ولكن أحداً لم يبلغ بعد أسعد باشا درجة النفوذ التي وصل إليها بسبب ضعف الأسرة العظمية من ناحية وانهيار سلطة ولاة دمشق عامة ازاء ازدياد قوة ظاهر العمر وعلي بك الكبير خلال فترة السبعينات، وخلال حكم أحمد باشا الجزار حتى نهاية القرن من ناحية أخرى([42]). وحكم أفراد من أسرة العظم ولاية دمشق في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حيث حكم عبدالله باشا العظم ولاية دمشق تسع سنوات متقطعة في الفترة بين 1795 ـ 1808م. وكان عبدالله باشا آخر ولاة آل العظم في بلاد الشام([43]). وبذلك فإن آل العظم قد حكموا ولاية دمشق خلال القرن الثامن عشر نحو 45 سنة([44])، إضافة إلى حكمهم في ولايات صيدا وطرابلس وحلب في بلاد الشام والعديد من الولايات خارج بلاد الشام([45]).
ويرى «مانتران» أن الباب العالي قد سمح باستمرار سلالة آل العظم في الحكم لأنه كان يرى أن بوسعها أن تحل عبر السلطة التي كفلتها نشأتها المحلية المشكلات التي تعاني منها الولاية بفاعلية أكبر، وأن ما تعرض له أسعد باشا العظم يشير إلى أن الباب العالي قد ظل الى حدٍ بعيد سيد اللعبة في دمشق، وأنه امتلك القوة الضرورية لذلك([46]).
ويمكن القول: إن آل العظم قد تمتعوا بالغنى والنفوذ والدعم في استانبول، وهي أمور أساسية في مقاييس تلك الفترة للحصول على الحكم والاستمرار فيه. وقد نتج عن تكليف ولاة دمشق بإمارة قافلة الحاج في سنة 1708م إطالة حكم هؤلاء الولاة ماداموا يؤَّمنون سلامة الحاج، فآل العظم أَّمنوا ذلك فاستمروا في الحكم، ووطدوا إضافة إلى ذلك الأمن في ولاياتهم ودفعوا مال الميري، ولم تحدثهم أنفسهم بالثورة والاستقلال، بل قنعوا بالحكم في ظل السلطان، فتسامح معهم مع أنه كان بإمكانه عزلهم ونقلهم من مكان إلى آخر، وحتى مصادرة ممتلكاتهم وقتلهم كما حدث في الواقع([47]).
وشهدت ولاية دمشق خلال القرن الثامن عشر تطورات مهمة إضافة إلى حكم آل العظم، إذ نقل مركز إمارة الحاج إلى دمشق، وكلف والي دمشق بإمارة الحاج مما ترتب عليه إطالة مدة حكم الولاة على ولاية دمشق. وفوق ذلك فإن الوالي أصبح يغادر دمشق نحو أربعة أشهر تبدأ عادة في النصف الأول من شهر شوال وحتى النصف الأول مـن شهـر صفـر. وألقـى ذلك المسؤوليـة على والي دمشق بالإعداد لقافلة الحاج وتمويلها بالمال اللازم، ولذلك اضطر للذهاب بنفسه لجمع الأموال الأميرية من واردات سناجق الولاية([48]). وسُمي خروج الوالي لذلك بالدورة التي كانت أيضاً بمثابة إظهار سطوة الدولة على المناطق التي تمر منها([49]). وساهمت قيادة والى دمشق لإمارة الحاج في ضعف السلطة في ولايته خلال غيابه، وعدم تمكن المتسلمين الذي ينوبون عنه من ممارسة سلطة حازمة([50]). كما ساهم أيضاً خروج والي صيدا أو والي طرابلس في قافلة الجردة إلى ضعف سلطتهم على ولاياتهم خلال غيابهم. وقد بقيت قافلة الحاج مضافة إلى باشوية دمشق حتى سنة 1288ﻫ(1871م) إذ انفصلت إمارة الحاج عن وظيفة الولاية وأفرد لها أمير خاص في عهد ولاية عبد اللطيف صبحي باشا([51]).
([2]) الشهابي ـ لبنان، ج1، ص3 ـ 4. الدويهي ـ تاريخ الأزمنة، المشرق، مجلد 44، بيروت،1950، ص382 ـ 383. الشدياق ـ أخبار الأعيان، ج1، ص19 ـ 22. ج2، ص311.
([9]) الشهابي ـ لبنان، ج1، ص10 ـ 13. الشدياق ـ أخبار الأعيان، ج2، ص313 ـ 315. السويد ـ التاريخ العسكري، ج2، ص56.
([10]) رافق ـ بلاد الشام، ص233 ـ 234. جودت ـ تاريخ جودت، ج1، ص350. الشهابي ـ لبنان، ج1، ص43. المعلوف ـ دوانـي القطـوف، ص109. مجهول ـ تاريخ الأمراء الشهابيين، ص100 ـ 101.
([26]) كرد علي ـ خطط، ج2، ص276. المعلوف ـ المرحوم جميل بك العظم، مجلة المجتمع العلمي العربي، مجلد 14، ج1، دمشق، 1936، ص56. بريك ـ تاريخ الشام، ص 36، 49.=
= جب، وبوون ـ المجتمع الإسلامي، ج2، (هامش) ص32.Holt ـ Egypt, P. 107.
([45]) البديري الحلاق ـ حوادث، ص191، 199، 221. أحمد عبد الكريم ـ مقدمة كتاب حوادث دمشق اليومية للبديري، ص34، 37، 38. Rafeq ـ The Province, P. 131.