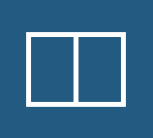أوضاع الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر
أوضاع الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر
كتب الأستاذ الدكتور خالد محمد صافي حول هذا الموضوع في كتابه " ظاهر العمر الزيداني حاكم الجليل في القرن الثاني عشر ( 1689-1775 م) والذي صدر عن دار المقتبس في بيروت سنة 1439هـ-2018 م
فقال:
شهدت الدولـة العثمانيـة مرحلـة مـن التراجع والإنحطاط خـلال القرن السابع عشر، وازداد ذلك وضوحاً خلال القرن الثامن عشر على الصعيدين الخارجي والداخلي. وسيتم الحديث عن هذا التراجع وتأثيره على الأوضاع في بلاد الشام.
أ ـ الصعيد الخارجي:
بلغت الدولة العثمانية أوج قوتها داخلياً وخارجياً في منتصف القرن السادس عشر، ثم شهدت تراجعاً في قوتها العسكرية خلال القرن السابع عشر، وفشلت في إحراز نصر في حصار فينا في تموز 1683م، وتبع ذلك سلسلة من الهزائم العسكرية انتهت بتوقيع معاهدة «كارلوفتز Karlowits» في 26 كانون الثاني 1699م بين الدولة العثمانية وبين النمسا وروسيا والبندقية وبولونيا. وترتب على ذلك خسائر إقليمية للدولة العثمانية في أوروبا، مما جلب انحداراً ملحوظاً لصورة الدولة العثمانية وهيبتها في نظر الأوروبيين وفي نظر رعايا الإمبراطورية([1]).
وواجهت الدولة العثمانية حروباً متعاقبة مع النمسا وروسيا خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر، فقد برزت روسيا باعتبارها قوة كبرى في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر في عهد بطرس الأكبر (1682 ـ 1725م) «Peter the Great» الذي وطد دعائم دولته، وسعى جاهداً إلى توسيع نفوذ روسيا على الصعيد الخارجي، وفتح أبوابها على البحار الدافئة مثل البحر الأسود. ودخل من أجل ذلك في صراع مع الدولة العثمانية التي رفضت سياسته في النفاذ للبحر الأسود([2]). وواجهت الدولة العثمانية هزائم عسكرية أمام النمسا في سنتي 1716 ـ 1717م ترتب عليها خسائر اقليمية جديدة بموجب معاهدة «بساروفتز Passarowitz» مما زاد أوضاع الدولة صعوبة على الصعيد الخارجي([3]).
وكان انتصار الدولة العثمانية على النمسا في أواخر الثلاثينات الانتصار الوحيد المهم الذي حققته الدولة في القرن الثامن عشر. إذ فرضت الدولة العثمانية شروطها على النمسا بموجب معاهدة بلغراد في 14 جمادى الآخرة سنة 1152ﻫ/ 18 أيلول 1739م، والتي استردت الدولة بموجبها مدينة بلغراد وأراضي أخرى([4]).
وجابهت الدولة العثمانية في الربع الثاني من القرن الثامن عشر خطراً داهماً من بلاد فارس شرقاً، حيث تمكن الأمير التركماني نادر شاه من قبيلة أفشر (ويعرف بلقب طهماسب قولى خان) من القضاء على حكام فارس الأفغانيين سنة 1729م، وأعاد الصفويين للحكم. وأصبح هؤلاء مجرد حكام صوريين بينما كانت السلطة الفعلية في يد نادر شاه. وأعلن نادر شاه في سنة 1736م نفسه حاكماً على فارس وأزال الصفويين من الحكم. وكان منذ ظهوره على مسرح السياسة سنة 1729م وحتى مقتله سنة 1747م العدو الأكبر للعثمانيين. وقد حاصر بغداد والموصل أكثر من مرة، وعُقدت معاهدات صلح بينه وبين العثمانيين خلال هذه الفترة ولكنها سرعان ماكانت تلغى بتجدد القتال([5]).
وتجددت الاشتباكات بين الدولة العثمانية وروسيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد كاترين الثانية «Catherine II» (1762 ـ 1796م)، وبلغ الصراع ذروته في حرب دامت الفترة ما بين 1768 ـ 1774م. وقد انتهت هذه الحرب التي كانت أكثر تدميراً من سابقاتها بتوقيع معاهدة «كجك كينارجة» «Kueuk Kainarca» في تموز 1774م. وانهكت هذه الحرب الدولة العثمانية إضافة إلى الخسائر الإقليمية التي لحقت بها([6]).
ويمكن القول: إن الدولة العثمانية واجهت خلال القرن الثامن عشر تحديات دولية خطيرة، وانشغلت بحروب خارجية استنزفت مواردها المالية والعسكرية. ولم تحقق الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر على الصعيد الخارجي سوى انتصارات جزئية في مقابل هزائم كبرى. وأثر انشغال الدولة العثمانية بالتحديات الخارجية سلباً على أوضاعها الداخلية، إذ نتج عن ضعفها تجاه الدول الأجنبية تناقص هيبة السلطة المركزية في الولايات، وعجزت عن تحقيق الأمن([7]).
ب ـ الصعيد الداخلي:
تدهورت أوضاع الدولة العثمانية تدهوراً واضحاً على الصعيد الداخلي خلال القرن السابع عشر، فعلى رأس الدولة وقف سلاطين شخصياتهم ضعيفة أو عديمة الكفاءة، وانقطع هؤلاء السلاطين إلى حياة القصر الخاصة، وانتقل تسيير شئون الدولة إلى أيدي السلطانات الوالدات. وازداد شأن موظفي القصور وعلى رأسهم الكازلار آغا (المشرف على الحريم في القصر السلطاني)، فأخذ ينافس الصدر الأعظم على الصدارة. وتوقف على نتيجة الصراع بين هذين القطبين مصير كثير من حكام الولايات الذين اعتمدوا على دعم أحد هذين القطبين في وجه الآخر([8]).
وتردى الموقف المالي والاقتصادي للدولة، فمع توقف الفتوحات العثمانية فقدت الخزينة مصدراً مالياً مهماً، وزاد الوضع المالي ارتباكاً تدفق الفضة والذهب إلى بلاد البحر المتوسط من العالم الجديد. فارتبك النقد العثماني وانهارت قيمته، وأصيبت الدولة بتضخم مالي وغلاء أسعار. وفشلت محاولات الدولة في الإصلاح النقدي([9]). وسعت الدولة العثمانية إلى البحث عن مصادر إضافية للدخل، فزادت الضرائب على الفلاحين بدرجة كبيرة مما أدى إلى هربهم من قراهم، وتدهورت الزراعة من جراء ذلك وشاع نظام الالتزام في أراضي الدولة بعد انحطاط الإقطاعات وأصحابها.
وأدى توقف الفتوحات إلى تراجع الوضع العسكري للدولة، حيث توقف التزود بالدفشرمة فعلياً في الثلث الثاني من القرن السابع عشر. وترتب على ذلك استخدام الدولة للجند المحليين. وهذا قلل من مقدرتهم القتالية بشكل كبير. وبدأ عدد من الجند في الزواج ومغادرة الثكنات، واتجه كثير منهم إلى زيادة دخله من مصادر أخرى بسبب غلاء الأسعار والتضخم المالي الذي تعاني منه الدولة. والأكثر من ذلك بدأ المسؤولون العثمانيون في تسجيل الموالين لهم في الجيش الانكشاري مبعدين الجنود المدربين والمتمرسين عن وظائف الجيش. وبالرغم من تراجع قوة الجيش الانكشاري خارجياً وتلقيه الهزيمة تلو الأخرى إلا أنه كان ذا تأثير قوي في العاصمة. وأصبح الجيش مصدراً للفساد والتمرد، وساهم في إضعاف الدولة خارجياً وداخلياً([10]). وبعد أن كانت الإدارة العسكرية مصدر قوة السلطنة في مراحلها الأولى فإنها أصبحت في القرن السابع عشر موطن الخلل الإداري والمالي([11]).
وكان الفساد العام الذي أصاب الدولة العثمانية من القمة إلى القاع له صدى بعيد المدى في ولاياتها، إذ ضعفت الإدارة المركزية. وعلى الرغم من أن هذه الإدارة قد شهدت فترة قوة ونشاط في النصف الثاني من القرن السابع عشر حين عُين عدد من أفراد أسرة كوبريلي «Koprulu» صدوراً عظاماً([12]). إلا أن ذلك كان استثنـائياً إذ سرعان مـا دب الضعف فـي أجهـزة الدولـة بنهاية القرن السابع عشر. وتراجعت سلطة الدولة، وساعد ذلك على ظهور حكام محليين ملأوا الفراغ الذي تركه ضعف الدولة العثمانية في ولاياتها. فظهر في روميلية والأناضول أعيان محليون سموا هناك باسم «أمراء الوديان» «Derbeyis». واعترفت الدولة بسلطتهم في ضوء عدم قدرتها على القضاء عليهم أو القيام بتأمين النظام مثلهم. هذا إلى جانب المساعدة التي كانوا يقدمونها للسلطان في حروبه ضد أعداء الدولة([13]).
وشهدت الولايات العربية بروز قوى محلية، فظهرت في بلاد الشام على الصعيد السياسي أسر محلية مثل آل العظم، والأسرة الزيدانية في الجليل، وظهر آل الجليلي في الموصل، والمماليك في بغداد. وبلغ المماليك في مصر في عهد علي بك الكبير ذروة سلطتهم. وبرزت في طرابلس الغرب في القرن الثامن عشر الأسرة القرمانلية التي حكم أفرادها بين 1711 ـ 1835م. وظهرت الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية([14]).
وضعفت سلطة ولاة الدولة العثمانية في ولاياتهم، إذ تولى الولايات ولاة يفتقدون الكفاءة في الإدارة، واعتمدوا على الرشوة في الوصول لمناصبهم والاحتفاظ بها. وقال «جب»: «وما جاء أوائل القرن الثامن عشر حتى أصبحت من العادات المقررة أن تمنح الترقيات بالحظوة والرشوة، وأن يطبق المزاد على الوظائف، ليس فقط ما كان منها إدارياً، بل أيضاً القضائية والدينية، والأراضي والامتيازات من كل نوع»([15]). ولذلك كان بقاء الموظفين في وظائفهم يعتمد على بقاء الشخص الذي يدعمهم في استانبول قوياً راضياً عنهم بدفع الرشاوي له، ولهذا استغل الولاة وكبار الموظفين مناصبهم للثراء ولإرضاء حُماتهم، فكثر تغير الولاة خلال تلك الفترة([16]).
وساهم اتباع نظام الالتزام في جمع الضرائب الذي حل محل الخدمة العسكرية في نظام التيمار في بروز زعامات محلية اكتسب سلطتها وشرعيتها منه، وسعت هذه الزعامات وفق مصالحها في توسيع حدود التزامهم والدخول في صراعات محلية مع القوى المجاورة أو مع ولاة الدولة. قال كوثراني: «كان الصراع والحلف يرتسمان على الخريطة السياسية والبشرية لبلاد الشام وفق مصالح القوى المتصارعة على اكتساب حق الالتزام والتلزيم في المقاطعات والقرى… وذلك بمعزل عن أي اعتبار إداري في تقسيم الولايات أو السناجق، وبمعزل عن أي اعتبارات إقليمية أو قومية وحتى شرعية. وعلى هذا النحو فإن بروز هذه الزعامات المحلية كانت جزءاً من ضعف السلطة العثمانية. وأن تمردها أحياناً وتهديدها للسلطة المركزية العثمانية ونزعتها الاستقلالية لم تكتسب وقتها تفسيرات قومية»([17]) وبالتالي فإن أي اسقاطات ايدلوجية معاصرة عليها كما فعل بعض المؤرخيـن تجاه ظاهـر العمـر([18])، يعتبر خـارج إطـار الدقـة والموضوعية والقراءة الصحيحة لتلك الفترة.
وشهدت بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر تطورات مهمة على صعيد تحرك القبائل البدوية وتنازعها السلطة على بادية الشام، فقد اختل التوازن فيها بسبب هجرة قبيلة عنزة (التي تنسب إلى عنـز بـن وائـل بـن جديلـة بن أسد بن ربيعة … بن معد بن عدنان) من الحجاز صوب الشمال. وهذه القبيلة هي أعظم القبائل العدنانية بل العربية عدداً وأعلاها شأناً وأكثرها انتشاراً. ويقع موطنها الأصلي بين أواسط نجد وشمال الحجاز. وقد هاجرت إلى بلاد الشام خلال القرن السابع عشر والثامن عشر بسبب الجدب والضيق، ثم لاحقاً بسبب ضغط الحركة الوهابية وتم ذلك بحركة متتابعة على مثال الهجرات البدوية العديدة([19]). وواجهت أثناء تقدمها في بادية الشام مقاومة القبائل العربية هناك، واصطدمت أولاً بقبيلة السرحان في منطقة الجوف فدحرتها، وهزمت قبيلة بني صخر التي قدمت لنجدة السرحان. ونزح بنو صخر والسرحان عقب ذلك إلى البلقاء، وتبعهم العنزيون وهزموهم شمال إربد، وتفرق بذلك حلف الشمال المكون في تلك الفترة من السردية والسرحان والفحيلي والعيسى، واستقر قسم من الفحيلي والسردية في شمال فلسطين، وانتقلت زعامة المنطقة بين دمشق وحوران إلى وادي السرحان والجوف إلى قبيلة عنزة. وتقدمت قبيلة عنزة شمالاً وبلغت حمص وحماه ودحرت الموالي نحو منازلهم في معرة النعمان، وزاحمت قبيلة شمر التي سبقتها في الخروج من نجد على المراعي في انحاء جبل بشرى والعمور، فاضطرت قبيلة شمر إلى عبور الفرات والاستقرار في الجزيرة. وبذلك أصبحت عنزة سيدة بادية الشام دون منازع حتى وادي الفرات، وأخلت بالأمن وشلت كل عمل في التجارة والنقل([20]).
وحاولت الدولة العثمانية احتواء الوضع وتحويله لصالحها فخلعت على زعماء قبيلة عنزة لقب بك، وكلفتهم بحراسة حدود الصحراء بين حلب ودمشق، وسُمح لهم مقابل ذلك بفرض رسوم على القوافل([21]).
([5]) رافق ـ بلاد الشام، ص297. الدبس ـ تاريخ سوريا، مجلد 7، ج4، ص372 ـ 373. فريد ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص146 ـ 148.
([18]) معمر ـ ظاهر العمر، مقدمة ص أ، ج. أحمد جودة ـ حركة الشيخ ظاهر العمر الزيداني حاكم عكا والجليل 1690 ـ 1775، المؤتمر الدولي الخامس للجنة الدولية للدراسات ما قبل الفترة العثمانية والفترة العثمانية (الولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني)، تونس، 1984، ص150.