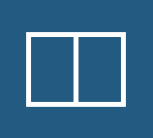المدح ومبادلاته في الأغراض المقابلة
المدح ومبادلاته في الأغراض المقابلة
(الرِّثاء، الفخر، الهجاء)
كتب الأستاذ الدكتور أسامة اختيار حول هذا الموضوع من كتاب ( جمهرة أشعار الصقليين تحقيق ودراسة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة ( 1437 هـ - 2016 م )
فقال :
لا يأتي الجمع في هذه الدِّراسة بين شعر المدح الصِّقلِّيِّ والأغراض الشِّعريَّة المقابلة له عبثاً، إنَّما تدعو إليه ضرورتان؛ الأولى: تفرضها طبيعةُ المادَّةِ الشِّعريَّةِ، والثَّانيةُ تفرضها خصوصيَّةُ علاقةِ تلك الأغراض بشعر المدح، فعلى صعيد المادَّة الشِّعريَّة نشير إلى أنَّ تقديمَ المدح على غيره يعود إلى اهتمام الصِّقلِّيِّين بهذا الغرض، ووَفْرَة مادَّته في أشعارهم، في حين يبدو أنَّ ما وصل إلينا من أشعارهم في سائر الأغراض الأخرى (الرثاء، الفخر، الهجاء) لا يعدو أن يكون متفرِّقاتٍ، حتَّى إنَّ بعضَها يندرُ كالفخر والهجاء، كما سيتَّضح في هذا الفصل.
لا يخفى على صعيد خصوصيَّة العلاقة بين تلك الأغراض وشعر المدح أنَّ ثمَّةَ وشائجَ معنويَّةً تصل بين المدح والأغراض الشِّعريَّة المقابلة له (الفخر والرِّثاء والهجاء) ولا أدَّعي هنا أنَّ تلك الأغراضَ واحدةٌ من حيث البناءُ، فثمَّةَ ما يجمع بينها أو ما يفرِّق، إنَّما أرمي إلى أنَّ دراسة هذه الأغراض متقابلةً تتيح النَّظر في خصائصها المعنويَّة، وفيما يستلفه كلُّ غرضٍ من معاني الآخر، أو فيما يكون من الصُّور الشِّعريَّة المتداولة بين تلك الأغراض، إذ ليس بِدْعاً القول إنَّ بعض صور المدح أو معانيه تصلح للفخر، كما يصلح بعضُها لِذِكْرِ مناقب المرثي.
أمَّا الهجاء فهو على النَّقيض من المدح من حيث سَلْبُ المَهْجُوِّ معانيَ الفضائل، مع الاختلاف في منهج البناء وفي أسلوب التَّصوير، ولذلك يقف هذا الفصل عند تلك الأغراض الشِّعريَّة وفقاً لهذه الرُّؤية الَّتي تقوم على دراسة عناصر الاتِّفاق وعناصر الاختلاف بينها، من حيث خصائص المعاني وأسلوب التَّصوير، وأبدأ بالمدح لمكانته في شعر الصِّقلِّيِّين.
* * *
أولاً ـ قصيدة المدح الصِّقلِّيَّة:
يُعَدُّ المدح من الأغراض الشِّعريَّة البارزة في الشِّعر العربيِّ القديم عامَّةً، ويرجع ذلك إلى مكانته لدى الأدباء وأثَرِه في نَفْسِ الممدوح، ولا يخفى أنَّ إعجابَ الممدوحِ بغرض المدح، ثمَّ اهتمـامَ الأدباءِ والنُّقادِ الأقدمين بـه؛ زادا من أهمِّيته وعَمِلا في تطويره على صعيدي الدِّلالة وأساليب الأداء الفنِّيِّ.
أمَّا دوافعُ المدحِ فكثيرةٌ، إذ يمدح الشَّاعر تكسُّباً، أي طمعاً في عطايا الممدوح، أو رغبةً في الحُظْوَة والمكانةِ لديه، أو رهبةً منه وخوفاً من بطشِهِ، وقد يمدح إعجاباً بممدوحِهِ على غيرِ طمعٍ بِهِبَةٍ أو حُظْوَةٍ، وهذا الضَّرْبُ من المدح أعظمُ مرتبةً، وأجلُّ منزلةً، وأصدق عاطفةً، لِصُدورِه عن محبَّةٍ للممدوح وإجلالٍ له.
شعر المدح الصِّقلِّيُّ فرعٌ نضيرٌ من فروع المدح في الشِّعر العربيِّ القديم، ويظهر لنا من خلال ما وصل إلينا من شعر الصِّقلِّيِّين مَبْلَغُ عنايتهم ببناء قصيدة المدح، ويُعَدُّ غرضُ المدحِ من الأغراض الشِّعريَّة البارزة في أشعارهم، قياساً إلى الفخر والرثاء والهجاء، فكيفَ بَنَوا مدائحَهم؟ وما المنهجُ الَّذي سارَتْ عليه تلك المدائح؟ وهل تأثَّرت مقدِّمةُ المدحةِ الصِّقلِّيَّةِ بالبيئة والواقعِ المعيشِ؟ وهل يمكننا تصنيفها تحت نَسَقِ مدرسةِ المدحِ الاتباعيِّ أو أنَّها جنحت في بعض مواطنها إلى الاتِّجاه الإبداعيِّ لملائمة التغيُّرات الزَّمانيَّة والمكانيَّة المفروضة عليها؟
أ ـ مقدِّمة قصيدة المدح:
تُظْهِرُ مقدِّماتُ المدائحِ الصِّقلِّيَّة تنوُّعَ حياة الصِّقلِّيِّين وتنوُّعَ مصادرِ ثقافتهـم، ويتَّضـح في مقدِّماتِ مدائحهم أثرُ المدرستين المشـرقيَّة والأندلسيَّة، فضلاً عن أثـر البيئـةِ الصِّقلِّيَّـةِ، وفي الإمكان تمييز نمطين من التَّأثير المشـرقيِّ في مقدِّمة المِدْحَةِ الصِّقلِّيَّة؛ الأوَّل يتجلَّى في أثر المدرسةِ المشرقيَّةِ التَّقليديَّةِالَّتي قامَ فيها المدحُ على مقدِّمةِ النَّسيبِ ووَصْفِ الرِّحلةِ والرَّاحلةِ، أما الثَّاني فيتجلَّى فيه أثرُ المدرسةِ المشرقيَّةِ المُحْدَثةِ الَّتي مثَّلها تيَّارُ الشُّعراء المُحْدَثِين في القرن الثَّاني الهجريِّ، الَّذين باشروا المدحَ من دون مقدِّماتٍ، أو رفضوا مباشرةَ المدحِ بالنَّسيبِ مُسْتَبْدِلين ذلك بمقدِّماتٍ مُحْدَثَةٍ كان أبرزُها المقدِّمةَ الخمريَّةَ.
يندر في شعر الصِّقلِّيِّين افتتاحُ مقدِّماتِ المدائحِ بالنَّسيب الطَّلليِّ، وكانت لنا وَقْفَةٌ عند تفسير ظاهرة عزوفهم عن وصف الطَّلل([1])، ويُظْهِرُ تَتَبُّعُ النَّسيبِ الطَّلليِّ في مقدِّمات المدائح الصِّقلِّيَّة وجودَ نماذجَ قليلةٍ لا تتيحُ التَّفصيلَ في دراسة الجانب الفنيِّ للنَّسيب الطَّلليِّ غيرَ الَّذي يُلْـمَحُ من الرَّغبة في محاكاة النَّمط المشرقيِّ التَّقليديِّ، وكأنَّ الشَّاعر الصِّقلِّيَّ يرمي إلى إبراز ثقافته الأدبيَّة، فمن ذلك ما نجده في قول ابن القطَّاع في مقدِّمة مِدْحَتِهِ للأفضل الجِماليِّ أمير الجيوش المصريَّة (ت 515ﻫ)([2])وقد استعان بالمقدِّمة الطَّلَلِيَّة([3]):
| ذي ديارُها فَقِفا
| صاحِبَيَّ وا أَسَفا |
| مِنْ حَدِيثِها طَرَفا
| واسْمَعا أَبُثُّكُما |
تنحصر مدائحُ الصِّقلِّيِّين الَّتي تُفْتَتَحُ بمقدِّمة النَّسيب الطَّلليِّ في أشعارهم الَّتي نظموها خارجَ صقلِّيَّة، إذ تَظْهَرُ في شعر المهاجرين إلى المغربِ ومصرَ، وهذا يلائمُ البيئةَ الجديدةَ للشِّعر الصِّقلِّيِّ المهاجرِ، فالقارَّةُ الإفريقيَّةُ صحراويَّةُ المناخِ، ممَّا يستدعي أجواءَ الطَّلليَّات التَّقليديَّة ويلائمُ الحالَ الشُّعوريَّةَ للنَّظم فيها، وليس في مدائح الصِّقلِّيِّين المقيمين في صقلِّيَّةَ أو المهاجرين إلى الأندلس ـ كأبي العرب الصِّقلِّيِّ وابن حمديس ـ ما يُسْتَهَلُّ بالنَّسيب الطَّلليِّ.
يقترن النَّسيبُ في مدائحهم بذكرِ الأماكن على عادة المشـرقيِّين، أو يقترن بوصف الظَّعْنِ وذِكْرِ أسـماءِ النِّسـاءِ اللَّـواتي يُتَشَـبَّبُ بهـنَّ في النَّسـيب المشرقيِّ، ويُلْحَظُ في مدائحهم ذِكْرُ الأماكن المغربيَّةفضلاً عن الأماكن المشرقيَّة، فمن قَبيل ذِكْرِهِم للأماكن المغربيَّة ما نجده في شعر ابن القُرْقُوبيِّ الصِّقلِّيِّ، كقوله في مطلع إحدى مدائحه المغربيَّة([4]):
| بِلاَ مِرْيَةٍ إنَّ العَذُولَ لَمـُسْـرِفُ | غداةَ اغْتَدَى في مَجْهَلِ اللَّومِ يَعْسِفُ([5]) |
| أَأَصبِرِ عَنْ غِزْلانِ صَبْرَة إنَّنِي | لأَوْهَى قُوًى ممِّا يَسُومُ وَأَضْعَفُ([6]) |
ويُكْثِرُ ابنُ حمديس من ذِكْرِ الأماكنِ المشرقيَّةِ في أشعاره، ولا سيَّما الَّتي نَظَمَها في المرحلة الأخيرة من حياته بعد رحلته إلى إفريقيَّة، كقوله([7]):
| وقد مُلِئَتْ أنفاسُه ليَ بالوَجْدِ؟([8])
| أَمِسْكَ الصَّبا أهدَتْ إليَّ صَبا نَجْدِ |
| أَحُدِّثْتَ عن حَرٍّ مُذيبٍ منَ البردِ؟
| رماني بِحَرِّ الشَّوقِ بَرْدُ نَسِيمِها |
| تَطَيَّبَ في جُنْحِ الدُّجى بِسُـرى هِنْد([9])
| وما طابَ عَرْفٌ مِنْ سُراها وإنَّما |
| فَكَمْ خَدَّدَ الخَدَّ الَّذي فوقَهُ تَخْدِي([10])
| حدا بالأسى شَوقِي رواحلَ أَدْمُعِي |
| تُواصِلُ وُدِّي في فِراقِ ذوي الوُدِّ
| ولي ذِمَّةٌ مَرْعِيَّةٌ عندَ عَبْرَةٍ |
| فيا دمعُ أَنْجِدْني على ساكِني نَجْدِ([11])
| أُحِبُّ حبيباً نَجْلَ أَوْس ٍلقولِهِ: |
إنَّ ملامحَ النَّسيبِ المشرقيِّ واضحةٌ في الأبيات (صَبا نَجْد، سُرى هِنْد، حَدا بالأسى شوقي رواحل أدمعي، ساكِني نَجْدِ) ويَفِيدُ الشَّاعرُ في هذا المشهد من ثقافته الأدبيَّة، ويتَّضح ذلك في بناء معاني الأبيات وقافيتَها على نحوٍ يذكِّرُنا بداليَّةِ الشَّاعرِ الأمويِّ ابنِ الدُّمينة([12]):
| فَقَدْ زادني مَسْـراكَ وَجْداً على وَجْدِ
| ألا يا صَبا نَجْدٍ متى هِجْتَ مِنْ نَجْدِ؟ |
فضلاً عن ذلك نجدُ ابنَ حمديس يُضَمِّنُ في أحدِ أبياتِهِ السَّابقةِ قولَ الشَّاعرِ العبَّاسيِّ أبي تمَّام([13]):
| فيا دمعُ أَنْجِدْني على ساكِني نَجْدِ([14])
| وأَنْجَدْتُمُ مِنْ بَعْدِ إتهامِ دارِكُمْ |
يقترن النَّسيب أيضاً بذكرِ أسماءِ النِّساءِ اللَّواتي يُتَشَبَّبُ بهنَّ في النَّسيب المشرقيِّ، مثل (هِنْد) في الأبيات المذكورة آنفاً من شعر ابن حمديس، ومثل (سعاد) في قول عمر بن حسن الصِّقلِّيِّ في مطْلَعِ إحدى مدائحه([15]):
| حَلَّتْ سُوَيدا قلبِهِ وفُؤادِهِ
| طَلَبَ السُّلُوَّ لَوَ انَّ غيرَ سُعادِهِ |
ونحو ذلك ما نجده في شعر ابن حمديس من ذِكْرٍ لاسم (سَلْمى) الَّذي شاع في شعر المشارقة، يقول([16]):
| فَحَلَّلَ من وَصْلِ سَلْمى حَراما([17])
| رَعى من أخي الوَجْدِ طيفٌ ذِماما |
وقد يأتي النَّسيبُ مقترناً بوصف الرِّحلة، سواءٌ في ذلك وصفُ رحلةِ الظَّعائن وفيهنَّ المحبوبة، أو وصفُ رحلةِ الشَّاعر إلى ممدوحه، والأوَّلُ من صُلْبِ بنيةِ النَّسيب، أمَّا الثَّاني فَمُلْحَقٌ بها، وقد يجمتع الوصفان، كقول جعفر بن الطيِّب الكلبيِّ في مقدِّمةِ مدحِهِ لمُدافِع بن رشيد([18]) في قصيدةٍ بديعة المعاني والسَّبْك([19]):
| جِمالاً بالجَمالِ مُحَمَّلاتِ([20])
| أراها للرَّحيلِ مُثَوَّراتِ |
| بأقمارٍ عليها طالِعاتِ
| تَتِيهُ على الرَّكائبِ في سُراها |
| لَصَدَّتْ عن وجوه الغانياتِ
| ولو نظرَتْ لمن تَسْـري إليهِ |
يمضي الشَّاعر في وصف رحلته إلى ممدوحه، فيصوِّرُ ما تكابدُه النَّاقةُ من العطشِ والجوعِ في رحلتها الصَّحراويَّة، فهي لا تجد ما تقتاتُ به غيرَ زَجْرِ الحُداة ورَجَزِ الرُّواةِ، ولا تحطُّ ركابَها إلَّا في منازل الممدوحِ، وهذا النَّسيبُ تقليديٌّ.
هذه المقدِّماتُ البدويَّةُ الملامحِ الَّتي تقترنُ بالرِّحلة في الصَّحراء غائبةٌ عن مدائـح الشُّـعراء الصِّقلِّيِّين في صقلِّيَّـة والأندلـس، بسبب الطَّبيعة النَّضرة التي تَتَّصف بها الجزيرتان، لكنَّ تلك المقدِّماتِ تَظْهَرُ في مدائح الصِّقلِّيِّين المهاجرين إلى إفريقيَّة، ويرجع ذلك إلى طبيعة الصَّحراء الإفريقيَّة الَّتي تتناسبُ ومضامينَ تلك المقدِّماتِ، وهذا يدلُّ على عُمْق الارتباطِ الشُّعوريِّ بالمكان لدى الشُّعراء الصِّقلِّيِّين، فعلى سبيل المثال يميل ابن حمديس في مقدِّمات مدائحه الإفريقيَّة إلى وصف الرَّحلة الصَّحراويَّة بعد مقدِّمة النَّسيب([21])، لكنَّه يعزف عن ذلك في مدائحه الأندلسيَّة.
وظهرَتْ مقدِّمةُ النَّسيب في شعر ابن الصَّبَّاغ، ويبدو فيها الأثرُ المشرقيُّ لرحلة الظَّعْن، فمن ذلك قوله([22]):
| لما دَرَتْ أنَّ قلبَ الصبِّ في شُغُلِ
| حنَّتْ إلى الصَّدِّ تبغي طاعةَ الملَلِ |
| مِنْ تحتِ ليلٍ على أعلاهُ مُنْسَدِلِ
| إذا بدَتْ قلْتُ: غُصْنٌ فوقَهُ قَمَرٌ |
| سَقَتْهُ مِنْ لَحْظِها كأساً منَ الخَبَلِ
| لما رأتْهُ أسيرَ الحُبِّ ذا كَلَفٍ |
| وخَلَّفَتْني أسيراً في يدي أَجَلِي
| تَرَحَّلَتْ بفؤادي يومَ رِحْلَتِها |
تَمْتَح هذه المقدِّماتُ من مَعينِ مقدِّمة النَّسيب الجاهليِّ، وتستقي منها كثيراً من المعاني، ولا يخفى أنَّ الشُّعراء الجاهليِّين أكثروا من مقدِّمة النَّسيب في قصائد المديح، وأسهبوا في «الحديث عن صَدِّ المحبوبةِ وهجرِها أو بُعْدِها وانفصالِها، وما يُخَلِّفُهُ البعدُ والهجرُ والفراقُ من تَعَلُّقٍ شديدٍ وشوقٍ مستبدٍّ»([23])، وإذا كانت مقدِّماتُ مدائحِ الصِّقلِّيِّين تحاكي المدرسةَ المشرقيَّةَ التَّقليديَّةَ الَّتي قام فيها المدح على مقدِّمةِ النَّسيب التقليديِّ؛ فإنَّ ثمَّة مطالعَ أخرى ظهرَ فيها النَّسيبُ الرَّقيقُالَّذي بدَتْ فيه أَثَرُ المعايشة الواقعيَّة، فضلاً عن أَثَرِ البيئةِ المدنيَّةِ المتحضِّرة، فمن ذلك مِدْحَةُ ابن الخيَّاط الَّتي مطلعها([24]):
| أَخَذَ الرُّقادَ وخَلَّفَ الأرَقا
| طَرَقَ الخيالُ وساءَ ما طَرَقا |
ويَكْثُرُ في شعرهم امتزاجُ النَّسيبِ الرَّقيقِ بوصف الخمر، كالَّذي يُلْحَظُ بوضوحٍ في شعر البَلَّنُوبيِّ (أبي الحسن) وهو من الشُّعراء الصِّقلِّيِّين الَّذين هاجروا إلى مصرَ بعـد سـيطرة النُّورمـان علـى صقلِّيَّة، وقضى حياتَهُ في كنف الوزراء والأمراء حيث القصورُ والرِّياضُ وحياةُ التَّرفِ، ولذلك كَثُرَتْ في مدائحه المقدِّماتُ التي يَبْرُزُ فيها التَّشَبُّبُ الَّذي يأتي ممزوجاً بأوصاف الخمر ووصف الطَّبيعة والحديث عن مجالس اللَّهو، كقوله([25]):
| صَرَعَتْني بينَ ظَلْمٍ ولَمَى([26])
| لَحَظاتٌ مِنْ شَبيهاتِ الدُّمى |
يمضي الشَّاعر في مقدِّمته فيمزج بين الغزل والطَّبيعة والخمر مزجاً لا تنفصل فيه هذه العناصر، وهذا يتَّضح في قوله([27]):
| فَتَّحَ الرَّوضَ وجَلَّى الظُّلَما؟
| كيفَ تَخْفَى زَورَةُ الصُّبحِ وقد |
| وثنايا ورُضاباً وفَما([28])
| قد أعارَ الكأسَ منه وَجْنَةً |
| جَوِّها أمْ حَدَقاً أم أَنْجُما؟([29])
| أَحَباباً ما أثارَ الماءُ في |
يتجلَّى في مِثْلِ هذا النَّوعِ من مقدِّمات المدح أثرُ المدرسـةِ المشرقيَّةِ المُحْدَثةِ الَّتي نشأَتْ بتيَّار الشُّعراء المُحْدَثين في القرن الثَّاني الهجريِّ، ورفضَتْ مباشرةَ المدحِ بالنَّسيب وأولعت بمقدِّماتٍ مُحْدَثَةٍ تُبْرِزُ أطيافَ الحياة المدنيَّة، ويُقِرُّ بعضُ الصِّقلِّيِّين بأثـرِ المشرقيَّةِ المُحْدَثةِ في أشعارهم، كالَّذي نجده في مقدِّمة مدائح ابن حمديس من محاكاة تجربة أبي نواس في تجديد المطالع مُسْتَهِلًّا بالخمر([30])، وذلك على النَّحو الَّذي يتَّضح في هذه المقدِّمةِ الخمريَّةِالَّتي تَرِدُ في مَطْلَعِ إحدى مدائحِهِ الأندلسيَّة إذ يقول([31]):
| محاسنَ ما خُلِعْنَ على الرُّسومِ([32])
| خَلَعْتُ على بُنَيَّاتِ الكُرومِ |
| وكيف أميلُ عن غَرَض ِالحكيم؟([33])
| أخذْتُ بمَذْهَبِ الحَكَمِيِّ فيها |
| تَمُجُّ المسكَ في نَفَس النَّسيمِ([34])
| وما فَضْلُ الطُّلولِ على شَمُولٍ |
| إذا صَقَلَتْهُ مِنْ صَدأ الهُمومِ
| يُجَدَّدُ حُبُّها في كلِّ قَلْبٍ |
وهذا لا يعني أنَّ المقدِّمةَ الخمريَّةَ في شعر ابن حمديس هي نِتاجُ التَّأثُّر بالمدرسة المشرقيَّةِ المُحْدَثَةِ وحسب، فقد أسهمَتْ بيئةُ الأندلس الَّتي قضى الشَّاعر فيها شطراً من عُمُرِه في صياغة مقدِّمتِهِ الخمريَّةِ، ولاسيَّما على صعيد مَزْجِ الخمرِ بالنَّسيب، ويُعَدُّ ذلك صفةً بارزةً في مقدِّمات مدائحه، وهذا ينطبق على مقدِّمات أبي العرب الصِّقلِّيِّ، إذ يستهلُّ مديحَهُ بالخمر ويدعوها بنُعوتِها، فهي أمُّ اللَّهوِ والطَّرَبِ وابنةُ الكَرْم، ويبذلُها لزوَّارِه إيناساً لهم، يقول([35]):
| عندي منَ البِرِّ والإيناسِ والأدبِ
| وقد أُزارُ وللزُّوَّارِ حُكْمُهُمُ |
| وأَعْوَزَتْني أمُّ اللَّهْوِ والطَّرَبِ | وأَفْضَلُ البِرِّ بِرٌّ يقتضـي طَرَباً |
| قَفْرٌ إذا لم تكنْ فيه ابنةُ العِنَبِ
| وكلُّ رَبْعٍ ـ وإنْ حَلَّ الجميعُ بهِ ـ |
وإذا كان أبو العرب الصِّقلِّيُّ يبذل خمرتَهُ للشَّاربين ويُؤْنِسُهُمْ بها، فإنَّ الخمرَ في شعر مَجْبَر بن محمَّد الصِّقلِّيِّ مبذولةٌ للشَّاربين أيضاً، غيرَ أنَّه يحجبُها ويصرفُها عن العاشق الَّذي أَخَذَتْهُ نَشْوَةُ الحُبِّ وسَكْرَتُهُ، رفقاً بما نزل به، فيقول في أحد مطالع مدائحِهِ مخاطباً نديمَهُ([36]):
| إنَّ الهوى للنَّفْسِ من لَذَّاتِها
| اِمْلأْ كؤوسَكَ بالمُدامِ وهاتِها |
| رَشْفُ الرُّضابِ أَلَذُّ مِنْ رَشَفاتِها
| اِصْرِفْ عَنِ المُشْتاقِ صِرْفَ مُدامةٍ |
| أمسَتْ ثغورُ البِيضِ من كاساتِها
| وأَحَلُّ أَشْرِبَتي وأَحْلاها الَّتي |
تمتزج في هذا الشِّعر صورةُ الخمرِ بالصُّورة الغزليَّة على نحوٍ يغدو فيه الفصلُ بين عُنصري الخمرِ والغزلِ صعباً (اصْرِفْ عن المُشْتاق صِرْفَ مُدامةٍ، رَشْفُ الرُّضابِ أَلَذُّ مِنْ رَشَفاتِها، أمسَتْ ثغورُ البِيضِ من كاساتِها) غير أنَّ رَبْطَ المقدِّماتِ الخمريَّةِ في الشِّعر الصِّقلِّيِّ بأصولها المشرقيَّةِ المُحْدَثَةِ لا يعني تجريدَها من السِّمةِ الواقعيَّةِ، لأنَّ الشُّعراءَ الصِّقلِّيِّين جسَّدوا في المقدِّمات الخمريَّة بيئتَهُمُ الصَّاخبـةَ بحيـاة اللَّهـو، كما جسَّـدوا فيهـا الثَّقافـةَ المشرقيَّةَ المُحْدَثَةَ، ممَّا جعلَ مقدِّماتِهم أشبهَ بلوحةِ فُسَيفِساء تضافرَتْ في صناعتها ثقافاتٌ أدبيَّةٌ متنوِّعةٌ.
فضلاً عن ذلك ظهرَتْ في مقدِّمة مدائح الصِّقلِّيِّين مقدِّمةُ وصفِ الطَّبيعة، وتجلَّتْ في مدائحِهمُ الأندلسيَّةِ والصِّقلِّيَّةِ معاً لتحاكيَ جمالَ البيئتين، ويُلْحَظُ أنَّ مقدِّمةَ وصفِ الطَّبيعةِ ـ ولاسيَّما الرِّياض المحيطة بالقصور ـ كان من نتاج الحياةِ المَدَنِيَّةِ، وبرزَتْ هذه الظَّاهرة في شعر الأندلسيِّين، ولها ملامحُ في بعض شعر العبَّاسيِّين أيضاً، وكان من أبرزهم مسلم بن الوليد (ت 208ﻫ) الَّذي جعل من وصف الرِّياض مدخلاً إلى المدح([37])، وقد أبدع الصِّقلِّيُّون في هذا النَّوع من المقدِّمات، ويُعَدُّ ابنُ حمديس من الشُّعراء الَّذين استهلُّوا المدحَ بوصف الرِّياض، ونجـد ذلك أيضاً بوضـوحٍ في شـعر مُشْرِف بن راشدٍ حين يستعين بوصف الطَّبيعة في إظهار براعته في حُسْنِ التَّخَلُّصِ إلى بناء المدح مستعيناً بالتَّشخيص إذ يقول([38]):
| لم تَنْتَهِبْها أَعْيُنُ النَّاسِ
| ما روضةٌ بالحُسْنِ مَمْطورةٌ |
| عَنْ نَرْجِسٍ غَضٍّ وعَنْ آسِ
| بكى عليها الغيثُ فاسْتَضْحَكَتْ |
| وإنْ رمى قلبي بوَسْواسِ([39])
| أَحْسَنَ مِنْ وَجْهِ أبي طاهرٍ |
أظهرت البيئتان الصِّقلِّيَّةُ والأندلسيَّةُ أَثرَ الحياةِ المدنيَّةِ بجانبها الرَّقيقِ في مقدِّمـات المـدح، وجـاء مَزْجُ الطَّبيعـةِ بالغـزل في مقدِّمـات مدائحهـم اسـتجابةً للـذَّوق الأدبيِّ العـامِّ في البيئتيـن المذكـورتين، وحَـرَصَ الشَّـاعرُ المتكسِّبُ بمدحِهِ على مخاطبة ممدوحيـه بما يستميل مشاعرهم، إذ «ينبغي لِمَنْ كـان قولُـه الشِّـعرَ تَكَسُّـباً لا تأدُّبـاً أن يحمـل إلـى كـلِّ سـوقٍ مـا ينفـق فيها»([40])ولذلك أكثر الشُّـعراء الصِّقلِّيُّـون في مدائحهـم من المقدِّمـات الَّتي تَستَهِلُّ بالغـزل الممزوجِ بالطَّبيعـةِ على اختلاف عناصرها المتعـدِّدة، كالَّذي نجده في مقدِّمة مِدْحَةِ ابن الصفَّـار للأمير ابن صَمادِح (ت 484ﻫ)([41]) ومن مَطْلَعِها قوله في هذه الأبيات([42]):
| وانحدرَ الطَّلُّ على الجُلَّنارْ([43])
| فاضَ عقيقُ الدَّمعِ فوقَ البَهارْ |
| ذاوٍ وهذا يانعٌ ذو اخضـرارْ
| واجتمعَ الغُصنان، لكنَّ ذا |
| وكادَ هذا يَعْتَرِيهِ انْكِسارْ
| وكادَ ذا يَنْقَدُّ مِنْ لِينِهِ |
| فهذه الأدمعُ عَنْهُ شَرارْ
| واضطرمَتْ في القلبِ نارُ الجَوَى |
وقد مزجَ مُشْرِف بن راشد بين الطَّبيعة والغزل في بعض مقدِّمات مدائحِهِ، كالَّذي نَلْحَظُه في مطْلَع مَدْحِهِ لصاحبِ الخُمُسِ إبراهيم([44]) إذ يقول([45]):
| وليَكُنْ منكَ للقطيعةِ رَفْضُ
| أيُّها الغُصْنُ لِنْ بِعَطْفِكَ غَضّاً |
فضلاً عن وصف الطَّبيعة؛ ظهرَتْ في مدائحهم مقدِّمةُ وصفِ مظاهرِ الحضارة، فمن ذلك وصفُ القصورِ والمُتَنَزَّهاتِ، كما في مقدِّمة مدحة ابن بِشْرون للملكِ رُوجارَ الثَّاني (ت548ﻫ)([46]) الَّتي وصفَ فيها قصورَ منصوريَّةَ([47]) من نواحي حواضر صقلِّيَّة([48]):
| للهِ مَنْصُورِيَّةٌ | راقَتْ ببَهْجَتِها البَهِيَّةْ |
| وبقَصْـرِها الحَسَنِ البِنا | والشَّكْلِ والغُرَفِ العَلِيَّةْ |
| وبوَحْشِها ومِياهِها الْـ | ـغُزْرِ العُيونِ الكَوْثَريَّةْ |
وقد مزجوا وَصْفَ القصورِ بذِكْرِ مجالسِ اللَّهوِ والخمرِ، كالَّذي نجده في شعر البَثيريِّ([49])، وكان من مظاهر عنايتِهم بالوصف في مقدِّمات مدائحهم وَصْفُ ما تقع عليه العيون من مظاهر التَّرف في القصور، فمن ذلك قول ابن حمديس يصفُ مَجْمَرَةً وصفاً طريفاً([50]):
| تدورُ إذا حَرَّكْتَها في حشا كُرَةْ
| ثلاثةُ أفلاكٍ عنِ العَين مُضْمَرَةْ |
| موافقةٍ منها الخِلافَ مُقَرَّرَةْ
| فلا فَلَكٌ إلَّا يُخَصُّ بدورةٍ |
يَظْهَرُ من الوصف أنَّها مَجْمَرَةٌ لها ثلاثةُ رؤوسٍ جُعِلَ فيها البَخُورُ، وهي في كُرَةٍ إذا حُرِّكَتْ دارَ كلُّ رأسٍ منها على خِلافِ الرأسين الآخرَين، وهذا الوصفُ ينمُّ على براعة الصِّقلِّيِّين في الاستهلال بوصف ما يستهوي الممدوحَ ممَّا يقتنيه في قصره، فيلاقي ذلك استحسانَه، ويجذبُ سَمْعَهُ، ويستحضرُ جُودَهُ، كاستهلال ابن حمديس بوصفِ خيلٍ أُهْدِيَتْ إلى ممدوحه([51])، ومِثْلُ ذلك وَصْفُهُ في قصيدةٍ أخرى لنفائسَ حُمِلَتْ إلى ممدوحه([52])، ونحوه وَصْفُ أحمد بن قاسم الصِّقلِّيِّ لِدُواةِ حِبْرٍ من عاجٍ ومَرْجان وَجَدَها بين يَدَي ممدوحِهِ فاستهلَّ بوصفِها مِدْحَتَهُ([53]).
ويجدر بالذِّكر أنَّ قصيدةَ المدحِ الصِّقلِّيَّةَ تميَّزَتْ في بعض نماذِجها بالتَّخفُّف من المقدِّمات على اختلاف أنواعها، وهذا يحمل إلى الذِّهن منهجَ قصيدةِ المدحِ في عصر الفتوح في صدر الإسلام، إذ لم يفتتح كثيرٌ من الشُّعراء في صدر الإسلام مدائحَهُم بالمقدِّمات، ويُلْحَظُ في المدائح الصِّقلِّيَّة تأثُّرُها بِثَراءِ مقدِّماتِ المدحِ في القصيـدة العربيَّـة فـي رحلتهـا التَّاريخيَّـة من المشرق إلى المغرب، ثمَّ الأندلس وصقلِّيَّة، وقد جمعَ الصِّقلِّيُّون بين مناهج القدماء والمُحْدَثين على اختلاف أساليبهم في بناء المدائح ومقدِّماتِها، وتكمنُ براعتُهم في استخدام كلِّ فنٍّ من مقدِّمات المدح في بيئته الملائمة، فَظَهَرَ في مدائح الصِّقلِّيِّين الإفريقيَّةِ منهجُ الافتتاحِ بالنَّسيب الطَّلليِّ ووَصْفِ الصَّحراءِ، وظهرَ الافتتاحُ بالطَّبيعةِ والخمريَّاتِ والنَّسيبِ الرَّقيقِ في مدائح الصِّقلِّيِّين الأندلسيَّةِ. والسُّؤالُ الجديرُ بالإجابة هنا:
ما الغايةُ الَّتي يتوخَّاها الشُّعراءُ الصِّقلِّيُّون من الافتتاح المباشرِ بالمدح والتَّخَفُّفِ منَ المقدِّمات؟ وإذا كان هناك تأثرٌ بمنهج المدحةِ الإسلاميَّةِ الأُولى؛ فما دافعُ الصِّقلِّيِّين إلى تَرْكِ مقدِّمةِ المدحِ في بعض أشعارهم؟ وهلْ هذا النَّهْجُ لا يعدو أن يكون تقليداً لمنهجِ المدحةِ الإسلاميَّةِ في عصورها الأولى؟
إنَّ نَبْذَ مقدِّمةِ المدحِ في بعض أشعارِ الصِّقلِّيِّين ليسَ بدْعَةً ابتدعوها من دون غيرِهم، فقد بدا تأثُّرهم بالمدحةِ الإسلاميَّةِ واضحاً، وتُظْهِرُ دراسةُ مدائحِهم أنَّ الدَّافعَ إلى نَبْذِ المقدِّماتِ في بعض المدائحِ يرتبط مباشرةً بخصوصيَّةِ موقفِ المدحِ في القصيدة، فعندَ كلِّ أمرٍ عظيمٍ جَلَلٍ تَتَنَحَّى المقدِّماتُ المعروفةُ في المدح، ويشرعُ الشَّاعرُ في مباشرة مِدْحَتِهِ، ويكون استهلالُه بالموقف الجَلَلِ، إذ ليس ثمَّةَ ما يدعو إلى جَلْبِ انتباه الممدوحِ أكثرَ ممَّا يشغلُه في ذلك الموقفِ، وهذا نمطٌ من براعة الاستهلال، فخيرُ المطالعِ في المدح ما افْتُتِحَ بما يستميل الممدوحَ، والمتكسِّبُ بالشِّعرِ يفتتحُ بما يُمليه عليه سوقُ شعرِه، ويُلْحَظُ أنَّ المدائحَ الصِّقلِّيَّةَ الَّتي تَتَخَفَّفُ من المقدِّماتِ ترتبط بشعر الفتوحِ، كالَّذي نجدُه في شعر الحسينِ بنِ أبي عليِّ القائد في مقدِّمةِ مَدْحِهِ للأميرِ أحمد الأكحل (ت427ﻫ)([54])في حربٍ غَنِمَها([55]):
| ونادِ يُجِبْكَ منهم كلُّ نادِ
| على العاداتِ فَاجْرِ معَ الأعادي |
| ولو أنَّ البناءَ بناءُ عادِ([56])
| فما لحصونِهم منكَ امتناعٌ |
| سَلَكْتَ إليهِ مِنْهاجَ الرَّشادِ
| فكمْ مِنْ مَعْقِلٍ لِلْعَينِ سامٍ |
| إلى أنْ قامَ فيهم منكَ هادِ
| وقَدْ حارَتْ نفوسُ القومِ فيه |
| وأنزلْتَ الوُعولَ إلى الوِهادِ
| فأصعدْتَ الخيولَ إلى الرَّوابي |
ومن ذلك قول الشَّاعر مَجْبَر بن محمَّد الصِّقلِّيِّ يذكرُ انتصارَ ممدوحِهِ على عدوٍّ خارجٍ عليه([57]):
| وفي كلِّ إحسانٍ معانيكَ تُغْرِبُ
| بأيِّ لسانٍ عن معاليكَ أُعْرِبُ |
ونحـو ذلك ما نجدُه في شـعر محمَّد بن أحمد الكَلاعيِّ([58])، ونجد في ديوان البَلَّنُوبيِّ (أبي الحسن) مدحتين باشـر فيهما المدحَ من دون مقدِّمة، واستهلَّ الأُولى بذِكْرِ عزيمةِ ممدوحِهِ وانتزاعِهِ المُلْكَ([59]). أمَّا الثَّانيةُ فافتتحَها بتمجيد انتصاراته وغَلَبَتِهِ على أعدائه، وممدوحُهُ في الثَّانية النَّاصرُ للدِّين أبو محمَّد اليازَوَرِيُّ (ت 450ﻫ)([60]) ومن مَطْلَعِها قوله([61]):
| وقَرَّ لأمْرِ المسلمينَ قرارُ
| توالَتْ فتوحاتٌ وأُدْرِكَ ثَارُ |
تُظْهِرُ دراسـةُ هـذه الظَّاهـرة في ديـوان ابن حمديـس أنَّـه افتتحَ تسعَ عشرةَ قصيدةً بالمدح مباشـرةً([62])، وهي قصائدُ مُصَرَّعةٌ، ممَّا يؤكِّدُ أنَّها لم تستهلَّ بغير المديح، غيرَ أنَّ أكثرَها في ذِكْـرِ فتوحِ ممدوحيـهِ وانتصاراتِهم، وقليلٌ منها انصرفَ إلى مناسباتٍ رأى الشَّاعرُ ضرورةَ الاستهلال بذِكْرِها لأهمِّيتها لدى ممدوحيه، ويُلْحَظُ أنَّ القصائد الَّتي تَخَفَّفَ فيها ابنُ حمديسَ من المقدِّمات استُهِلَّتْ بظَفَرِ الممدوحِ في حروبه، لاستمالة الممدوحِ إلى المدحة بهذا الاستهلال، في حين اقتصـرَتْ ستُ قصائدَ منها على الاستهلال بمناسباتٍ أخرى؛ منها مدحتان يُواسي فيهما الشَّاعر ابنُ حمديسَ وَلِيَّ نعمتِهِ الأميرَ المُعْتَمِدَ بنَ عبَّاد (ت488ﻫ) في أَسْرِه، ويمدحُه عِرفاناً بجميل صُنْعِهِ ووفاءً له، وقصيدةٌ ثالثةٌ يذكرُ في مَطْلَعِها ما أحدثه في نفسِهِ خبرُ إصابةِ ممدوحِهِ المُعْتَمِد في معركةٍ مع الرُّوم ويهنِّئه بسلامته، أمَّا القصائدُ الثَّلاثُ الأُخريات فهي في مدح بعض أمراءِ المغربِ، وباشَرَ هذه المدائحَ بما يتعلَّقُ بمناسباتها.
هذا كلُّه يدلُّ على عناية الصِّقلِّيِّين بمقدِّمات المدح وحِرْصِهم على رَبْطِ تلك المقدِّماتِ بما يناسبُ مقتضى حال المتلقِّي الأوَّل (الممدوح)الَّذي يهتمُّ به الشَّاعر، فالمدحةُ إنَّما صُنِعَتْ له ورغبةً في رضاه، أو طمعاً في جزيل عطائِهِ، أو اتقاءً لِشَرِّه، وإن لم تَلْقَ المِدْحَةُ منذُ مَطْلَعِها استحسانَ الممدوحِ ضاعَ ما بعدَها واندثرَ، وقد يقعُ في سوء المطالعِ فحولُ الشُّعراء لِتجاهلِ مقتضى حال الممدوح، ولذلك صرفَ الخليفة عبدُ الملكِ بن مروان شاعرَهُ جريراً حين أنشدَه صدرَ مدحتِهِ «أتصحـو أم فؤادك غير صاح؟» وردَّ عليـه: «بَلْ فؤادُك»([63]) وهذا يؤكِّدُ ما لِمطالعِ المدحِ من أهميَّةٍ، ولاسيَّما عند الشَّاعر المتكسِّبِ بمدحِهِ، ولعلَّ مِثْلَ هذا الخبرِ لا يخفى على الشُّعراء الصِّقلِّيِّين، ولاسيَّما أنَّ شِعْرَهم يشفُّ عن اطِّلاعِهِمُ الواسعِ على الثَّقافةِ الأدبيَّةِ المشرقيَّةِ.
عَقِبَ الكلام على تنوُّعِ مقدِّماتِ المدائحِ الصِّقلِّيَّةِ، ومراعاةِ الشُّعراءِ الصِّقلِّيِّين لمناسباتِ المديحِ ومقتضى أحوال الممدوحين؛ لابدَّ من دراسة اتِّجاهاتِ معاني المديحِالصِّقلِّيِّ في المرحلتين العربيِّة والنُّورمانيِّة، وذلك للنَّظرِ في الثَّابتِ والمتغيِّرِ في معانيها،فضلاً عن الوقوف على المؤثِّرات العامَّة في المدحة الصِّقلِّيَّة في هاتين المرحلتين من تاريخ الشِّعر الصِّقلِّيِّ.
ب ـ المدح الصِّقلِّيُّ في العصرين العربيِّ والنُّورمانيِّ:
يُعَدُّ ابنُ الخيَّاط مِنْ أبرزِ أعلام شعرِ المدحِ في مرحلة سيادة الحكم العربيِّ في صقلِّيَّة، وقد عاش في كنف الأمراءِ الكلبيِّين، وتَقَلَّبَ في قصورهم مادحاً، وقدَّمَتْ مدائحُـهُ صـورةً واضحـةَ المعالـم للحيـاةِ السياسيَّةِ في صقلِّيَّـةَ في عصر الكلبيِّين، تلك الحياةُ الَّتي كانت قامت على الغزو والدِّفاع المستمرِّ عن صقلِّيَّةَ ضدَّ الفرنجةِ المتربِّصين في البحر الَّذين ظلُّوا يأملون في بسط نفوذهم عليها، وأهمُّ مدائحِهِ في الكلبيِّين ما صنعَهُ في ثقة الدَّولة يوسف بن عبد الله([64])، وقد أظهرَتْ مدائحُه ما وصلَتْ إليه صقلِّيَّةُ منَ المنعة حتَّى يَئِسَ منها الأعداءُ، وأطبقَ ملوكُها على أصقاعها([65]):