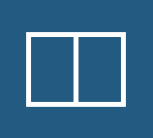ملامح الحياة الاجتماعية في الشعر الصقلي
ملامح الحياة الاجتماعيَّة في الشِّعر الصِّقلِّيِّ
كتب الأستاذ الدكتور أسامة اختيار حول هذا الموضوع من كتاب ( جمهرة أشعار الصقليين تحقيق ودراسة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة ( 1437 هـ - 2016 م )
فقال :
إنَّ للشِّعر العربيِّ في كلِّ عصـرٍ من عصوره الأدبيَّة اتجاهاتٍ يفرضها العصر، والظُّروف التَّاريخيَّة له، فضلاً عن البيئـة الَّتي نشـأ فيها، وإذا كان لعنصر الزَّمان تأثيرٌ واضحٌ في انتشار أغراضٍ شعريَّةٍ في مرحلةٍ معينةٍ من مراحل تاريخ الشِّعر العربيِّ؛ فإنَّ العاملَ المكانيَّ فرضَ ذاتَه أيضاً مؤثِّراً في تكوين هويَّة الشِّعر، وتحديد المعالم الخاصَّة لاتِّجاهاته.
يتجلَّى العامل المكانيُّ في تفاعل النَّصِّ الشِّعريِّ وما تطرحه البيئةُ من ثوابتَ ومتغيِّراتٍ، وتُعَدُّ الطَّبيعة إحدى مفردات العامل المكانيِّ، ولهذا الكتاب في فَصْلِهِ الثَّاني وَقْفَةٌ تفصيليَّةٌ لدراسة تجلِّيات الطَّبيعة في الشِّعر الصِّقلِّيِّ([1])، غير أنَّ العامل المكانيَّ يَتَّسِعُ ليشملَ النَّسيجَ السُّكَّانيَّ الَّذي يشغل المكانَ، وما ينتجه من تفاعلٍ بين عناصره، وهذا ما يُعبَّرُ عنه بمفهوم الأثر الاجتماعيِّ في إنتاج الأدب.
لا يخفى أثرُ التَّفاعل بين المكان ومتغيِّرات الحياة الاجتماعيَّة في تكوين اتجاهات الأدب على اختلاف زمانه ومكانه، ولذلك فإنَّ المنطلق الصَّحيح لدراسة الشِّعر الصِّقلِّيِّ هو الكشف عن ملامح البيئة الاجتماعيَّة الَّتي استمدَّ منها الشَّاعر موضوعاته، وخيرُ نهجٍ لِتَتَبُّعِ ذلك هو الكشف عن تلك الملامح من خلال ما وصل إلينا من أشعار الصِّقلِّيِّين.
من المعلوم أنَّ «وجدان الشَّاعر يتأثَّرُ بمظاهر البيئة تأثُّراً عفويّاً، ويقع ذلك في عتمة ضميره»([2]) ولذلك نجد الشَّاعر الصِّقلِّيَّ وثيقَ الصِّلة بالمجتمع الَّذي يحيط به، يتأثَّرُ به ويؤثِّرُ فيه، ويبدو أنَّ الحياة الاجتماعيَّةَ الصِّقلِّيَّةَ ـ على اختلاف مظاهرها ـ وجدَتْ لها مساحةً واسعةً في أشعار الصِّقلِّيِّين، إذ يستطيع الدَّارس لهذا الشِّعر أنْ يرسمَ من خلاله صورةً واضحةَ المعالم للمجتمع الصِّقلِّيِّ تشفُّ عن تنوُّع مظاهر البيئة الاجتماعيَّة المدنيَّة، وفي الإمكان رَصْدُ المشهد الاجتماعيِّ في الشِّعر الصِّقلِّيِّ في أربعة محاورَ هي: صورة المجتمع المدنيِّ المُتْرَف، وشعرُ المجالس مُمَثَّلاً بالطَّربيَّات والخمريَّات، وشعرُ النَّقد الاجتماعيِّ السَّاخر، والشِّعرُ الدِّينيُّ مُمَثَّلاً بالزُّهد والتَّصوُّف.
* * *
أولاً ـ صورة المجتمع المدنيِّ المُتْرَف:
إنَّ أوَّلَ ما يلفتُ النَّظرَ في الشِّعر الصِّقلِّيِّ هو اهتمام الصِّقلِّيِّين بتصوير مظاهر التَّرف الاجتماعيِّ، فقد جنحوا في شعرهم إلى معجمٍ لغويٍّ تكثر فيه الألفاظ الدَّالَّة على رَغَدِ العيش، فمن ذلك ما نجده في أشعارهم من ألفاظ المعادن الثَّمينة والأحجار الكريمة والحُلِيِّ والعطور والأثوابِ الموشَّاةِ المُتْرَفَةِ.
ويمكننا تعميمُ هذه الظَّاهرة في الشِّعر الصِّقلِّيِّ لتشملَ مرحلتي الحكم العربيِّ والنُّورمانيِّ لصقلِّيَّة، وسنضرب أمثلةً من شعر المرحلتين توكيداً لظهورها، والملاحظ أنَّها تَظْهَرُ في موضوعاتٍ مختلفةٍ من شعر الصِّقلِّيِّين، ومن ذلك ما نجده في الجانب العمرانيِّ كَوَصْفِ ابنِ الخيَّاط لِعَين ماءٍ جُلِبَتْ إلى بركةٍ في دار الإمارة الكَلْبِيَّة، وجُعِلَ مَسْرَبُ الماء فيها من المَرْمَرِ([3]):
| حتَّى اسْتَقَرَّتْ لَدَيهِ في قَرارَتِها | ثُمَّ اسْتَمَرَّتْ بهِ في مَرْمَرٍ سَرِبِ |
ويصوِّرُ ابن بِشْرون جانباً من هذا التَّرف العمرانيِّ في صقلِّيَّة في مرحلة الحكم النُّورمانيِّ، إذ يحشـد في الوصـف ألفاظَ التَّرف، فتبـدو الرِّياض مُطَيَّبـةً بالعبيـر، مدبَّجةً بالسُّندس معطَّرةً بالعنبر، يقول([4]):
| فَقَدِ اكتَسَتْ جَنَّاتُها | مِنْ نَبْتِها حُلَلاً بَهِيَّةْ |
| غَطَّى عَبِيرَ تُرابِها | بمُدَبَّجاتٍ سُنْدُسِيَّةْ |
يُهْدِي إليكَ نَسِيمُها | أفْواهَ طِيبٍ عَنْبَرِيَّةْ |
ويُلْحَظُ في وصف البَثِيْرِيِّ جانبٌ من هذا التَّرف المَدَنِيِّ في مقطوعةٍ يصف فيها قصورَ صقلِّيَّة وما فيها من ملاعبَ زاهيةٍ وتماثيلَ منحوتةٍ، ورياضٍ مصبوغةٍ بجواهر الزَّهْرِ، الَّذي يعطِّرُ أجواءَها، وحدائقَ مَحْمِيَّةٍ أُنُفٍ، أي تأنفُ الرَّعيَ فلا يَقْرَبُها ما يُفْسِدُ نَبْتَها من الأنعام([5]):
| أَعْجِبْ بمَنْزِلِها الَّذي | قَدْ أَكْمَلَ الرَّحْمَنُ زَيَّهْ |
| وَالمَلْعَبِ الزَّاهِي على | كُلِّ المَبانِي الهَنْدَسِيَّةْ |
| وَرِياضِهِ الأُنُفِ الَّتي | عادَتْ بها الدُّنْيا زَهِيَّةْ |
| وأُسُودِ شَاذَرْوانِهِ | تَهْمِي مِياهاً كَوْثَرِيَّةْ |
| وَكَسا الرَّبيعُ رُبُوعَها | مِنْ حُسْنِهِ حُللاً بَهِيَّةْ |
| وَغَدا [يُكَلِّلُ] وَجْهَها | بِمُصَبَّغاتٍ جَوْهَرِيَّةْ([6]) |
لا يقتصر مشهد التَّرف في شعر الصِّقلِّيِّين على وصف مظاهر الحضارة العمرانيَّة، بل تُلْـمَحُ الألفاظُ المترفةُ في سائر أغراض القصيد، ومن ذلك شعر المديح، ويبالغ الشُّعراء الصِّقلِّيُّون في استخدام معجم التَّرف في مدائحهم، كما في هذه الصُّورة الَّتي يتمنَّى فيها ابن الخيَّاط أن يُقَلِّدَ ممدوحَه عِقْداً من النُّجوم في إشارة إلى المدائح الَّتي نظمها فيه([7]):
| وَلَوِ اسْتَطَعْتُ على النُّجومِ نَظَمْتُها | عِقْداً إليكَ فَهَلْ إليها مَعْرَجُ |
كذلك يصوغ مَجْبَر بن محمَّد الصِّقلِّيُّ مدائحَهُ في مقابلاتٍ تصويريَّةٍ، كالَّتي سبقَتْ في شعر ابن الخيَّاط، فتأتي صوره المدحيَّةُ مُشْبَعَةً بمفردات التَّرف (العنبر، الدُّرُّ، المسك، العِقْد، الجواهر، الحُلَل الرَّائقة) وتكمنُ المقابلةُ التَّصويريَّةُ بين الشَّاعرين في تصوير المدحة عِقْداً، لكنَّ مَجْبَراً يضفي على صورته مَلْـمَحاً جديداً يتجلَّى في تشخيص الكواكب وهي تتمنَّى لو أنَّها تقلَّدَتْ عِقْدَ مِدْحَتِهِ([8]):
| ما زِلْتُ أَنْظِمُ طِيبَ ذِكْرِكَ عَنْبَراً | أَرِجاً خلال الدُّرِّ مِنْ كَلِماتِها |
| حتَّى إذا نَشَـرَ الصَّباحُ رداءَهُ | عَنْ مِثْلِ نَفْحِ المِسْكِ مِنْ نَفَحَاتها |
| وَتَمَثَّلَتْ عِقْداً تَوَدُّ كَواكِبُ الـ | ـجَوزاءِ عَقْدَتَهُ عَلَى لَبَّاتِها |
| أَعْدَدْتُها لِلِقاءِ مَجْدِكَ سُبْحَةً | أَدْعُو بها لأنالَ مِنْ بَرَكَاتِها |
| فاليومَ أَنْثُرُها جواهرَ حِكْمَةٍ | عَقُمَتْ بحارُ الشِّعْرِ عَنْ أَخَواتِها |
| فَالْبَسْ بها حُلَلَ الثَّناءِ فإنَّها | حُلَلٌ تَرُوقُ عُلاكَ في بَدَناتِها |
تُلمَحُ ظَّاهرةُ التَّرف أيضاً في موضوعاتٍ شعريَّةٍ أخرى تدلُّ على امتداد التَّرف إلى محيط المجتمع الصِّقلِّيِّ من دون أن يقتصر على الطَّبقة الحاكمة، فمن ذلك ما نجده في شعر الوصف عند ابن الخيَّاط، كوصفه لِقِطافِ العِنَبِ، إذ يصوِّرُ عناقيدَ العِنَبِ أقرطةً حبَّاتُها من أحجار العقيق، ويشبِّهُ رائحةَ عُصَارة حبَّاتِها في أيدي قاطفيها بماء الزَّعفران([9]):
| وكأنَّ أَقْرِطَةً على قُضْبانِها | منظُومَةٌ سَبَجاً بها وعَقيقا([10]) |
| وكأنَّ قاطِفَها [يَمِيثُ] بِكَفِّهِ | من مائِها بالزَّعْفَرانِ خَلوقا([11]) |
يبلغ الولعُ بالصُّور المترفة أن يستخدم الشُّعراء معجمَ التَّرف في مواقفَ شعريَّةٍ لا تناسـبُ الموضوعَ، كهذه الصُّورة الَّتـي يـؤدِّي فيهـا اسـتعمالُ لفـظ (العقيق) دلالاتٍ لا تضـارع الَّذي يثيـره في النَّفـس مشـهدُ الدَّم المتقطِّرِ من السُّـيوف، إذ يروقُ ابن الخيَّاط أن يشبِّهَهُ بحبَّات العقيق([12]):
| وَمُهَنَّداتٌ كالعَقائقِ ماؤُها | مُتَرَقْرِقٌ، وَلَهِيبُها مُتَأجِّجُ |
ثمَّةَ صورٌ أخرى لمظاهر التَّرف استمدَّها الشُّعراء من مخزون مشاهداتهم من البيئة، كتلك الصُّور الَّتي تُظْهِرُ الحُلِيَّ النَّفيسةَ، ومنها صورة المعادن الثَّمينة المُحَلَّى بعضُها، كتَحْلِيَةِ الذَّهب بالفضَّة، نحو الَّذي نجده في وصف ابن القطَّاع لِبَيضِ بعض الطُّيور([13]):
| بَنادِقُ التِّبْرِ غُشِّيَتْ وَرِقاً | أو مِشْمِشٌ في صِحافِ كافورِ([14]) |
نَلْحَظُ بوضوحٍ حَشْدَ الشَّاعر لألفاظ التَّرف في الصُّورة الوصفيَّة (التِّبر، الوَرِق، الكافور) ويميل ابن القطَّاع إلى مِثْلِ هذا الحَشْدِ لألفاظ التَّرف في البيت الواحد في كثيرٍ من وصفيَّاتِهِ، كالَّذي نجده في وصفه لِرمَّانةٍ يُخَيَّلُ إليه أنَّها وعاءٌ من الذَّهب مملوءٌ بمنثور اليواقيت([15]):
| كَأنَّها حُقَّةٌ مِنْ عَسْجَدٍ مُلِئَتْ | مِنَ اليواقِيتِ نَثْراً غَيْرَ مَنْظُومِ([16]) |
ويبدو أنَّ صناعةَ الحُلِيِّ والمجوهرات في صقلِّيَّة كانت مصدر بعض تلك الأوصاف المشبعة بألفاظ التَّرف، من ذلك صورة المنثور من مِبْرَدِ صائغِ الذَّهبِ بين يَدَيه، كما في وصف ابن الطُّوبيِّ (أبي عبد الله) لنار الفحم إذْ يَطْرُدُ فيها اللَّهبُ الشَّرارَ([17]):
| ونارِ فَحْمٍ ذِي مَنْظَرٍ عَجَبِ | يَطْردُ عَنْه الشَّـرارَ باللَّهَبِ([18]) |
| كأنَّما النَّارُ مِبْرَدٌ جَعَلَتْ | تَبْرُدُ مِنْهُ بُرادةَ الذَّهَبِ([19]) |
وقد اتَّسعَتْ هذه الظَّاهرة في أشعارهم فشملت الأوصافَ الإنسانيَّةَ، فمن ذلك قول ابن الخيَّاط في وصف صبيان الرُّوم([20]):
| كأنَّ على لَبَّاتِهِمْ وخُدودِهِمْ | وَذائلَ مُلْساً مِنْ لُجَينٍ وعَسْجَد([21]) |
| ترى كِبرياءَ الحُسْنِ في لَحَظاتِهِمْ | يُشابُ برَهْبانِيَّةِ المُتَهَجِّدِ |
ومن مظاهر معجم التَّرف في الأوصاف الإنسانيَّة ما نجده في شعر الغزل الصِّقلِّيِّ، ويُلْحَظُ إسرافُ الشُّعراء الصِّقلِّيِّين في استخدام ألفاظ التَّرف في هذا المضمار، ولا سيَّما في موضوع الغزل، وجُلُّ ما ورد من ذلك هو في مَعْرِضِ الصِّفات الحسِّيَّة، ولا أثرَ في معظمه للعاطفة والوجدان، فمثال ذلك ما نجده في قول الشَّاعر ابن الخيَّاط([22]):
| يكادُ ماءُ النَّعيمِ يَقْطُرُ مِنْ | سُنَّةِ وَجهٍ كَسُنَّةِ البَدْرِ |
| كأنَّ قُبْطِيَّةً نَثَرْتَ بها | خِلْطَينِ مِنْ فِضَّةٍ ومِنْ تِبْرِ([23]) |
يشفُّ الحقل الدِّلاليُّ لألفاظ التَّرف في شعر الغزل الصِّقلِّيِّ عن طبيعة المجتمع المُغْرَم بالجانب الزَّاهي من الحياة، فضلاً عمَّا تفيضُ به تلك الألفاظُ من دلالاتٍ يُضْفِيها الشُّعراءُ على موصوفاتهم، كما في هذه الصُّورة من شعر ابن الخيَّاط الَّتي تبدو فيها الموصوفةُ وقد نظمَ لها حُسْنُها خَرَزَ القلوب عِقْداً([24]):
| وأنا الرَّهينُ بحُبِّ ساحِرَةٍ | مَلأَتْ يَدِيَّ بِبِشْـرِها مَلَقا([25]) |
| نَظَمَتْ لها أَيْدِي مَلاحَتِها | خَرَزَ القُلوبِ بِجِيْدِها نَسَقا |
تتجلَّى ظاهرةُ التَّرف في شعر الغزل الصِّقلِّيِّ في صورة المرأةِ الصِّقلِّيَّةِ المُنْعَمَةِ المُتْرَفةِ، وتَظْهَرُ عنايةُ الصِّقلِّيِّين بأنواع الحُلِيِّ المتداخلة الَّتي يتفنَّنُ الصُّنَّاعُ في مزج عناصرها النَّفيسة، كأنْ تُكْسَى ياقوتةٌ بقشرة من الفضَّة، ثمَّ تُحَلَّى من أعلاها بحبَّات العقيق، وقد نقل الشُّعراء الصِّقلِّيُّونَ صورةَ تلك الحُلِيِّ الَّتي تفنَّن في تشكيلها الصَّائغون، فضمَّنوها غزليَّاتِهم، كالَّذي نجده في نسيج هذه الصُّورة الغزليَّة الرَّائقة من شعر عيسى بن عبد المنعم الصِّقلِّيِّ([26]):
| فَكَأنَّها في دِرْعِها وَخِمارِها الْـ | ـمُبيَضِّ والْـمُحْمَرِّ عِنْدَ المَنْظَرِ([27]) |
| ياقُوتَةٌ كُسيَتْ صَفِيحَةَ فِضَّةٍ | وَتَتَوَّجَتْ صَفْحَ الْعَقِيقِ الأَحْمَرِ([28]) |
ويجنح شعراء الغزل الصِّقلِّيِّ من خلال هذه الظَّاهرة إلى رصد التَّفصيلات الحسيَّة في الوصف الغزليِّ، ولا يُسْتَبْعَدُ أن يكون هذا التَّرف الَّذي نجده في صورهم الغزليَّة عاملاً في انتشار الغزل الحسِّـيِّ في الشِّعر الصِّقلِّيِّ، ويستحضـر شعراء هذا النَّمط صورةَ المجتمع المترف في أشعارهم من خلال رسم صورة المرأة رسماً حسيّاً مُتْرَفاً، لتبدوَ كأنَّها منحوتةٌ من مَعْدِنٍ نفيسٍ أو حَجَرٍ كريمٍ، فمن ذلك قول ابن الخالَةِ الفَرَضِيِّ في وصف صفاء أديم الوَجْهِ([29]):
| كأنَّ عليه من صفاءِ أديمِهِ | إذا اللَّحظُ أدماهُ عقيقاً وجوهرا([30]) |
يسرف بعضُ الشُّعراء الغزِلينَ في رسم تفصيلات تلك الصُّورة الحسِّيَّة للمرأة، فيُكثرون من الألفاظ الدَّالَّة على الذَّهب والفضَّة واللُّؤلؤ والدُّرِّ والعقيق والياقوت، ويستخدمونها في صورٍ متراكمةٍ نَلْحَظُ فيها حَشْدَ ألفاظ الجواهر وازدحامَها في النَّصِّ الشِّعريِّ على نحوٍ يُظْهِرُ المبالغةَ في اقتفاء أَثَرِ الصَّنعة في الوصف الغزليِّ، وأكثر ما يكون ذلك في شعرِهُمُ الغزليِّ الَّذي يُعنى بالتَّصوير الحسِّيِّ الماديِّ، كالَّذي نجده في صورة الثَّغر في شعر محمَّد بن عيسى الصِّقلِّيِّ([31]):
| عَسَلِيُّ الرِّيقِ خَمْرِيُّ الهوى | لُؤْلُؤِيُّ الثَّغْرِ دُرِّيُّ الكلامِ |
نجد مِثْلَ هذه البنية النمطيَّة للصُّورة المترفة في بعض شعر ابن الطُّوبيِّ (أبي عبد الله) الَّذي لا يخرج في تصويره للثَّغر والأسـنان عمَّا سبقَ ذِكْرُه، نحو قوله في هذا البيت([32]):
| فَمُهُ فِيهِ لُؤلُؤٌ في شَقِيقِ | فَوقَهُ خاتَمٌ لَهُ مِنْ عَقِيقِ([33]) |
إنَّ الميل إلى استخدام ألفاظ الجواهر والمعادن الثَّمينة في الشِّعر الغزليِّ معروفٌ في تراثنا الشِّعريِّ، غير أنَّ الشُّعراء الصِّقلِّيِّين بالغوا في ذلك، فحشدوا في أشعارهم تلك الألفاظ على نحوٍ لافتٍ للنَّظر، وعملوا في توليد صورهم المترفة، فجاءت مركَّبةً لا تخلو من تكلُّفٍ وافتعالٍ، كالَّذي نجده في تصوير الثَّغر من قول ابن القطَّاع([34]):
| إذا ابتسمَتْ يوماً حسبْتَ بثغْرِها | سُمُوطاً منَ الياقُوتِ قَدْ رُصِّعَتْ دُرّا([35]) |
وإذا جاءت الصُّورة المترفةُ مفردةً وجدْتَ الشَّاعرَ لا يكتفي بها، بل يطمح إلى توليد صورٍ أخرى تجري على نسق الصُّورة الأُولى الَّتي تستمدُّ مادَّتها من مصادر التَّرف المحيطة بالشَّاعر، ويستأنف نَظْمَه على هذا النَّهج، وربما حشدَ ذلك كلَّه في بيتٍ واحدٍ، كما في قول ابن طلحة الصِّقلِّيِّ([36]):
| مُفَضَّضُ الثَّغْرِ لهُ نُقْطَةٌ | مِسْكِيَّةٌ في خَدِّهِ المُذْهَبِ([37]) |
هذا التَّفصيل في معرض التَّصوير ينفي العفويَّة، ويؤكِّدُ عنصرَ الصَّنعة في بناء الصُّورة الشِّعريَّة، ويشفُّ عن أثر المجتمع المدنيِّ المترف في أشعار الصِّقلِّيِّين، فكأنَّهم يَمْتَحُون في بناء صورهم من معينٍ واحدٍ، مصدرُه ذلك المجتمعُ المُنْعَمُ، وهذه ظاهرةٌ بارزةٌ من ظواهر الشِّعر الصِّقلِّيِّ في العصـر الكلبيِّ الَّذي عُرِفَ بالازدهار والرَّخاء، على الرَّغم ممَّا كان يشوبه أحياناً من الفتن والقلاقل، وقد امتدَّت إلى شطرٍ من شـعر الصِّقلِّيِّين في العصـر النُّورمانيِّ، ويبدو أنَّ غِنى موارد صقلِّيَّة كان له أثرٌ في حياة أبنائها، كما كان له أثرٌ في نتاجهم الشِّعريِّ، وحملَتْ هذه الحياةُ المدنيَّةُ المترفةُ في نواتها المتناقضاتِ الَّتي ظهرت نتائجها في المجتمع الصِّقلِّيِّ في صورة اتِّجاهين متباينين تَرَكَا أثراً واضحاً في الشِّعر الصِّقلِّيِّ، وهما: شعرُ المجالس، ممثًّلاً بالطَّربيَّات والخمريَّات، والشِّعرُ الدِّينيُّ ممثَّلا بالزُّهد والتَّصوُّف، وذلك على الرَّغم مما بين الاتِّجاهين من التَّفاوت والاختلاف.
* * *
ثانياً ـ شعر المجالس (الطربيَّات ـ الخمريَّات):
ظهر هذا الاتِّجاهُ الشِّعريُّ بوضوحٍ لدى الصِّقلِّيِّين، وكانت له مكانةٌ بارزةٌ في أشعارهم، ويبدو أنَّهم أُغرِمُوا بالحديث عن تلك المجالس، الَّتي كانت تجسِّد الجانبَ اللَّاهيَ من الحياة الاجتماعيَّة في صقلِّيَّة، بما يشتمل عليه ذلك الجانبُ من الانغماس باللَّهو، والاستمتاع بمباهج العصر، وقد قامت المادَّةُ الشِّعريَّةُ لتلك المجالس على محورين رئيسين؛ هما: الطَّربيَّات والخمريَّات.
أ ـ الطَّربيَّات:
تمثِّل الطَّربيَّاتُ جانباً من الحياة المدنيَّة في صقلِّيَّة، وتجسِّد رغبةً جامحةً لدى الصِّقلِّيِّين في الإقبال على مجالس الأنس الَّتي كانوا يَعْقِدونَها في أجواء الطَّبيعة، ويجمعون لها الأصدقاء، يقول البَلَّنُّوبيُّ (أبو الحسن) يستدعي صديقاً([38]):
| فَهلْ لكَ يا فديتُكَ في صديقٍ | بَلَوْتَ ودادَهُ سِرّاً وجَهْرا([39])
|
| إذا واصلْتَ عَدَّ الشَّهرَ يوماً | وإنْ صارَمْتَ عَدَّ اليومَ شَهْرا
|
| لِنجنيَ مِنْ رياضِ الأُنسِ زَهْرا | وَنُطْفئَ مِنْ لهيبِ الشَّوق جَمْرا
|
| ونَصْطَحِبَ المَثالثَ والمَثاني | فَنَحْيا لَذَّةً ونموتَ سُكْرا
|
وكانوا يتخيَّرون لتلك المجالس من الصَّحْب مَنْ يلتمسون فيه خِفَّةَ الظِّلِّ وحُسْنَ المَحْضَـر، كقول ابن الودَّانيِّ (أبي الحسن عليِّ بن إبراهيم)([40]):
| مَنْ يَشْتَرِي منِّي النُّجومَ بليلةٍ | لا فَرْقَ بينَ نُجومِها وصِحابي([41]) |
| دارَتْ على فَلَكِ السَّماءِ ونَحْنُ قَدْ | دُرْنا على فَلَكٍ منَ الآدابِ |
| وأتى الصَّباحُ ـ فلا أتى ـ وكأنَّهُ | شَيْبٌ أَطَلَّ على سَوادِ شَبابِ([42]) |
ويغلب أن تكون مادَّةُ تلك المجالس من الغناء والرَّقص والخمر، لكنَّ الغناءَ مادَّتُها الأُولى وعنصرُها الرَّئيسُ، ويُعَدُّ الشَّاعرُ البَلَّنُوبيُّ (أبو الحسن) من الَّذين تَفَنَّنُوا في وصف المُغَنِّين، ويُلْحَظُ من خلال تحليل أحد مشاهد وصف المجالس في شعره أنَّهُ يمزج بين عناصر الطَّرَب والخمر وذِكْرِ النَّديم في وصفه لمُغَنٍّ صِقِلِّيٍّ بارعٍ يُدْعى القَفَّاص([43]):
| ظَلَلْنا بحُكْمِ الرَّاحِ نَغْنَمُ لَذَّةً | مِنَ العيشِ صَرْفُ الدَّهْرِ منها تناسانا |
| وعارَضَنا القَفَّاصُ يَعْرِضُ سِحْرَهُ | وَناهِيكَ بالقَفَّاصِ خِدْناً وإحسانا
|
| إذا قارَنَتْ أوتارُهُ نَغَماتِهِ | ظَلَلْتَ وإنْ لم تشربِ الرَّاحَ سَكْرانا |
| ولي مُؤْنِسٌ بينَ النَّدامى يَعُلُّني | إذا غَفَلُوا وَرْداً وراحاً ورَيحانا([44])
|
وقد صدرَ الشُّعراءُ الصِّقلِّيُّون في وصفهم للمغنِّين عن حسٍّ ذوقيٍّ للطَّربِ، وتفنَّنُوا في وصفهم للمُجِيدين منهم بما ينمُّ على رهافة حسِّ الطَّربِ والسَّماعِ لديهم، وذكروا براعةَ المغنِّين في التَّسـلية عن السَّـامعين، كقول ابن الطُّوبيِّ (أبي عبد الله) يصف مغنِّياً([45]):
| إذا غَنَّى يُزِيلُ الهَمَّ عَنَّا | ويأتينا بما نَهْواه مِنْهُ |
| لَهُ وَتَرٌ يُطالِبُ كُلَّ هَمٍّ | بِوِتْرٍ فالهمومُ تَفِرُّ عَنْهِ([46]) |
وقد امتدحُوا المُجيدين من المُغَنِّينَ وتعرَّضُوا بالنَّقد اللاذعِ لِمَنْ دونَهُم، ويُعَدُّ ابن الطُّوبيِّ (أبو عبد الله) مِنْ أبرزِ الشُّعراء الَّذين تجلَّتْ في شعرهم ظَّاهرة نقد المغنِّين المُسيئين، وللبحث وَقْفَةٌ عند هذه الظَّاهرة في دراستنا لمشهد النَّقد الاجتماعيِّ السَّاخر في الشِّعر الصِّقلِّيِّ([47]).
يبدو أنَّ مجالس الأُنس الصِّقلِّيَّةَ عُرِفَتْ ببعض المغنِّين ممَّن كانت لهم شهرةٌ، حتَّى إنَّ أمراءَ الأندلس كانوا يستقدمون بعضَهم من صقلِّيَّة، وتروي المصادرُ من أخبارهم في ذلك ما يصل إلى حدِّ الغرابة، فمنها ما رواه ابن الأبَّار عن المعتضد، قال: «يُحْكَى عن المُعْتَضِد خبـرٌ غريبٌ في نظيـره عنـد انصرام أيَّامِهِ، وبين يَدَي هجوم حِمامِهِ، وهو انعقادُ نِيَّتِهِ على استحضار مُغَنٍّ يَجْعَلُ ما يَبْتَدِئُ بِهِ فَأْلاً في أمره، وقد اسْتَشْعَرَ انقراضَ مُلْكِهِ، وحُلُولَ هلْكِهِ، فأرسل في الصِّقلِّيِّ المُغَنِّي، وكان قد قَدُمَ عهدُهُ به، فأجلسَهُ وآنسَهُ وأمرَهُ بالغناء فَغَنَّى»([48]).
وقد أَلِفَ الصِّقلِّيُّون عَقْدَ تلك المجالس، حتَّى غدا ذلك من العادات الاجتماعيَّة لدى العامَّة والخاصَّة، ولم يجد وجهاؤُهم غضاضةً في الجلوس إلى مُغَنٍّ أو سماع جاريةٍ، وحالُ الصِّقلِّيِّين في استحسان ذلك مثل حال الأندلسيِّين الَّذين كانوا يجتمعون لمجالس الطَّرب، ولم يَتَرَفَّع كثيرٌ من علمائهم أو قضاتهم عن حضورها، وقد نقل بعض العلماء الصِّقلِّيِّين صورةً لتلك المجالس في أشعارهم، فمن ذلك ما نجده في شعر ابن الطُّوبيِّ (أبي عبد الله) النَّحويِّ الطَّبيب من وصفٍ لتلك المجالس وما فيها من رقص وطَرَبٍ([49]).
كذلك حَفَلَ شعرُ المجالس الصِّقلِّيَّة بمشاهد الرَّقص، ويبدو من خلال الشِّعر أنَّ بعضَ الرَّقص كان يؤدِّيه رجالٌ، ومن شعر ابن الكَمُّونيِّ يصف راقصاً مُجِيداً في رَقْصِهِ([50]):
| ما إنْ رأيْتُ كَراقِصٍ | مُسْتَظْرَفٍ في كُلِّ فَنِّ([51]) |
| يَحْكِي الْغِناءَ بِرَقْصِهِ | كمُراقِصٍ يَحْكِي الْـمُغَنِّي([52]) |
| رِجْلاهُ مِزْمارٌ وعُـ | ـودٌ في نهايةِ كُلِّ حُسْنِ |
| فَهُوَ السُّـرورُ لِكُلِّ عَيـ | ـنٍ والنَّعيمُ لِكُلِّ أُذْن |
يرتبط وصفُ الرَّاقص في الأبيات بوصف إيقاع الرَّقص مع ذِكْرِ آلات الطَّرب كالعُود والنَّاي، وتتناول مشاهدُ وصفِ الرَّقص في الشِّعر الصِّقلِّيِّ براعةَ الرِّجال والنِّساء في ذلك، كالَّذي نجده في قول البلَّنُوبيِّ (أبي الحسن) يصف حِذْقَ راقصةٍ في مجلس طربٍ([53]):
| هيفاءُ إنْ رقصَتْ في مجلسٍ رقصَتْ | قلوبُ مَنْ حَولَها مِنْ حِذْقِها طَرَبا |
| خفيفةُ الوَطْءِ لو جالَتْ بِخَطْوَتِها | في جَفْنِ ذي رَمَدٍ لم يشتكِ الوَصَبا([54]) |
ولا يخلو بعضُ تلك المجالسِ الطَّربيَّةِ من وصفٍ مُتْرَفٍ تعود أصولُه إلى الغزل الحسِّـيِّ الَّذي انتشـر في الشِّـعر الصِّقلِّيِّ على نحوٍ لافتٍ للنَّظر، وقد يُشرِكُ الشَّاعرُ الطَّبيعةَ على اختلاف مظاهرها في تصوير مشهد الرَّقص ليجسِّدَ أجواءَ التَّرف والبَذَخ، كقول ابن حمديس([55]):
| ومِنْ راقصاتٍ ساحِباتٍ ذُيولَها | شَوادٍ بِمِسْكٍ في العَبِيرِ تَضَمَّخُ
|
| كما جَرَّرَتْ أذيالَها في هَدِيلِها | حَمائمُ أيكٍ أو طواويسُ تَبْذَخُ
|
عُرِفَتْ صقلِّيَّةُ بشهرة المغنِّين الَّذين حَرَصَ أمراءُ الأندلس على استقدامهم([56]) وعُرِفَتْ أيضاً بفنونٍ من الرَّقص خاصَّةٍ بها، فمن ذلك لونٌ من الرَّقصِ عُرِفَ بهِ الصِّقلِّيُّون ثمَّ وصل إلى الأندلس، وهو رقصٌ إيمائيٌّ يذكر تفصيلاتِهِ ابنُ حمديس في خَبَرٍ يروي فيه أنَّ أديباً من أهل الأندلس سأله أن يصف له ذلك النَّمط من الرَّقص، فأجابه بمقطَّعةٍ توضح ذلك على مَذْهَبِ الصِّقلِّيِّين في رقص قيناتهم([57]).
ولا يقتصر مشهد مجالس الأنس في الشِّعر الصِّقلِّيِّ على وصف المغنِّين والرَّاقصين، إذ نجد وصفاً للموسيقيِّين من الرِّجال والنِّساء، ممن يُحْسِنونَ العَزْفَ بآلات الطَّرَبِ، فمن ذلك قول الشَّاعر ابن حمديس في وصف زمَّارٍ مُتْقِنٍ يُرْسِلُ الألحانَ، فكأنَّها منبعثةٌ من الجِنان([58]):
| وذي حَنِينٍ تَحِنُّ أنفسُنا | إليهِ مُنْقَادَةً ومُنْجَذِبَهْ
|
| يُفْشِيهِ ذو حِكْمَةٍ، أنامِلُهُ | مُنَغِّماتٌ بِزَمْرِهِ ثُقَبَهْ
|
| يُرْسِلُ عن منخَرَيهِ مِنْ فَمِهِ | ريحاً لها نَغْمَةٌ مِنَ القَصَبَهْ
|
| كأنَّ ألحانَهُ الفصيحةَ مِنْ | صَرِيرِ بابِ الجِنانِ مُكْتَسَبَهْ
|
ونحو ذلك ما ورد في شعره من وصف ضاربات العُودِ، كقوله في وصف جاريةٍ تضربُ العودَ وهي تشدو بالغناء، فكأنَّما يدُها تنطقُ بالسِّحر، فتملأ نفوسَ السَّامعينَ بالطَّربِ الشَّجيِّ([59]):
| وَمنبَّهٍ في حِجْرِ مَنْ شَدَواتُها | تَثْني الهمومَ بها على الأعقابِ([60]) |
| وَكأنَّما الأجسامُ مِنْ إحسانِها | مُلِئَتْ بأرواحٍ مِنَ الإطرابِ |
| وكأنَّما يدُها فَمٌ مُتَكَلِّمٌ | بالسِّحْرِ فيه مِقْوَلُ المضـرابِ
|
برعَ الصِّقلِّيُّون في وصف آلات الطَّربِ، وأفادوا في وصفهم لها من مهارتهم في الغزل، فاستعاروا لها الأوصافَ الغزليَّةَ، وجاء الوصف وجدانيّاً نابضاً بالحياة والحركة، فضلاً عن الاستعانة بالتَّشخيص، كالَّذي نجده في وصف العُودِ في شعر الحسين بن أبي علي القائد([61]):
| ومَعاهِدٌ آنَسْنَني بأوانسٍ | يدنو السُّـرورُ بها وفيه شطونُ([62]) |
| خُمْصُ البُطونِ، صدورُها أفواهُها | جُعِلَتْ لها بَدَلَ النُّهودِ عيونُ |
| وذواتُ ألسنةٍ أسرَّ حديثُها الشْـ | شَاجي، وأفصحَ قولُها الملحونُ |
| يَصْدُرْنَ عنها عن صدورٍ ما بها | لمَّا تثيرُ منَ الحديثِ دَفينُ |
| مضمومةٌ ضمَّ الحبيبِ، مَخَمَّشٌ | منها صدورٌ تارةً وقُرونُ([63]) |
| يُضْـرَبْنَ عِنْدَ عِناقِهِنَّ، فَمَنْ رأى | أنَّ العِقابَ معَ العِناقِ يكونُ؟([64]) |
| فَكَما ضُرِبْنَ وما لَهُنَّ جِنايَةٌ | فَكَذا لَهُنَّ وما أَلِمْنَ أنينُ([65]) |
إن ابن حمديس من الشُّعراء الصِّقلِّيِّين الَّذين برعوا في وصف آلات الطَّربِ، فهو يَفْتَنُّ في إبداع الصُّورة الوصفيَّة للعود وأوتاره الَّتي يضربها العازفُ بأناملِهِ، فَتُصْدِرُ صوتاً شجيّاً تنجلي به الهموم([66]):
| يَمُدُّ كفّاً إليهِ ضارِبَةً | أَعْناقَ أحزانِنا إذا ضَرَبَهْ
|
| في حِجْرِهِ أَجْوَفٌ لَهُ عُنُقٌ | نِيطَتْ بظَهْرٍ تخالُهُ حَدَبَهْ([67])
|
ويصوِّرُ ابن حمديس العُودَ نابضاً بالحياة يتَلَّوى ألماً من شدَّة ضَرْبِ العازفة للأوتار، فيأتي بلَحْنٍ عَذْبٍ يقع في حِسِّ السَّامعِ مَوْقِعَ النَّسيم العليلِ منَ النَّفْسِ المُنَعَّمَةِ بعبير الرِّياض([68]):
| وذي قَتْلَةٍ بالرَّاحِ أحيَيْتُ سَمْعَهُ | بأجْوَفَ أَحْيَتْهُ مُمِيتَتُهُ ضَرْبا
|
| فَهَبَّ نَزِيفاً والنَّسيمُ مُعَطَّرٌ | فما خِلْتُهُ إلَّا النَّسِيمَ الَّذي هَبَّا
|
ولمَّا قرنَ ابنُ حمديس الرَّاحَ بالطَّرب عبَّرَ بذلك عن ظاهرة شاعَتْ في أشعار الصِّقلِّيِّين وفي مجالس أُنْسِهم هي المَزْجُ بين الخمر والطَّرب، وهذا يمهِّدُ للحديث عمَّا يُعرَفُ بالخمريَّات، فكيف تجلَّتْ هذه الظَّاهرةُ في أشعارهم وفي حياتهم الاجتماعيَّة؟ وما العناصر الَّتي قامت عليها الخمريَّاتُ الصِّقلِّيَّة؟.
ب ـ الخمريَّات:
تطوَّرَ وصف الخمر في الشِّعر العربيِّ حتَّى غدا تيَّاراً بارزاً من تيَّارات الشِّعر الوصفيِّ في القرن الثَّاني الهجريِّ، وكان ذلك التَّطوُّر بسبب التَّطرُّف في المتع الحسِّيَّة، ممَّا أسهم في انتشار شعر الأديرة الخمريَّة والحانات في الأدب العربيِّ، وأسهمَتْ عواملُ كثيرةٌ في ذلك الانتشار، كاختلاط العرب بالأعاجم، وامتدادِ حياةِ التَّرف في المجتمع العربيِّ المدنيِّ، حتَّى أصبح وصف الخمر مشهداً مألوفاً في القصيدة العربيَّة، بل إنَّه زاحمَ سائرَ مشاهدِها، فاحتلَّ موقعَ الصَّدارةِ في بناء النَّصِّ الشِّعريِّ، واستهلَّ بعضُ الشُّعراء العبَّاسيِّين من أصحاب المَنْهَجِ المُحْدَثِ مطالعَ قصائدهم بالمقدِّمة الخمريَّة، واستبدلوها بالمقدمة الطَّلليَّة، وأعلنَ بعضُ هؤلاء الشُّعراء كأبي نواس وغيره خروجَهُم على مقدمة الطَّلل، وذمُّوا الافتتاح بها([