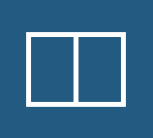الشعر السياسي في عصري الطوائف والنورمان
الشِّعر السِّياسيُّ في عصري الطَّوائف والنُّورمان
كتب الأستاذ الدكتور أسامة اختيار حول هذا الموضوع من كتاب ( جمهرة أشعار الصقليين تحقيق ودراسة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة ( 1437 هـ - 2016 م )
فقال :
مرَّ الشِّعر العربيُّ الصِّقلِّيُّ في عهدي الطَّوائف والنُّورمان بظروفٍ سياسيَّةٍ جديدةٍ تتلخَّص في اشتعال الفتنة بين أمراء الطَّوائف وتناحرهم على السُّلطة والنُّفوذ، ممَّا أطمع فيهم أعداءهم المتربِّصين من النُّورمان الَّذين وجدوا في خيانة أحد أمراء الطَّوائف المتناحرين عوناً لهم، ممَّا بسط لهم مسالك صقلِّيَّة، فسيطروا عليها وتحكَّموا في شؤونها بعد إقصاء أمراء الطَّوائف عن السُّلطة.
ونشأ عن هذه الظُّروفِ اضطرابٌ كبيرٌ في الحياة السِّياسيَّة في صقلِّيَّة، وظهرَ أثرُ ذلك في حركة الشِّعر الصقلِّيِّ، فبرز فيه اتِّجاه الشِّعر السِّياسيِّ، ويقوم هذا الاتِّجاهُ على رصد الأزماتِ السِّياسيَّةِ الَّتي عصفَتْ بصِّقلِّيَّة في عهدي أمراء الطَّوائف والنُّورمان، سواء من حيث وصف الشُّعراء لها، أم من حيث التَّعبيرُ عن مواقفهم منها، على اختلاف تلك المواقف وتعدُّدها.
قبل الشُّروع في دراسة الشِّعر السِّياسيِّ الصِّقلِّيِّ، لابدَّ من الوقوف على أثر الظُّروفِ السِّياسيَّةِ في أغراض الشِّعر الصِّقلِّيِّ بإيجازٍ، ممَّا يؤكِّدُ ارتباطَ الشِّعرِ الصِّقلِّيِّ ارتباطاً وثيقاً بالظُّروف المحيطة الَّتي تحدِّدُ هويَّتَه وترسم ملامحَ انتمائه، وتَبْرُزُ أهميَّةُ الأثر السِّياسيِّ في تحديد اتِّجاهاتِ الشِّعرِ الصِّقلِّيِّ من خلال تأثُّر الشُّعراء بالواقع تبعاً لاتِّجاهين؛ اتِّجاهٍ مباشرٍ تَبْرُزُ فيه موضوعاتُ الشِّعر السِّياسيِّ الصِّقلِّيِّ، وآخرَ غير مباشرٍ تَبْرُزُ فيه المؤثِّراتُ السِّياسيَّةُ في الأغراض الشِّعريَّة عامَّةً.
* * *
أوَّلاً ـ أَثَرُ الواقع السِّياسيِّ في أغراض الشِّعر الصِّقلِّيِّ:
تتجلَّى مظاهرُ تأثُّرِ الشُّعراء بالواقع فيما يتركه من انفعالاتٍ كامنةٍ في أعماق وجدانهم، ويَظْهَرُ ذلك في النَّسيج اللُّغويِّ للشِّعر الصِّقلِّيِّ على اختلاف موضوعاته، ويُعَدُّ ابنُ حمديس مِنْ أبرزِ الشُّعراءِ الَّذين مَثَّلَ شـعرُهم هذا التَّأثُّرَ، فمن ذلك ما ظهرَ في غزله في صورتَي الحربِ والسِّلْم([1]):
| وهَلْ لكَ سِلْمٌ عندَ مَنْ خُلِقَتْ حَرْبا
| سريعةُ غَدْرٍ سيفُها في جفونِها |
يفيض مخزون ذاكرة الشَّاعر بصور الحرب الَّتي شَهِدَها في ريعان شبابه في صقلِّيَّةَ، ويأتي بعض ذلك في سياق التَّضادِّ الصُّوريِّ بين صورة شبابِ الحبيبةِ وصورة شَيبِ الشَّاعر([2]):
| والحَرْبُ بينَ شبابها ومشيبي؟
| مِنْ أينَ أرجو أن أفوزَ بسِلْمِها |
ويجعل من جفاء الحبيبة نارَ حربٍ، ومن خالصِ مودَّتِهِ لها جنَّةَ سِلْمٍ، وكأنَّ الحبيبةَ في شعره هي المعادلُ الموضوعيُّ للوطن الَّذي يكابدُ نارَ الحربِ بعد نعيم السِّلْم ورَغَدِهِ([3]):
| نارَ حربٍ وكنْتُ جنَّةَ سِلْمِ
| غادةٌ أكثرَتْ خِلافي فكانَتْ |
ويصوِّر نفسَهُ في موضعٍ آخرَ عاشقَ سِلْم، أمَّا الَّتي يحبُّها فتميلُ إلى الحرب وتجنحُ إليها([4]):
| كما جنحْتِ لِحَرْبِكْ
| لقد جنحْتُ لِسِلْمي |
يجعل ابن حمديس صرعى الحبِّ في غير موضعٍ من شعره كصرعى الحربِ من حيث تَعَرُّضهم للموت والهلاك، نجد ذلك في هذا الخطاب الَّذي افْتَتَحَهُ بنداء بني الحرب حيث قابلَ بين الصُّورتين([5]):
| مثلكم في لقاء صَرْفِ المنونِ
| يا بني الحربِ ما بنو الحبِّ إلَّا |
تصدر هذه الصُّور الشِّعريَّةُ السَّابقةُ عن أثر الظُّروفِ السِّياسيَّةِ في شعر ابن حمديس، وتدلُّ على المرجعيَّةِ النَّفسيَّةِ لواقعِ الحربِ، ولا يقتصرُ أثرُ واقعِ الحربِ في شعره الغزليِّ على المعجم اللُّغويِّ الدَّالِّ على ألفاظ الحرب، ويتجاوز ذلك إلى ذِكْرِ ما يتعلَّقُ بها، ويؤكِّد الشَّاعر هذا المعنى في أبرزِ مواضعِ الإيقاعِ، وهو موضع القافية، ويكرِّرُ لفظَ (الجراح) في قافية شعره، فيعيبها بالإيطاء([6]):
| تَصِفُ الأسنَّةَ في الطَّعينِ جراحُ؟([7])
| نُجْلُ العيون جراحُها نُجْلٌ أمَا |
| شَهِدوا حروباً ما لهُنَّ جراحُ
| يا ويحَ قتلى العاشقينَ وإنْ هُمُ |
| حُورٌ تكافِحُ بالعيونِ مِلاحُ؟
| أوَما عَلِمْتَ بأنَّ فُتَّاك الهوى |
يُسْهِبُ الشَّاعرُ بعد هذه الأبياتِ في الاستعانة بمادَّة الحرب في غزله، ويستمدُّ صورَهُ الغزليَّةَ من أجواء القتال، مشبِّهاً القَدَّ بالرمح، والدَّلَّ بخداعِ الحربِ، ويجعل حُمْرةَ وَجْنَتَي موصوفتِهِ من دماء أهلِ العشقِ، يقول([8]):
| فكأنَّ قتلاهُمْ عليها طاحُوا
| ودماءُ أهلِ العِشْقِ في وَجَناتِها |
وينصرف إلى وصف الخمر في القصيدة ذاتِها، فيُغِير على معاني الحرب، ويستمدُّ من معجمها اللُّغويِّ عناصرَ صوره الوصفيَّة على النَّحو السَّابق، ويبدو القتالُ ماثلاً في مُخَيِّلتِهِ حين يجعل الخمرَ سَبِيَّةَ حربٍ، تُسْبَى من خوابيها بكؤوس الذَّهبِ الملتويـةِ كالصَّوارم، ويستحضر صورتَي الفسادِ والإصلاحِ المقترنتين بنتائج الحروب، فينسج منهما صورةَ الخمرِ الَّتي إنْ مَزَجَتْها بالماءِ غانيةٌ إصلاحاً لها أفسدَتْ بها العقول([9])، ويبدعُ في نسج الصُّورة الحركيَّة لمزج الخمر بالماء في موضعٍ آخرَ من شعره، فيصوِّر الخمرةَ عروقاً من النَّار جرى فيها الماءُ فجنحَتْ إلى السِّلْم بعد ثورة الحربِ، ويجعلُ مَزْجَها ابتغاءً لسِلْمِها واتِّقاءً لغَضْبَةِ حَرْبِها([10]):
| رِضا السِّلْمِ منها يَتَّقي غَضَبَ الحربِ
| جرى في عروقِ النَّار ماءٌ كأنَّما |
يصف الشَّاعر ليلَهُ الطَّويلَ في فراق مَنْ أَحَبَّ، ويأملُ أن يُوهِنَ طولُ اللَّيلِ قوَّةَ الفراقِ، فيسالمَ الفراق ويُهادنَ بعد طول حربٍ([11]):
| وتُفضي به حربُ الفراقِ إلى الصُّلْحِ
| عسى طولُه يثني عَنِ البَينِ عَزْمَهُ |
وحين يذكر زمانَ الصِّبا في صقلِّيَّةَ في وصفِهِ مجلسَ أُنسٍ تستدعي ذاكرتُه صورتَي العَزْلِ والتَّمْليكِ اللَّتين شاعتا في الحياة السِّياسيَّةِ في صقلِّيَّة في أثناء القلاقل، فيشبِّهُ زمانَ صِباه بحاكمٍ يعزلُ الهمومَ ويُمَلِّكُ الأفراحَ([12]):
| عَزَلَ الهمومَ ومَلَّكَ الأفراحا
| جُرْنا على زمنِ الصِّبا الزَّاهي الَّذي |
تظهر صورتا العَزْلِ والتَّمْليكِ لدى غيرِه من الشُّعراءِ، فمن ذلك ما نجده في غزل البَلَّنوبيِّ (أبي الحسن) كقوله يذكرُ ما صنعَ به فراقُ الأحبَّة([13]):
| تنأى الحياةُ بهِ ولا أهْلا
| لا مرحباً بالبينِ من أَجَلٍ |
| فالآنَ أصبحَ بُعْدُكُمْ عَزْلا
| قد كان لي مُلْكاً دُنُوُّكُمُ |
إنَّ حضورَ الوطن في ديوان ابن حمديس بارزٌ، ويبدو الحبُّ لديه معادلاً موضوعيّاً لتجربة الغربة، ولذلك يذكر عشقَهُ لغريبةٍ مِثْلِهِ([14]):
| وكئيبٍ شجاهُ شَجْوُ كئيبَةْ
| كم غريبٍ حنَّتْ إليهِ غريبَةْ |
ترتبط صورةُ الحبيبةِ في شعره بصورة الوطن ارتباطاً يدلُّ على عُمْقِ العلاقة بين الطَّرفين، وكأنَّما الوطنُ هو الحبيبةُ، والحبيبةُ هي الوطن([15]):
| وَطَنٌ وُلِدْتُ بأرضِهِ ونَشيتُ
| رشأٌ أحنُّ إلى هواهُ كأنَّهُ |
يمثِّل الوطنُ في شعر ابن حمديس حصيلةَ ذكرياتِ الصِّبا، وبقايا صور الماضي السَّعيد، إنَّه بلدُ الصَّبابة والحبِّ، وموطنُ الأُسُودِ الأبطالِ([16]):
| كِناسَ الظِّباء وغِيلَ الأُسُودِ([17])
| ولله أرضي الَّتي لم تَزَلْ |
ترتبط البنيةُ الدلاليَّةُ للصُّور السَّابقة بظلال ذكريات ابن حمديس في وطنِهِ (صقلِّيَّةَ) الَّذي وُلِدَ فيه، ودَرَجَ على أرضه، وقد غادره لمَّا دخلَهُ النُّورمانُ مُحْتَلِّينَ له، وتبقى صورةُ الوطن ماثلةً في أغراض شعره كلِّها، حتَّى إنَّه يذكرُ غُرْبتَهُ في سياق ثنائه على ممدوحه([18]):
| عن مغانيه غُرابٌ فاغْتَرَبْ
| أنا مَنْ صاحَ به يومَ النَّوى |
ويرسم أبو العربِ الصِّقلِّيُّ في غزليَّاته أخلاقَ الفارس الذي خَبِرَ الأهوالَ، وأوردَ نفسَهُ مواردَ التَّهْلُكَةِ، ويتَّخذُ من سيفِهِ حليفاً له من دون إخوان الصَّفاء، ولا يرى نصراً يكون من دونه([19]):
| قُلْتُ: الْـمُتَيَّمُ مِقْدامٌ على الغَرَرِ([20]) | قالَتْ: تَجَشَّمْتَ في سُبْلِ الهَوَى غَرَراً |
| تَهَيَّبَ الوِرْدَ حتَّى عادَ بالصَّدَرِ([21]) | لا كَالهَيُوبِ [وَقاهُ] الخَوفُ بُغْيَتَهُ |
| أَذْكَى مِنَ الزُّرْقِ في الخَطِيَّةِ السُّمُرِ([22]) | تَوَقَّ رِقْبَةَ أعداءٍ عُيُونُهُمُ |
| إنِّي بغَيْرِ الْيَمانِي غَيْرُ مُنْتَصـِرِ | قُلْتُ: الْيَمانِي حَلِيفِي ما يُفارِقُنِي |
| ما غَيَّرَتُهُ صُروفٌ جَمَّةُ الغِيَرِ | رَضِيْتُهُ دونَ إخوانِ الصَّفاءِ أخاً |
يكشف شعر أبي العرب الصِّقلِّيِّ أثرَ الواقعِ السِّياسيِّ في الشُّعراء الَّذين دفعَهُم احتلالُ وطنهم إلى الهجـرة قسـراً، فغادروه يحملون في وجدانهم ذكريات الزَّمن الماضي، وآلامَ الزَّمن الحاضر المُثْقَلِ بوحشةِ الغربةِ([23]):
| فَقْدُ المُدامةِ واستيحاشُ مُغْتَرِبِ
| بَرِمْتُ باثنين ِضاقَ الصَّدْرُ بينَهُما |
يجسِّدُ هذا التَّأثيرُ الواضحُ للظُّروف السِّياسيَّة في أغراض الشِّعر الصِّقلِّيِّ أثرَ الواقع في نفوس الشُّعراء الصِّقلِّيِّين، ويعرض ضرباً من إبرازِ المهارةِ الفنيَّةِ في تنويع مصادر الصُّورة الشِّعريَّة على اختلاف موضوعات الشِّعر، ممَّا يضفي عليها سمةً فنِّيَّةً جماليَّةً، فمن ذلك ما نجده في وصف عبد الحليم بن عبد الواحد لبعض شعراتٍ سودٍ في رأسه الَّذي غزاه الشَّيب، فكأنَّها مهزومُ حربٍ، أو أسارى الزَّنج في معسكر الرُّوم، يقول([24]):
| هَمَمْتَ بأنْ تُخْفِي بقايا شَبِيبَةٍ | كَغُرَّةِ لَيْلٍ أو حُشاشَةِ مَهْزُومِ([25]) |
| تَرَى الشَّعَراتِ السُّودَ والبِيْضَ حولَها | كَمِثْلِ أَسارَى الزَّنْجِ في عَسْكَرِ الرُّومِ([26]) |
يتفنَّنُ الشُّعراء في استحضار معجم الحرب في أشعارهم، تمثيلاً للواقع السِّياسيِّ الَّذي عاشوه، كالَّذي نجده في وصف أبي الحسن بن عبد الله الطَّرابُنشيِّ لشعرةٍ بيضاءَ ظهرَتْ في رأسِهِ فعاجلَها بالنَّزْعِ، وقد رسمَ لها صورتين متقابلتين، فشخَّصها في صورة المعاتِب حيناً، والمهدِّدِ المتوعِّدِ حيناً، واستمدَّ من الواقع السِّياسيِّ صورةَ الضَّعفِ للتَّعبيرِ عن العِتابِ، وصورةَ الجيشِ للتَّعبير عن الوعيد([27]):
| وزائرة ٍللشَّيبِ حلَّتْ بعارضي | فعاجلْتُها بالنَّتْفِ خوفاً مِنَ الحَتْفِ([28]) |
| فقالَتْ: على ضعفي اسْتَطَلْتَ ووَحْدَتي | رُويدَكَ للجيش الَّذي جاء مِن خَلْفي([29]) |
ويبدو أنَّ ما خلَّفَتْهُ الأزماتُ السِّياسيَّةُ من نكباتٍ قد لقيَ صدًى في وجدان الصِّقلِّيِّين وعمَّقَ إحساسَهُمْ بالأسى، وشاعت الشَّكوى في شعرهم عند اشتداد الملمَّات، فوصفوا تغيُّراتِ الزَّمان وتقلُّباتِ أحوالِهم، وقد ظهر ذلك في شعر ابن الخيَّاط، الَّذي كان مُقْبلاً على مُتَعِ الحياةِ أيَّام عيشِهِ في كنفِ الأمراءِ الكلبيِّين، حتَّى إذا انقضى عهدُهم وآلَ الحكمُ إلى أمراء الطَّوائفِ واضطربت البلادُ لزمَ نفسَهُ وراحَ يشكو صروفَ دهره([30]):
| يَعْلُونَ، والأخيارُ فيها تَسْفُلُ
| لا تَعْجَبَنَّ لِرُتْبَةٍ أَشْرارُها |
| والرَّاجحون هُمُ الَّذين تَنَزَّلوا
| فالنَّاقصون همُ الَّذين عَلَوا بها |
| في كفَّةٍ ويَحُطُّ فيها الأثْقَلُ؟
| أوَما ترى الميزانَ يعلو خِفَّةً |
ينظر ابن الخيَّاط في اضطرابات الدَّولة الكلبيَّة في أواخر عهدها، وما كان من تقلُّبات الحياة السِّياسيَّـة في عصـر أمـراء الطَّـوائف، والصِّراع النَّاشب بين النَّاس والملوك، فيُؤْثِرُ اعتزالَ ذلك كلِّه، ويعزف عن أمور السِّياسة والخوض في ذلك الصِّراع، يقول([31]):
| إنَّ سَبَّ الملوكِ من شُعَبِ المو | تِ، فإيَّاكَ أنْ تَسُبَّ الملوكا |
| إنْ عَفَوا عنكَ بالذُّنوبِ أهانو | كَ، وإنْ عاقبوا بها قتلوكا |
وقد أثَّرَ في شعره انقضاءُ عهدِ الكلبيِّين الَّذين نَعِمَ في كنفهم بالأمان، كما نَعِمَ بجزيل عطاياهم جزاءَ مديحِهِ، فمضى يرقبُ تداولَ الأيَّام وتغيُّر الأحوال في بلاده، ويَحْمِلُ نفسَهُ على الصَّبر، ويواسيها بسُنَّةِ التَّعاقبِ، ويجد في ذلك عزاءً فيما نزل به من البلاء([32]):
| لِحُكْم ِالتَّعاقُبِ فيها عَمَلْ
| أرى كُلَّ شيءٍ لهُ دولةٌ |
| لشـيءٍ إذا ما تناهى انتقلْ
| فلا تَفْرَحَنَّ، ولا تَحْزَنَنَّ |
ويبدو أنَّ معاصرةَ ابنِ الخيَّاط لفتنةِ تناحـرِ أمراءِ الطَّوائفِ في بلاده دَفَعَتْـهُ إلى أنْ يُقِلِّبَ بَصَرَهُ فيما كان من الأمان فانقضى، وما آلَتْ إليه الحالُ من الاضطراب، ولاسيَّما أنَّه عاصرَ تقلُّبَ الزَّمان في حالي السُّرور والأسى، فيقول في هذا المعنى([33]):
| وما يكونُ غداً في الغيبِ موعودُ
| ما كان أمسِ فقد فاتَ الزَّمانُ به |
| في حالتيهِ فمذمومٌ ومحمودُ
| وبينَ ذَينِكَ وَقْتٌ أنتَ صاحبُهُ |
كذلك عاصر ابنُ الطُّوبيِّ (أبو الحسن) تسلُّطَ النُّورمان على صقلِّيَّةَ، وما كان من زوالِ الحكم العربيِّ فيها، وشَهِدَ تعاظُمَ الخطوبِ في البلاد، فَبَرَزَ في شعره أثرُ تلك الظُّروف السِّياسيَّة([34]):
| وإنَّ أذاهُ لِلْكِرام ِلظاهِرُ
| أجارتَنا إنَّ الزَّمانَ لجائِرُ |
| ومن ذا على ريبِ الحوادثِ صابرُ
| أجارتَنا إنَّ الحوادثَ جَمَّةٌ |
يبدو أنَّ ما نتجَ من تلك الفتنِ دفعَ بعضَ الشُّعراءِ إلى التَّعبير عن الإحساس بالخوف، وظهرَ أثرُ تلك الاضطراباتِ في نفوس الشُّعراءِ، فنراهم يتقلَّبون بين السُّرور والكَمَدِ مع تَغَيُّرِ الأحوال من الأمن إلى الخوف، إذ لا يروم المرءُ السَّلامةَ في أرضٍ يَتَخَطَّفُها الخوفُ، وفي هذا المعنى يقول جعفر بن الطيِّب الكلبيُّ([35]):
| وشاكرُ حالةٍ حِيناً وشاكِ
| ضحوكٌ مرَّةً جَهْداً وباكِ |
| يرومُ سلامةً تحتَ الهلاكِ
| ومُغْتَبِطٌ بعيشٍ غيرِ باقٍ |
| وعلَّتْ بالعَليلِ عنِ الحَراكِ([36])
| ألا يا حارِ قد حارَتْ عقولٌ |
| فَحاوِلْ أن يكونَ على السِّماكِ | وإنْ شَيَّدْتَ لي يا حارِ بيتاً |
| فإنِّي والحوادث في عِراكِ
| وأبعِدْ إنْ قَدَرْتَ على مكانٍ |
وقد ظهرَ أثرُ الواقعِ السِّياسيِّ في رثائيَّاتهم أيضاً، فمن ذلك ما نجده في رثاء ابنِ السُّوسيِّ (عثمان بن عبد الرَّحمن) لأحدِ قادةِ المسلمين في صقلِّيَّةَ في دَرْجِ ذِكْرِه ما حلَّ بها من الفتن، فَيَعْظُمُ عليه فَقْدُه، ويصوِّر حِمامَ الموتِ يلتقط أرواحَ أهلِ الخير، فيصطفي من النَّاس خِيارَهم([37]):
| رِكابُ المَعالِي بالأَسَى رَحْلَهُ حَطَّا | وَطَودُ العُلا العالي تَهَدَّمَ وانْحَطَّا([38]) |
| أُصِيبَ فما رَدَّ الرَّدى عَنْهُ رَهْطُهُ | بَلَى أَوْدَعَ الأحزانَ إذ وَدَّعَ الرَّهْطَا([39]) |
| كأنَّ حَماماً للحِمامِ قَدِ انْبَرى | لأرواحِ أهلِ الفَضْلِ يَلْقُطُها لَقْطَا |
| عزاءً عَزاءً، قَدْ مَحا المَوْتُ قَبْلَنا | مُلُوكاً كما يَمْحُونَ مِنْ كُتُبٍ خَطَّا |
يصدر بعضُ شعر الصِّقلِّيِّين عن نمطٍ جديدٍ من العزاء لِفَقْدِ مَنْ يُحِبُّون، فنرى الشَّاعرَ يُعَزِّي نفسَهُ في إخوانه، ويبدو النُّزوع إلى التَّشاؤم في كثيرٍ من أشعارهم في هذا الصَّدد، كالَّذي نجده في شعر ابن الشَّاميِّ (أبي الفضل) حين يذكر موتَ أحدِ خِلَّانِهِ، فيرى الموتَ خيراً للمرء من حياةٍ غَشِيَها القلقُ والهوانُ والخوفُ، في ظِلِّ هذه التَّقلُّباتِ السِّياسيَّةِ والاضطراباتِ الاجتماعيَّةِ([40]):
| ولا الخيرُ مجلوبٌ بعِلْمٍ ولا فَهْمِ
| فلا البؤسُ مدفوعٌ بما أنتَ جازعٌ |
| وأهونُ من عيشٍ يَشِينُ ومِنْ وَصْمِ
| تَعَلَّمْ بأنَّ الموتَ أزينُ للفتى |
ولم يقتصر تأثُّرُ الشِّعر الصِّقلِّيِّ بالواقع السِّياسيِّ على الاستحضار غيرِ المباشرِ لصور ذلك الواقع في الأغراض الشِّعريَّة، بل تجاوزَ ذلك إلى تصوير الواقعِ السياسيِّ تصويراً مباشراً.
وقد عبَّر بعضُ الشُّعراء عن موقفهم من الفتنة في أواخر عهد الدَّولة الكلبيَّة وفي مطلع عصر أمراء الطَّوائف، وسنقف عند هذا الجانبِ من الشِّعر الصِّقلِّيِّ وقفةً تفصيليَّةً في العنوان الآتي.
* * *
ثانياً ـ موقف الشِّعر من الفتنة في عصر الطَّوائف:
يمكننا حَصْرُ مواقفِ الشِّعرِ الصِّقلِّيِّ منَ الفتنةِ في ثلاثةِ مواقفَ؛ يتلخَّصُ أوَّلها في رصد تطوُّراتِ الفتنة وما كان من شأنها، ويعبِّرُ الموقفُ الثَّاني عن صوت اليأس إزاءَ احتدام الأزمةِ السِّياسيَّةِ واشتجارِ الفتنةِ، ويصدرُ الموقفُ الثَّالثُ عن الدَّعوة إلى استنهاض الهِمم للجهاد ضدَّ النُّورمان المتربِّصين.
أ ـ رصد تطوُّر الفتنة:
نشأت بذور الفتنة في أواخر عهد الدَّولة الكلبيَّة، حين وَلِيَ صقلِّيَّةَ عددٌ منَ الأمراء الكلبيِّين الَّذين أساؤوا السِّـيرةَ، فثار النَّاس عليهـم، واحتـدم الصِّراع في إمارة تأييد الدَّولة أحمد بن يوسف الكلبيِّ الملقَّب بالأكحل([41])، وسجَّل الشِّعر الصِّقلِّيُّ استعانةَ الصِّقلِّيِّين بالمُعِزِّ بن باديس (ت 453ﻫ) لنجدتهم([42])، وقد أرسل المُعِزُّ جيشاً عظيماً لنُصْرَة الصِّقلِّيِّين جَعَلَ عليه ولدَهُ عبد الله، ووصلَتْ إلينا قصيدةٌ لمحمَّد بن أحمدَ الكَلاعيِّ وثَّقَتْ هذا الحَدَثَ، وذكر الشَّاعر فيها ما عاناه الصِّقلِّيُّون من ظُلْم أمراءِ الطَّوائف، وأثنى فيها على قائد الجيش عبد الله بن المعزِّ([43]):
| اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْدَى الْجَورُ وانْقَشَعَتْ | سُحْبُ النِّفاقِ وزالَ الحادِثُ النُّكُرُ |
| يا أيُّها الْـمَلِكُ الْـمَيمُونُ طائِرُهُ | وكاشف الضُّـرِّ عن قومٍ به انْتَصَرُوا([44]) |
| غادرْتَ كُلَّ عَزِيزٍ كان مُمْتَنِعاً | وَوَجْهُهُ بينَ أَيْدِي الخَيلِ مُنْعَفِرُ |
| والبِيضُ تَضْحَكُ والأعناقُ قَدْ سَفَحَتْ | دَمْعاً منَ الدَّمِ في الأجسادِ يَنْحَدِرُ([45]) |
| رميتَهُمْ بخَمِيس ٍلو رَمَيْتَ بهِ | دعائمَ الدَّهرِ كادَتْ مِنْهُ تَنْفَطِرُ([46]) |
| ما طالَ بَغْيُ أُناسٍ قَطُّ مِنْ بَطَرٍ | إلَّا وأصبحَ في أعمارِهِمْ قِصَـرُ([47]) |
| إنْ غرَّهُمْ مِنْكَ حِلْمٌ قَدْ عُرِفْتَ بهِ | فالمَرْخُ يُضْرِمُ ناراً عُودُهُ النَّضِـرُ([48]) |
يذكر الشَّاعرُ انتصارَ الصِّقلِّيِّين بالمُعِزِّ، ويستعين بثقافته الأدبيَّـة المشرقيَّة في رسم صورة مَلِكِهِ المظفَّرِ في حربه، فيقرن خوضَ الغَمْرِ بيُمْنِ الطَّائر ممَّا يوحي بأثرٍ من قول الأخطلِ الشَّاعرِ الأمويِّ([49]):
| خليفةُ اللهِ يُستسقى بهِ المطرُ
| الخائضُ الغَمْرَ والميمونُ طائرُه |
كذلك يذكرُ ابنُ الخيَّاطِ الفتنةَ، وما تفاقم من أمرها على ضعف بَدْئها أوَّلَ الأمرِ، فيقول([50]):
| رُبَّ شأنٍ يكونُ منه شوؤنُ
| لا يَهُنْ بعدَها عليكَ حقيرٌ |
ويستعين بعضُ أمراء الطَّوائف بالنُّورمان انتصاراً بهم على أبناء جِلْدَتِهِمْ، ويسيطر النُّورمانُ على صقلِّيَّةَ سنة (444ﻫ) فيسومون أهلَها سوءَ العذابِ، ويعزلون أمراءَ الطَّوائف جميعاً، وتتكرَّر فصولُ هذه الخيانةِ بعد ذلك في الأندلس بسقوط غَرْناطةَ (897ﻫ) ويسجِّلُ السَّمَنْطاريُّ خيبةَ أمل الصِّقلِّيِّين في أحد أمراء الطَّوائف حين خان الإسلامَ والعروبةَ، فَمَهَّدَ مسالكَ صقلِّيَّة للنُّورمان([51])، ويصوِّر الشَّاعرُ هذه الخيانةَ، ويذكر موقفَهُ من بعض أمراء الطَّوائف، يقول([52]):
| فِتَنٌ أقبلَتْ وقَومٌ غُفُولُ | وزمانٌ على الأنام يَصُولُ |
| رَكَدَتْ فيهِ لا تُرِيدُ زَوالاً | عَمَّ فيها الفَسادُ والتَّضلِيلُ |
| أيُّها الخائنُ الَّذي شأنُهُ الإثْـ | ـمُ وكَسْبُ الحرام ماذا تقولُ؟ |
| بِعْتَ دارَ الخلودِ بالثَّمَنِ الْبَخْـ | ـسِ بِدُنيا عَمَّا قَرِيبٍ تَزُولُ |
وكان ممَّا نجمَ عن الفتنة توزُّعُ الشُّعراء الصِّقلِّيِّين على أمراء الطَّوائف في إماراتهم الصَّغيرة يتكسَّبون بمدحهم، غير أنَّ قِصَرَ المدَّةِ الَّتي حكموا فيها لم تؤثِّر تأثيراً واضحاً في حركة الشِّعر الصِّقلِّيِّ، باستثناء بروز الاتِّجاه السِّياسيِّ بروزاً جليّاً، إذ واكبَ الشِّعر الصِّقلِّيُّ الظُّروفَ السِّياسيَّةَ الجديدةَ، فَسَجَّلَ خَطَراتِ نفوسِ الشُّعراء ومواقفهم من الفتنة، وعبَّرَ الشُّعراءُ عند استفحال شأنِ الفتنةِ أواخرَ عهد أمراءِ الطَّوائف عن موقفين متباينين؛ موقفٍ سيطرَ عليه صوتُ اليأس فدعا إلى الرَّحيل عن صقلِّيَّةَ طلباً للأمن، وآخرَ دعا إلى نَبْذِ الشِّقاقِ وجَمْعِ الشَّمْلِ لمواجهة الأخطارِ المُحْدِقَةِ.
* * *
ب ـ صوت اليأس والدَّعوة إلى الرَّحيل:
أحسَّ بعضُ الشُّعراء الصِّقلِّيِّين بالفاجعة بعد تطوُّر الفتنة، فسيطرَ على أشعارهم تقريعُ أمراء الطَّوائف الَّذين هدَّدوا باشتجارِهِمْ أمنَ صقلِّيَّة، وظهرَ اليأسُ من صلاح الأمر بعد استفحال الفساد، وقد رسمَ سليمانُ بن محمَّد الطَّرابُنشيُّ صورةً للحياة السِّياسيَّة حينئذٍ، ووجدَ الخلاصَ في الرَّحيل([53]):
| عجِبْتُ لِمَعْشَـرٍ عَزُّوا وبَزُّوا | ولم يَصِلُوا إلى الرُّتَبِ السَّوامِي([54]) |
| طلَبْتُ بهِمْ مِنَ العَدَم انْتِصاراً | فَأَشْبَهْتُ ابنَ نُوْحٍ في اعْتِصامِي([55]) |
| تَقَلَّبَ دَهْرُنا فالصَّقْرُ فيهِ | يُطالِبُ فَضْلَ أرزاقِ الحَمامِ |
| على الدُّنيا العَفاءُ، فقد تَنَاهى | تَسَـرُّعُها إلى أَيْدِي اللِّئامِ([56]) |
| وما النَّعْماءُ لِلْـمَفْضُول إلَّا | كَمِثْل الحَلْيِ للسَّيفِ الكَهامِ([57]) |
| ذَرِينِي أَجْعَلِ التِّرْحالَ سِلْكاً | أُنَظِّمُ فيهِ ساحاتِ المَوامِي([58]) |
| فإنِّي كالزُّلال العَذْبِ يُؤْذي | صَفاهُ وطَعْمَهُ طُولُ المَقامِ |
عبَّر الشَّاعر في الأبيات السَّابقة عن خيبة أملِهِ بأمراء الطَّوائف الذين كانوا وبالاً على الأمَّة، إذ أغرقوها في التَّناحر على المُلْكِ، وشبَّهَ حالَهُ معهم بابن نوحٍ، الَّذي غَرَّهُ عقلُه، فظنَّ أنَّ اعتصامَه بالجبل سيحميه من الطُّوفان، فكان من المُغْرَقين، وظهرَ في الأبيات الموقفُ السَّلبيُّ من الواقع السِّياسيِّ.
يوازن الشُّعراء بين نعيم الأمنِ في جنَّةٍ كانوا يستظلُّون بظلالها، وما آلَتْ إليه من الجحيم الذي باتوا يَصْلَون نارَه، حتَّى أضحَوا يفتقدون الأمنَ والحياةَ الوادعةَ الهانئةَ التي كانوا يرفلون فيها، ونجد صورةً قاتمةً لهذا الواقع الجديد المؤلم في شعر عبد الحليم بن عبد الواحد([59]):
| عَشِقْتُ صِقِلِّيَةً يافِعاً | وكانَتْ كَبَعْضِ جِنانِ الخُلُودِ |
| فَما قُدِّرَ الوَصْلُ حتَّى اكْتَهَلْتُ | وصارَتْ جَهَنَّمَ ذات الوَقُودِ |
تقابل هذه الرُّؤيةَ السَّلبيَّةَ للواقع رؤيةٌ متَّزنةٌ تتَّسمُ بنظرةٍ واقعيَّةٍ تُحْسِنُ التَّصرُّفَ في المُلِمَّاتِ، وتتجلَّى فيها الدَّعوةُ إلى استثارة العزائم، والتَّنبيهُ على خطر النُّورمان الَّذين شرعوا في التَّسلُّل إلى صقلِّيَّة مستغلِّينَ ظرفَ الفتنةِ الناشئةِ.
ج ـ تيَّار الاستنهاض والتَّنبيه:
دعا الشُّعراء في هذا التيَّارِ إلى ضرورة مواجهةِ الفتنةِ بحكمةٍ وشجاعةٍ، وحَمَلُوا مسؤوليَّةَ النِّداء إلى جَمْع شَتاتِ الأمَّةِ لتجاوزِ الفتنةِ وتوحيدِ الصَّفِّ في مواجهةِ الأخطارِ المُحْدِقةِ بالبلاد، وكان من بين هؤلاء شاعران مبرَّزان هما: ابن الخيَّاط والقاسم بن عبد الله التَّميميُّ.
يُعَدُّ ابنُ الخيَّاطِ من الشُّعراء الَّذين لَزِموا الصَّمْتَ حينَ الفتنةِ الَّتي اشتجرَتْ بين الصِّقلِّيِّين والأمراء الكلبيِّين، لكنَّ المتغيِّراتِ السِّياسيَّةَ الجديدةَ فرضَتْ عليه التَّدخُّلَ في الْتِماسِ الحَلِّ للأمَّةِ بعد أن أدركَ تربُّصَ النُّورمان بالبلادِ منتهزين اشتعالَ الحرب بين أمراء الطَّوائف أنفسِهِمْ، فحذَّرَ من ذلك الخطر، ودعا إلى تجاوُزِ الخلافاتِ حرصاً على سلامةِ البلادِ قبلَ أن يستفحلَ وباءُ التَّنازع فيستعصي أمره، فمن ذلك قوله يشبِّهُ ما نزل في البلاد من خَطْبِ البلاءِ بفسادِ الجُرْحِ الَّذي قد يُعْجِزُ الطَّبيبَ إنْ أُهْمِلَ علاجُه([60]):
| إذا نَغِلَتْ أَعْيَتْ مَطَبَّةَ آسِ
| وقُلْتُ: تَلافَوا شَجَّةَ الدَّهْرِ إنَّها |
إذا كان جُلُّ شعر الصِّقلِّيِّين في عصر أمراء الطَّوائف مفقوداً؛ فثمَّةَ قصيدةٌ طويلةٌ تقع في أربعةٍ وأربعينَ بيتاً تقدِّمُ صورةً كاملةً للواقع السِّياسيِّ بتفصيلاتِه الدَّقيقةِ، والقصيدةُ للقاسم بن عبد الله التَّميميِّ، وهي أتمُّ ما وصل إلينا من شعر الصِّقلِّيِّين السِّياسيِّ في عصر الطَّوائف، ويكشف تحليلُ البنية التَّكوينيَّة للقصيدة عن أربع بنياتٍ مقطعيَّةٍ يتجلَّى فيها عمقُ المؤثِّرات السِّياسيِّة، ويسيطر الغرض الشِّعريُّ الرَّئيس (الموضوع السِّياسيُّ) على مضمونها الدِّلاليِّ، وإذا تأمَّلنا البنيةَ الأولى، وهي المطلَعُ الاستهلاليُّ؛ وَجَدْنا أثرَ الظُّروفِ السِّياسيَّةِ ماثلاً في المقدِّمة الغزليَّة الَّتي تشفُّ عن مشاعر الخوف وافتقاد الأمن والحزن لفراق الأحبَّة وشتات الأهل في البلدان، ويجمع الشَّاعرُ مشهدَ هجرِ الحبيبةِ إلى مشهد تَفَرُّقِ الأهلِ، بسبب الَّذي وقعَ في صقلِّيَّةَ من حروبٍ، وكأنَّما قَدَرُهُ أن تنتهبَ قلبَه لوعةُ البينِ وآلامُ فراق الأهلِ والأرحامِ والخلَّان([61]):
| أَبِيتُ وجَفْني مِنْ جَفائكِ نائمُ | وَقُلْتُ بما قالَتْهُ فيكِ اللَّوائمُ |
| وَعَهْدِي بذاك الدُّرِّ غيرَ مُثَقَّبٍ | فكيفَ أجادَتْهُ بِفِيكِ النَّواظِمُ |
| وعندي حديثٌ لو أَمِنْتُ أذعْتُهُ | ألا حبَّذا غَيبٌ تَعِيهِ المَناسِمُ([62]) |
| وإذْ كان لا يَهْدِيكِ إلَّا مدامِعِي | فلا قَرَّ لِي نَهْرٌ منَ الدَّمْعِ ساجِمُ([63]) |
| رعى اللَّهُ أيَّاماً لنا وليالياً | بِخَيْفِ مِنًى والنَّائباتُ نوائمُ([64]) |
| زمانَ تَصِيْدُ اللَّهوَ أشراكُ مُهْجَتِي | ومَرْعاكِ في قلبي الَّذي بكِ هائمُ |
| لَوَ انَّكِ في حِلِّ الشَّبابِ حَلَلْتِ لِي |