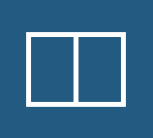مراحل الوجود العربي فيها صقلية
مراحل الوجود العربيِّ فيها صقلِّيَّة
كتب الأستاذ الدكتور أسامة اختيار حول هذا الموضوع من كتاب ( جمهرة أشعار الصقليين تحقيق ودراسة ) الصادر عن دار المقتبس في بيروت سنة ( 1437 هـ - 2016 م )
فقال :
كانت أُولى محاولات فتحها في عهد الخليفة عثمان بن عفَّان رضي الله عنه([1])، لكنها لم تسفر عن شيءٍ، ثمَّ توالت الحملات العربيَّة، وكان منطلقها جميعاً من إفريقيَّة، ومنها حملة والي إفريقيَّة معاوية بن حُدَيج سنة إحدى وأربعين للهجرة (41ﻫ)([2]) وحملة والي إفريقيَّة بِشْـر بن صفوان الكلبيِّ سنة ثلاثٍ ومئةٍ للهجرة (103ﻫ)([3]) وحملة الوالي عُبيدة بن عبد الرَّحمن بقيادة المُسْتَنيرِ بن الحَبْحاب الحرشيِّ([4])، ولم تسفر عن الفتح، بيدَ أنَّ أفضلَها حملةُ والي تونس حبيب بن أبي عُبيدة سنة اثنتين وعشرين ومئة للهجرة (122ﻫ) فقد توغَّل في صقلِّيَّة حتَّى نزل (سَرَقُوسة) غير أنَّ ثورة البرابرة في إفريقيَّة أعادته إلى تونس([5]).
في سنة اثنتي عشرة ومئتين للهجرة (212ﻫ) أمرَ زيادةُ الله الأغلبيُّ بفتح صقلِّيَّة، وجعل على رأس جيشه أسدَ بنَ الفُرات، وكان فقيهاً وَرِعاً، اجتمع حوله الخاصَّة والعامَّة لِعِلْمِه وتقواه، وخرج أسد بن الفُرات إلى صقلِّيَّة، فسارع عربُ إفريقيَّةَ والأندلس إلى مدِّه بالجند والمراكب([6])، فنزل صقلِّيَّةَ، وتوغَّلَ فيها حتَّى وصل إلى (سَرَقُوسَة) واستُشْهِدَ ـ رَحِمَهُ الله ـ تحت أسوارِها سنة ثلاث عشرة ومئتين للهجرة (213ﻫ) بعد أن مهَّدَ السَّبيلَ لفتحها، وبذلك صار البحر المتوسط كلُّه عَرَبِيّاً، يتحكَّمُ العربُ بالملاحة فيه شرقاً وغرباً، وأقرَّ الغربيُّون بهذه الحقيقة([7]) بعد سيطرة العرب على سواحل الشَّام وقُبْرُصَ وكَرِيتَ وشواطئ إفريقيَّةَ وصقلِّيَّةَ والأندلس.
يمكننا تقسيم مراحل الوجود العربيِّ في صقلِّيَّة بعد الفتح إلى ثلاث مراحل:
1 ـ سيادة الحكم العربيِّ في صقلِّيَّة (212 ـ 444ﻫ).
2 ـ الوجود العربيُّ في ظلِّ حكم النُّورمان (444 ـ 591ﻫ).
3 ـ حكم الجِرْمان وخروج العرب من صقلِّيَّة (591 ـ 647ﻫ).
1 ـ سيادة الحكم العربيِّ في صقلِّيَّة (212 ـ 444ﻫ):
تنقسم هذه المرحلة إلى أربعة عصور:
ـ عصر الدَّولة الأغلبيَّة (212 ـ 297ﻫ).
ـ عصر الدَّولة العُبيديَّة (297 ـ 336ﻫ).
ـ عصر الدَّولة الكلبيَّة (336 ـ 435ﻫ).
ـ عصر أمراء الطَّوائف (435 ـ 444ﻫ).
أ ـ عصر الدَّولة الأغلبيَّة (212 ـ 297ﻫ):
بَعْدَ أنْ سيطرَ أسدُ بن الفُرات على أهمِّ المواقع العسكريَّة البيزنطيَّة في صقلِّيَّة سنة اثنتي عشرة ومئتين للهجرة (212ﻫ) تمهَّدت السُّبُل أمام الجيش العربيِّ الأغلبيِّ([8]) للتَّوغُّل في أنحاء الجزيرة، وتابعَ محمَّد بن أبي الجَواري فَتْحَ الجزيرةِ بَعْدَ استشهاد أسد بن الفُرات، ودارت بين جيشه وجيش البيزنطيِّين معاركُ كثيرةٌ، واستطاع في آخرها أن يأخذ مَلِكَ صقلِّيَّة (قسطنطين) مع ابنه في الأسر([9]).
توفِّي ابنُ أبي الجَواري سنة ست عشرة ومئتين للهجرة (216ﻫ) فأرسل الأميرُ زيادةُ الله بزُهَير بن عوفٍ قائداً لجيوشه في صقلِّيَّة، فشدَّد الحصار على (بَلَرْم) حتَّى فُتِحَت له سنة عشرين ومئتين للهجرة (220ﻫ) واتَّخذها العربُ الأغالبةُ حاضرةً لهم، كما كانت حاضرةً لمن قبلَهُم، وهرعُوا إلى تثبيت دعائم الحكم العربيِّ في العاصمة، وما يَتْبَعُها من مدنٍ، وكان فَتْحُ صقلِّيَّة صعباً بسبب طبيعة أرضها القاسية، فهي أرضُ جبالٍ وأوديةٍ تصعبُ السَّيطرةُ عليها، ولاسيَّما أنَّ إمدادات الرُّوم البيزنطيِّين لم تنقطع عنها، ولذلك استمرَّ الفتح العربيُّ فيها طويلاً، ورافقَتْ هذه الحروبَ العسكريَّةَ الطَّويلةَ إنجازاتٌ حضاريَّةٌ تميَّزَ بها الفتحُ العربيُّ، فكان العرب الفاتحون يُثَبِّتُون قبضتهم العسكريَّة على مدن صقلِّيَّة، ثمَّ يهرعون إلى تعبيد الطُّرق وتشييد المرافق العامَّة وبناء المساجد والقصور([10])، في حين كانت سرايا الفتح تقوم بتحصين المدن المفتوحة، والدِّفاع عنها في البرِّ، ومنازلة الأسطول البيزنطيِّ في البحر.
في سنـة سـبع عشـرة ومئتين للهجرة (217ﻫ) وَلِيَ صقلِّيَّـةَ الأميرُ أبو الأغلب محمَّد بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب بأمرٍ من زيادة الله الأغلبيِّ بعد ولاية زهير بن عوفٍ، فأقام في (بَلَرْمَ) يجهِّزُ السَّرايا فتفتح وتغنم، وكانت إمارتُه عليها قُرابةَ تسع عشرة سنة([11])، ثمَّ وَلِيَهُ بعد وفاته سنة سبعٍ وثلاثين ومئتين للهجرة (237ﻫ) العبَّاسُ بن الفضل بن يعقوب بن فَزارة([12]) وفتحَ العبَّاسُ في صقلِّيَّةَ فتوحاتٍ كثيرةً، وممَّا فُتِح له (قَصْرُيَانَّة) وكانت بها دارُ الملك البيزنطيِّ بعد أن تحوَّل البيزنطيُّون إليها([13])، وتوفِّي العبَّاسُ سنة سبعٍ وأربعين ومئتين للهجرة (247ﻫ) فَخَلَفَهُ ابنُه عبدُ الله الَّذي بعثَ السَّرايا في أنحاء صقلِّيَّة، وبعد خمسة أشهرٍ من ولايته وصل خَفاجةُ بن سفيان من إفريقيَّة والياً عليها سنة ثمانٍ وأربعين ومئتين للهجرة (248ﻫ) فهاجم مدداً من الرُّوم قريباً من (سَرَقُوسُة) وسار إلى (قَطَانِيَّة) فقضى على ثورة فيها([14])، ثمَّ خَلَفَه ابنُه محمَّد سنةَ خمسٍ وخمسين ومئتين للهجرة (255ﻫ) فظلَّ يفتحُ في صقلِّيَّة إلى أن توفِّي سنة سبعٍ وخمسين ومئتين للهجرة (257ﻫ)([15]) فوليَ بَعْدَهُ أحمدُ بن يعقوب، ثمَّ حكمَ صقلِّيَّةَ عددٌ من الولاة الأغالبة ساروا كلُّهم على نَهْجِ مَنْ سَبَقَهُم في متابعة الفتح وتوطيد دعائم الحكم العربيِّ في الجزيرة، وظلَّ هذا شأنُهم حتَّى انقضاء الدَّولة الأغلبيَّة في القيروان وشتات أمرائها في البلاد سنة سبعٍ وتسعين ومئتين للهجرة (297ﻫ)([16]).
إنَّ اتِّصالَ الجهاد في صقلِّيَّةَ منذ فَتْحِها حتَّى سقوط الدَّولة الأغلبيَّة دليلٌ على منعتها، ولذلك لم يَغْفل العربُ الفاتحون عن التَّصدي للرُّوم البيزنطيِّين، وإجهاض محاولاتهم لبَسْطِ نفوذهم عليها، إضافةً إلى إجهاض الثَّورات الداخليَّة، الَّتي قامَت في (بَلَرْم) و(سَرَقُوسَة) و(مَسِّيْني) أيَّامَ أبي العبَّاس عبد الله بن إبراهيم الأغلبيِّ سنة ثمانٍ وثمانين ومئتين (288ﻫ) وقد نجح في إخمادها إلى أن جاوز أرضَ صقلِّيَّةَ إلى عُدْوَةِ الرُّوم في (إيطاليا)([17]) ويشير ابن حَوْقَلٍ إلى أنَّ الجهاد في صقلِّيَّة لم يزل قائماً والنَّفير فيها دائماً منذُ فُتِحَتْ([18])، وفي هذا إشارةٌ إلى امتناعها عن الاستقرار.
لم يقتصر العربُ الأغالبةُ في صقلِّيَّة على تثبيت دعامة الحكم العربيِّ، فوجَّهُوا عنايتهم إلى مراعاة الشُّؤون الاجتماعيِّة، وتميَّزَت مرحلةُ حكمهم بالتَّسامح الدِّينيِّ، ولم يأخذوا الجزيةَ من القساوسة والرُّهبان، ولم يُدخِلوا في نظام الجزية النِّساءَ والأطفالَ والشُّيوخَ، واهتمُّوا بالجانب العمرانيِّ، وشجَّعوا الزِّراعة، وحفروا القنواتِ والترعَ، وأدخلوا زراعاتٍ كثيرةً إلى الجزيرة، كزراعة الحمضيات والنَّخيل والزَّيتون، وعنوا بالصِّناعات، واهتمُّوا بتنشيط الحركة التجاريَّة، وأقاموا الأسواق الكبيرة([19])، وأَتبَعُوا ذلك بنظامٍ إداريٍّ متقنٍ تُدارُ به شؤونُ البلاد، ويبدو أنَّ دواوين الإنشاء كانت من أكبر نياباتهم، وهي من حيث التَّصنيفُ الإداريُّ في طبقةٍ رفيعةِ الشَّأنِ([20]).
أمَّا على صعيد الحياة العلميَّة؛ فقد أكرم ولاةُ صقلِّيَّة وفادةَ العلماء، ولاسيَّما الأطبَّاء، وكانوا يَصِلُونَهُم بمبالغَ من المال تُوفَّى إليهم سنويّاً([21])، ونشر العلماءُ العربُ فيها اللُّغةَ العربيَّةَ والعلومَ الرِّياضيَّةَ والفلكيَّةَ، وأسهمَ عددٌ من الفقهاء الَّذين نزلوا في صقلِّيَّة بدايةَ الفتح الإسلاميِّ بنشر العلوم الإسلاميَّة فيها، وكان من أبرزهم ابنُ الكحَّالة، وهو سليمانُ بن سالم القطَّان (ت 281ﻫ) وقد ذكره الشِّيرازيُّ في طبقاته([22])، وقرَّظَهُ ابنُ فَرْحون([23]).
ويُعَدُّ أسـدُ بن الفُـرات الَّذي يرجع إليـه فَضْلُ الفتح العربيِّ لصقلِّيَّةَ أحدَ أبرزِ رجالات الفقه الإسلاميِّ، وهو من الطَّبقة الوسطى المعروفين ممَّن تفقَّهوا على مالك بن أنس([24])، وممَّا يُؤْثَـرُ عنـه قولُـه من خطبـةٍ يحضُّ النَّاسَ على طلب العِلْم يومَ خروجه إلى صقلِّيَّة فاتحـاً: «واللهِ يا معشـرَ المسلمينَ ما وَلِيَ لي أبٌ ولا جَدٌّ... ولا بلغْتُ ما ترونَ إلَّا بالأقـلام، فأجهـدوا أنفسَـكُم فيهـا وثابروا على تدويـن العِلْم»([25]).
حَكَمَ صقلِّيَّةَ عددٌ من الأمراء الأغالبة ممَّن كان لهم اهتمامٌ بالأدب وعنايةٌ بالأدباء، وقد عنوا بالأدب على الرُّغم ممَّا شغلَهُم مِنْ شاغلِ الفتح وهَمِّ توطيد دعامة الحكم في البلاد، وكان منهم الأميرُ عبدُ الله بن محمَّد الأغلبيُّ، الَّذي وَلِيَ صقلِّيَّةَ سنة تسعٍ وخمسين ومئتين للهجرة (259ﻫ) وهو أديبٌ شاعرٌ، له نَظَرٌ في الأدب، وله شِعْرٌ سقطَ من يد الزَّمان([26])، ومنهم الأمير أبو العبَّاس عبدُ الله بن إبراهيم الأغلبيُّ، الَّذي وَلِيَ صقلِّيَّةَ سنة سبعٍ وثمانين ومئتين للهجرة (287ﻫ) وكان أديباً شاعراً أيضاً([27]).
شهدت صقِلِّيَّةُ رحلةَ كثيرٍ من علماء العرب إليها لعناية الأمراء الأغالبة بالحركة العلميَّة، وقد أسهمت الحرب الَّتي اشتعلت في إفريقيَّةَ في أواخر عهد الأغالبة في انتقال عددٍ من علماء القيروان إلى صقلِّيَّة بحثاً عن الأمن والاستقرار، غير أنَّ الاضطراب السِّياسيَّ لم يلبث أن وصل إليها بسبب ضعف الدَّولة الأغلبيَّة، و لمَّا سيطر العُبيديُّون على الحكم في إفريقيَّة انتقل حكمُ صقلِّيَّة إليهم سنة سبعٍ وتسعين ومئتين للهجرة (297ﻫ)([28]).
ب ـ عصر الدَّولة العُبيديَّة (297 ـ 336ﻫ):
ابتدأت هذه الدَّولة في إفريقيَّة بعُبيد الله بن محمَّد بن جعفر، وكان ذلك سنة سبعٍ وتسعين ومئتين (297ﻫ) بانقلابه على دولة الأغالبة، وقد سُمِّيَت الدَّولة العُبيديَّة نسبةً إليه([29])، ثمَّ إنَّه سَيَّرَ عمَّالَهُ إلى النَّواحي، فبعث إلى صقلِّيَّة الحسنَ بن محمَّد سنة سبعٍ وتسعين ومئتين للهجرة (297ﻫ) فأحدث مظالمَ، واشتكى منه أهلُ صقلِّيَّة، فولَّى عليهم أحمدَ بن قُهْرُب، فثاروا عليه أواخرَ المئة الثَّالثة من الهجرة، فولَّى عليهم أبا سعيد بن أحمد، فَظَلَمَ فَعَصَوا عليه، ثمَّ كانت ولايةُ سالم بن راشدٍ، فثاروا عليه أيضاً، واشتدَّت الفتنُ في البلاد، ثمَّ توفِّي عبيد الله، فآلَ أمرُ الدَّولة العبيديَّة في إفريقيَّة إلى أبي القاسم القائم بأمرِ الله، فأمرَ بعزل سالم بن راشد وتوليةِ عطَّاف الأزديِّ، ثمَّ انتقلَ أَمْرُ العُبيديِّين في إفريقيَّةَ إلى المنصور إسماعيل بن محمَّد، فضجر من صقلِّيَّة، وأَقْطَعَها لأبي الغنائم الحسنِ بن عليِّ بن أبي الحسين الكلبيِّ مكافأةً له على أياديه لديه، وبهذه الولاية قامت دولةُ الكلبيِّين في صقلِّيَّة، وتوارثَ الكلبيُّون حُكْمَها في أسرتهم.
ج ـ عصر الدَّولة الكلبيَّة (336 ـ 435ﻫ):
لما آلَ أمرُ صقلِّيَّة إلى أبي الغنائم الحسنِ بن عليِّ بن أبي الحسين الكلبيِّ؛ قضـى على الفتن، واجتهد في توطيد حكم أسرته، إلى أن تُوفِّي في حُمَّى أصابَتْه سنة ثلاثٍ وخمسين وثلاثمئةٍ للهجرة (353ﻫ)([30]) فَخَلَفَه ولدُه أبو الحسين أحمدُ، وكانت إمارتُه عليها ست عشرة سنةً وتسعة أشهر، ثمَّ خَلَفَه أخوه علي أبو القاسم، واستمرَّ أبو القاسم يغزو في صقلِّيَّة إلى أن قضى في إحدى معاركه مع الرُّوم سنة اثنتين وسبعين وثلاثمئةٍ (372ﻫ) فَخَلَفَه وَلَدُهُ جابرٌ([31])، ثمَّ وَلِيَ ابنُ عمِّه جعفر بن محمَّد بن الحسن سنة ثلاثٍ وسبعين وثلاثمئةٍ للهجرة، وبقي يغزو في الجزيرة حتَّى وفاته سنة خمسٍ وسبعين وثلاثمئةٍ للهجرة (375ﻫ) فَخَلَفَه أخوه عبد الله([32])، ثمَّ وَلِيَهُ ولدُه ثقةُ الدَّولة أبو الفتوح يوسف بن عبد الله سنة تسعٍ وسبعين وثلاثمئةٍ للهجرة (379ﻫ) وأصابه الفالجُ سنةَ ثمانٍ وثمانين وثلاثمئةٍ (388ﻫ) فوَلِيَ في حياته ابنُه جعفر الملقَّبُ بتاج الدَّولة، وأحدثَ جعفر مظالمَ كثيرةً، فخرج الصقلِّيُّون عليه وحاصروه ليقتلوه، فثبَّطَهم أبوه، ثمَّ عَزَلَه، وجعل مكانَه أخاه تأييدَ الدَّولة أحمدَ الملقَّبَ بالأكحل، فأساء السِّيرةَ، فخرجوا عليه، وقتلوه سنة سبعٍ وعشرين وأربعمئةٍ للهجرة (427ﻫ) فوَلِيَ من بعده أخوه الحسنُ صَمصامُ الدَّولة، فأحدث من المظالم ما دفع أهلَ الجزيرة إلى محاصرته وإخراجه من (بَلَرْم) وكان آخرَ الأمراءِ الكلبيِّين في صقلِّيَّة([33])، وآخرُ عَهْدِهِ سنة خمس وثلاثين وأربعمئة (435ﻫ)([34]).
شهدت صقلِّيَّةُ في المرحلة الأُولى من حُكْمِ الكلبيِّين ازدهاراً واستقراراً، ولا سيَّما في ولايـة أوَّل الحكَّام الكلبيِّين أبي الغنائم الحسـن بن عليٍّ (ت 353ﻫ) حتَّى ولاية ثقة الدَّولة يوسف بن عبد الله، وشملَ الازدهارُ ميادينَ مختلفةً، وتُعَدُّ تلك المرحلة من أفضل مراحل حكم الكلبيِّين، وقد اهتمَّ الكلبيُّون بتطوير الزِّراعة في صقلِّيَّة والنُّهوض بها، فأقاموا المصاطبَ الزراعيَّة، ونظَّموا الرِّيَّ، وكانوا أوَّل مَنْ أدخلَ إليها زراعةَ القطن، وقد اختفَتْ زراعةُ القطن من صقلِّيَّة مدَّةً طويلةً بعد خروج العرب منها.
أمَّا على صعيد النَّشاط الصِّناعيِّ؛ فتُعَدُّ صناعةُ الورق من أبرز الإسهاماتِ العربيَّة في صقلِّيَّة، وكانَ في (بَلَرْم) واحدٌ من أوائل مصانع الورق في أوربَّة([35])، وطوَّر العربُ في صقلِّيَّة الصِّناعاتِ النَّسيجيَّةَ وصناعةَ السُّكَّر، وهناك كلماتٌ عربيَّةٌ من المسمَّيات الزِّراعيَّة والمسمَّيات الصِّناعيَّة ما زالت دائرةً على لسان الصِّقلِّيِّين إلى أيَّامنا([36]).
أمَّا من النَّاحيَّة العمرانيَّة؛ فقد عنيَ العربُ الكلبيُّون بإنشاء القصور، وتميَّز البناء المعماريُّ العربيُّ في صقلِّيَّة بالأصالة العربيَّة، وأشار المستشرق (فون شاك) إلى أنَّ العرب الصِّقلِّيِّين كان في استطاعتهم أن يستغلُّوا الأعمدةَ وأجزاءً أخرى من المعابد الإغريقيَّة الصِّقلِّيَّة في بناء القصور، لكنَّهُم لم يفعلوا ذلك، وفضَّلوا المحافظةَ على النَّمط العمرانيِّ العربيِّ([37])، ولم يبق من هذه المعالم العمرانيَّة شيءٌ يُذكَر بسبب الحروب المتعاقبة.
واهتمَّ الكلبيُّون بالإدارة، فأسَّسوا نظاماً إداريّاً مُمَيَّزاً كان مَبْلَغَ إعجاب النُّورمان الَّذين حكموا الجزيرة مِنْ بعدهم، وعنوا بالتِّجارة والاقتصاد، وهناك كلماتٌ اقتصاديَّة ٌعربيَّةٌ تركت أَثَرَها في اللُّغة الإيطاليَّة، مثل: (ديوان Degana) وتعني في الإيطاليَّة الجماركَ، و(مخزن Maggazino) و(خسارة Cassara) و(خزينة Gasena) وغيرها من الكلمات، وأشار (صموئيل ستيرن) من جامعة أكسفورد إلى أنَّ العُمْلَةَ الَّتي كانت معروفةً في الغرب باسم (Tari) مشتقَّةٌ من الكلمة العربيَّة «طَرِيّ» بمعنى حديث الضَّرْبِ، وكان العرب الصِّقلِّيُّون يطلقونهاعلى رُبْعِ الدِّينار لحداثةِ ضَرْبِهِ([38])، وهذا كلُّه مِنْ أَثَرِ الحياة الاقتصاديَّة العربيَّة الصِّقلِّيَّة في أوربَّةَ، ولا سيَّما إيطاليا لِقُرْبها جغرافيّاً من صقلِّيَّة.
كانت صقلِّيَّة مقصداً للعلماء من نواحٍ مختلفةٍ، وقد قَصَدَها من القيروان الفقيهُ المعروفُ خلفُ بن أبي القاسم الأزديُّ البراذعيُّ([39])، وقصدَها من الأندلس شيخُ المحدِّثين أبو الرَّبيع سليمانُ الأندلسيُّ([40])، وأبرز مَنْ نزل بها من علماء اللُّغة من القيروان ابنُ البَرِّ أبو بكرٍ محمَّد بن علي بن الحسن (ت459ﻫ) وعلى يديه تتلمذ أحدُ أبرز علماء اللُّغة الصِّقلِّيِّين، وهو ابن القطَّاع الشَّاعرُ المعروفُ واللغويُّ البارز (ت 514ﻫ)([41]) ونزل بها من علماء اللُّغة أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعيُّ (ت 417ﻫ)([42]) وقصدها موسى بنُ أَصْبَغ المراديُّ القرطبيُّ اللُّغويُّ الأديب([43])، وقد أنتجت صقلِّيَّةُ علماء كثيرين من أبرزهم الفقيهُ أبو الحسن عليُّ بن المُفَرِّج بن عبد الرَّحمن الصِّقلِّيُّ (ت 470ﻫ) الَّذي خرج إلى مكَّة فوليَ قضاءها([44])، وعليُّ بن حمزة الصِّقلِّيُّ، وكان متصرِّفاً في علوم ٍشتَّى، وأقام في الأندلس قبل الأربعين وأربعمئةٍ للهجرة([45]).
من جانبٍ آخر شهدت صقلِّيَّةُ في أثناء حكم الكلبيِّين هجرةً واسعةً إليها من الأدباء والشُّعراء، ويعود ذلك إلى تشجيع الحكَّام الكلبيِّين للحركة الأدبيَّة بإكرام وفادة الشُّعراء المهاجرين إليها، أضفْ إلى ذلك أنَّ فئةً من الشُّعراء هاجرت إليها طلباً للأمن بعدما حلَّتْ بأوطانِهِمُ الفتنُ، وأبرزُ الشُّعراء الوافدين عليها ابنُ قاضي مِيلَةَ، ويحيى بنُ التِّيفاشيِّ، وعبدُ الكريم بن فُضَال القيروانيُّ، وابنُ المؤدِّبِ، ومحمَّدُ بن عبدون السُّوسيُّ، والنَّاقدُ المغربيُّ ابنُ رشيق القيروانيُّ وغيرُهم، وقد ظلَّت صقلِّيَّةُ مقصدَ كثيرٍ من الشُّعراء والأدباء والعلماء إلى زوال الحكم الكَلْبِيِّ فيها بسقوط الصَّمصام (431 ـ 435ﻫ) ونشوء دولة أمراء الطَّوائف.
د ـ عصر أمراء الطَّوائف (435 ـ 444ﻫ):
آلَ أمرُ البلاد إلى قادة الجند بعد ثورة أهل (بَلَرْم) على الصَّمصام آخر الأمراء الكلبيِّين، وانفرد كلُّ واحدٍ منهم بطرفٍ من جزيرة صقلِّيَّة، فاستقلَّ ابنُ الثِّمنةِ ببَلَرْمَ وسَرَقُوسَةَ وقَطَانِيَّةَ([46])، وانفرد عليُّ بن النِّعْمَة ـ المعروفُ بابن الحَوَّاس بقَصْريانَّةَ وجُرْجُنْتَ، وانفرد ابنُ عبد الله بن مَنْكُود بمازَرَ وطَرَابُنُشَ ومَرْسَى عليٍّ([47])، وترصَّدَ كلُّ واحدٍ منهم للآخر، ووقع بين ابن الثِّمْنَة وزوجِه خلافٌ، فهربت إلى أخيها ابن الحَوَّاس، وأبت العودةَ إلى زوجِها، فجمع ابنُ الثِّمْنَة عسكرَهُ، وسار إلى ابن الحَوَّاس في قَصْريانَّة، والتقى الجيشان في معركةٍ هُزِمَ فيها ابنُ الثِّمْنَة، وكان ذلك سنـة أربعٍ وأربعين وأربعمئةٍ (444ﻫ)، فلجأ ابنُ الثِّمْنة إلى الانتصار بالنُّورمان حُكَّام إيطاليا، وكان مَلِكُهُم آنذاك يُدعى (روجار) فسار إليه، وسهَّلَ له أمرَ الجزيرة وبَسَطَ لهُ مسالِكَها([48]).
2 ـ الوجود العربيُّ في ظلِّ حكم النُّورمان (444 ـ 591ﻫ):
اقتنصَ روجارُ ملكُ النُّورمان فرصةَ لجوء ابن الثِّمنة إليه، فسار إلى صقلِّيَّة، وتمكَّن من احتلال مواقعَ مهمَّةٍ فيها، واستولى على حاضرتها بَلَرْمَ، ولقيَ ابنُ الحَوَّاسِ النُّورمانَ فهزمُوه، فعادَ إلـى قَصْـريانَّةَ وتحصَّنَ فيها، وجهَّزَ صاحبُ إفريقيَّةَ المعزُّ بن باديس (ت 453ﻫ) أسطولاً لنجدة صقلِّيَّة، وشحنَهُ بالعتاد، فأغرقَتْهُ في البحر ريحٌ عاصفةٌ، ممَّا أضعف المعزَّ وسهَّلَ أمرَ صقلِّيَّةَ للنُّورمان، وبعد وفاة المعزِّ وَلِيَهُ ابنُه تميم، فبعث بأسطولٍ صغيرٍ إلى صقلِّيَّةَ، وجعل عليه وَلَدَيهِ أيُّوبَ وعليّاً، وأحبَّ أهلُ صقلِّيَّةَ أيُّوبَ فخشيَ ابنُ الحَوَّاس على مُلْكِه منه فقاتلَه، فأتى سهمٌ ابنَ الحَوَّاس فقتلَه، فقرَّرَ أيُّوبُ وأخوه بعد هذه الفتنة أن يعوداإلى إفريقيَّةَ سنةَ إحدى وستين وأربعمئةٍ (461ﻫ) ولم يبقَ أمام النُّورمان ما يمنعُهم من صقلِّيَّةَ، فضيَّقوا على أهلها وحاصروهم حتَّى خَضَعَتْ لهم الجزيرةُ كلُّها.
أخذ روجارُ أهلَ صقلِّيَّةَ بالبطش أوَّلَ الأمر، ودَمَّرَ معالمَ الحضارة الإسلاميَّـة فيهـا([49])، ولمَّا أمِـنَ جانبَ أهلِهـا انصرف إلى تنظيم شؤون الدَّولة، فَأُعْجِبَ بِسَعَةِ عِلْم العرب في كثيرٍ من المجالات، فأحسنَ معاملةَ العلماء منهم، وأسكنَهُمُ الجزيرةَ إلى جانب النُّورمان، ونالَ النِّظامُ الإداريُّ العربيُّ في الجزيرة إعجابَه فأقَرَّهُ، ثمَّ رغب بعد ذلك في التقرُّب إلى العرب والإفادة من جهدِهِمُ الحضاريِّ في بناء دولته، ولاسيَّما أنَّ النُّورمان قومٌ برابرةٌ جاؤوا من أقاصي أوربَّةَ الشَّماليَّة([50])، وكانوا رجال غزوٍ لا عهدَ لهم بالحضارة([51])، فأراد روجار الإفادةَ من الجهد الحضاريِّ العربيِّ في إنشاء دولةٍ قويَّةٍ متحضِّرة، وهذا ما دفعه إلى معاملة العرب في صقلِّيَّة معاملةً طيِّبةً، حتَّى إنَّه صكَّ نقوداً لدولتِه تحملُ اسمَ أخيه (رُوبِر) وعليها لفظُ الشَّهادة الإسلاميَّـة، ممَّا دفـع المستشرق الإيطاليَّ (د. ماتينو ماريو مورينو) إلى القول: «هكذا كانت صقلِّيَّةُ في أيَّام الكونت روجار مملكةً نصفَ إسلاميَّةٍ في دينها ونظامِها الإداريِّ والعسكريِّ»([52]).
توفِّيَ روجارُ سنة (494ﻫ) فَوَلِيَ صقلِّيَّةَ مِنْ بَعْدِه ولدُه روجارُ الثَّاني، وحَكَمَها على طريقة ملوك العرب، فقد كان له ديوانٌ للمظالم، واتَّخذ لنفسه ديواناً للتَّحرير العربيِّ، وحاكى ملوكَ العرب في أزيائهم، واتَّخذ لنفسه لقبَ المعزِّ بالله، ووصلَتْ إلى أيَّامنا حلَّةٌ عربيَّةٌ له، في وسطها اسمُه، وفي هامشِها ألقابُه، وعليها السَّنةُ الهجريَّةُ (528ﻫ) مكتوبةً بحروفٍ كوفيَّةٍ، وكانت له دار صناعةٍ للطِّراز العربيِّ، واصطفى لنفسه شعراء من عرب صقلِّيَّة، وكان من بينهم مَنْ مَدَحَهُ([53])، وقرَّبَ إليه العلماءَ العربَ، ومِنْ أبرزهم الشَّريفُ الإدريسيُّ أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد (ت560ﻫ) الَّذي صنَّفَ له الكتابَ المشهورَ «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»([54]) مشيراً فيه إلى نظرية كرويَّة الأرض، وتأثَّرَ روجارُ الثَّاني بكتب الحِسْبَةِ الإسلاميِّةِ، فنظَّمَ مزاولةَ مهنةِ الطبِّ، وفي عهده برزَ الفقيهُ الذَّائعُ الصِّيت محمَّدُ بن علي المازريُّ (ت536ﻫ)([55]).
ظلَّت سياسةُ روجار الثَّاني في حكم صقلِّيَّة على تلك الحال حتَّى وفاته سنة ثمانٍ وأربعينَ وخمسمئةٍ (548ﻫ)([56]) فَخَلَفَه ابنُه غليومُ، ولم يحسن التَّدبيرَ، فاضطربت شؤونُ البلاد في عهده([57])، وخلفَه بعد وفاته سنة إحدى وستين وخمسمئةٍ (561ﻫ) حفيدُه غليومُ الثَّاني، وكان يتقنُ العربيَّةَ قراءةً وكتابةً، ويحبُّ سماعَ القصائد العربيَّة، وجرى غليومُ الثَّاني على طريقة أجداده في تقريب علماء العرب غير أنَّه ضيَّق على عامَّتِهم، فلا أمنَ لهؤلاء في أموالهم وأبنائهم([58])، وتوفِّي غليومُ الثَّاني سنة أربعٍ وثمانين وخمسمئةٍ (584ﻫ) موصياً بالمُلْكِ للامبراطور الجِرْمانيِّ (هنري السَّادس) لأنَّه صِهْرُ مَلِكِ النُّورمان (روجار الثَّاني) وعاجلت المنيَّةُ (هنري السَّادس) فانتقل الحُكْمُ إلى زوجه الَّتي ما لبثت أن توفِّيَتْ تاركةً خلفَها ابنَها الصَّغيرَ ملكَ الجِرْمان المنتظر (فريدريك الثَّاني) واستولى أباطرةُ الجِرْمان (الألمان) على شؤون الحكم في صقلِّيَّةَ سنة إحدى وتسعين وخمسمئةٍ (591ﻫ) وعزلوا الأمير الصَّغيرَ عن أمور السِّياسة([59]).
3 ـ حكم الجِرْمان وخروج العرب من صقلِّيَّة (591 ـ 647ﻫ):
بدأ عهدُ الأباطرة الجِرْمان في صقلِّيَّة باستيلائهم على حكم الجزيرة وإقصائِهم الأميرَ فريدريك الثَّاني عن أمور الحكم، ولما شبَّ (فريدريك الثَّاني) انتفضَ فتغلَّب على خصومه في ألمانيا، ثمَّ عاد إلى صقلِّيَّة ليجدَ العربَ قد أعلنُوا الثَّـورةَ على الجِرْمان بقيادة زعيـمٍ يُدعـى ابنَ عبَّـاد الصِّقلِّـيَّ، فقضى (فريدريك الثَّاني) على الثَّورة، وقبضَ على زعيمها فقتلَهُ، ثمَّ نفى جندَه([60])، وأخذَ يُنَكِّلُ بالعرب المقيمين في صقلِّيَّة ليُكرِهَهُم على الرَّحيل، وقامَ في آخر الأمر بإجلائهم قَسْراً عن صقلِّيَّة سنة سبعٍ وأربعين وستمئةٍ ( 647ﻫ) ثمَّ سعى إلى إخلاءِ مالِطَةَ من العرب المقيمين فيها، وأحكمَ سيطرتَه على البلاد بعد سلسلةٍ من حملات الحَرْقِ والصَّلْبِ الَّتي شنَّها ضدَّ العرب الصِّقلِّيِّين، ثمَّ امتدَّتْ يدُه إلى معالم العِمارة العربيَّة في صقلِّيَّة فطمسَها، وقامَ حاكمُ إيطاليا الملكُ (شارل دانجو) بملاحقة فلول العرب الصِّقلِّيِّين الَّذين فرُّوا من صقلِّيَّة إلى إيطاليا فطردَهم منها أيضاً([61])، وبذلك انتهت مرحلةٌ مُشْرِقةٌ من الوجود العربيِّ في صقلِّيَّة ومالِطَة وإيطاليا، وعلى الرَّغم من انقضاء الحكم العربيِّ في صقلِّيَّة منذ سنة أربعٍ وأربعين وأربعمئةٍ (444ﻫ) ظلَّ الجهدُ العلميُّ العربيُّ مسيطراً في مرحلتي الحكم النُّورمانيِّ والجِرْمانيِّ.
إنَّ الحملةَ العِرْقيَّةَ الَّتي قام بها مَلِكُ الجِرْمان فريدريك الثَّاني سنة سبعٍ وأربعين وستمئةٍ (647ﻫ) لإبعادِ العربِ عن صقلِّيَّةَ لم تُثْنِه عن السَّعي إلى الإفادة من جهود العلماء العرب الصِّقلِّيِّين وغيرهم من علماء المغرب والشَّام والعراق، وتشير المصادر التَّاريخيَّـةُ إلى أنَّه كانَ يحتفظُ في بلاطِه بفيلسوفٍ يُدعَى ميشال سكواتش ممثِّلاً للثَّقافة العربيَّةِ، وترجمَ له عن العربيَّة عدداً من الكتب، كما جمعَ في بلاطه بعضَ المترجمين اليهود المُشْبَعِينَ بالثَّقافة العربيَّة([62])، وترجمُوا له كثيراً من كتب العرب، ووَجَّه فريدريك الثَّاني جملةً من المسائل الفلسفيَّة الَّتي شغلَتْ تفكيرَهُ إلى بعض علماء العرب خارجَ حدودِ دولته، ومن ذلك ما وجَّهَهُ من مسائلَ إلى بعض الفلاسفة العرب في المغرب والأندلس، ويتعلَّقُ بعضُها بنظرية أرسطو طاليس في قِدَمِ العالَم، ومنها ما يتعلَّقُ ببيان مفهوم العلم الإلهيِّ وبيان مقولات العلوم، وتشير الأخبارُ إلى أنَّه اتَّخذ لنفسه علماء من العرب، وأخذ عنهم بعضَ علوم المنطق والجَدَل([63])، وممَّا يُذكَرُ أنَّه كان حريصاً على جمع علماء الرياضيَّات العرب من حوله والاتِّصال بهم، وقد أكثرَ من ترجمة المصنَّفات العربيَّة في مجال الرياضيات خاصَّةً، وفي مجالات العلوم التطبيقيَّة عامَّةً([64]).
أمَّا الملكُ شارل دانجو الَّذي أسهم في إنهاء الوجود العربيِّ في إيطاليا بوحشيَّةٍ من خلال ملاحقتِه لفلول العرب الصِّقلِّيِّين الفارِّينَ إليها؛ فَيُذْكَرُ إعجابُه بجهود العرب في علم الطِّبِّ، وكان في بلاطه آخرُ كبار المترجمين عن اللُّغة العربيَّة في القرون الوسطى، وهو فرج بن سالم، الَّذي عُرِفَ عند الغرب باسم (Faragut) وهو عربيٌّ صقلِّيٌّ من مدينة (جُرْجُنْتَ) وقد ترجم لشارل دانجو كتاب (الحاوي) للرَّازيِّ الَّذي كان يُعَدُّ من أهمِّ المصادر الطِّبيَّة في كليَّات الطِّبِّ الأوربيَّة([65]).
اللاَّفتُ للنَّظر أن يتجاوز التَّأثيرُ الحضاريُّ العربيُّ في ملوك صقلِّيَّةَ العلومَ التَّطبيقيَّةَ إلى اهتمامهم باللُّغة والأدب أيضاً، ولاسيَّما في عهد النُّورمان الَّذين أُعجِبُوا بعناية العرب باللُّغة العربيَّة وعنايتِهم بالأدب والشِّعر، وقد دفع بعضُ الأباطرة النُّورمانِ أبناءهم إلى إتقان العربيَّة قراءةً وكتابةً، لأنَّها المدخلُ إلى تَلَقِّي علوم العرب كافَّةً، وعنيَ بعضُهم بالأدب العربيِّ، ومنهم من اتَّخذ في قصـره شعراءمن العرب الصِّقلِّيِّين لينشدوه الشِّعر، ولينظموا فيه المدائحَ، وهذا يفتح آفاقَالحديث عن الشِّعر العربيِّ الصِّقلِّيِّ، وأوَّل ما يُوقَفُ عندَه أصولُه ومصادره الرَّئيسة.
* * *
([8]) الأغالبةُ: بطنٌ من تميم، عمَّالُ بني العبَّاس على إفريقيَّة، أبرز مَنْ وَلِيَ منهم إبراهيمُ بن الأغلب بإذن هارون الرَّشيد سنة (184ﻫ) ثمَّ وَلِيَ بعدَهُ ابنُه زيادةُ الله الَّذي فُتِحَتْ له صقلِّيَّة. للتَّفصيل انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 92.
([16]) إنَّ الوضع السِّياسيَّ في القيروان أثَّرَ قروناً في صقلِّيَّة من حيث استقرارُها أو اضطرابُ أحوالها إلى أن حَكَمَها الكلبيُّون.
([38]) دراسات في تاريخ صقلِّيَّة الإسلاميَّة: 128. وللتَّفصيل اقرأْ في المرجع نفسه بحثاً عن الطَّرِيِّ الرُّباعيِّ الصِّقلِّيِّ وأثره في جنوب أوربَّة ص151 ـ 157.